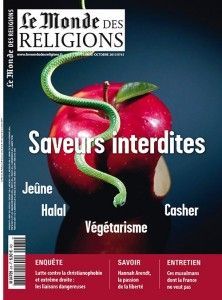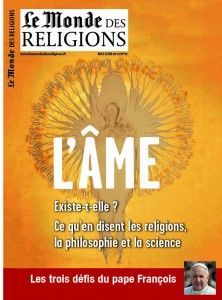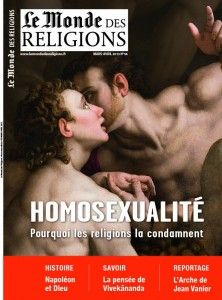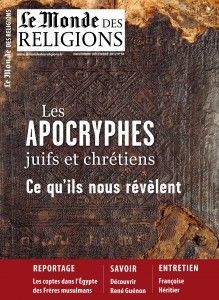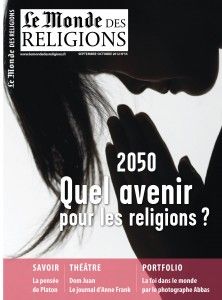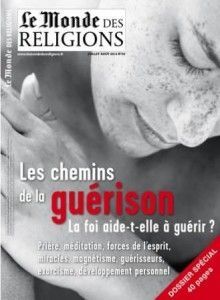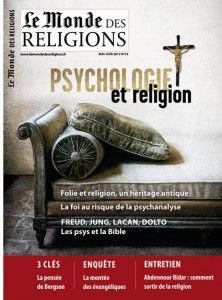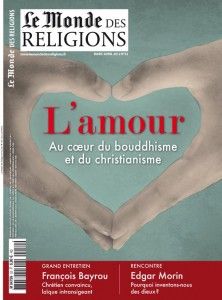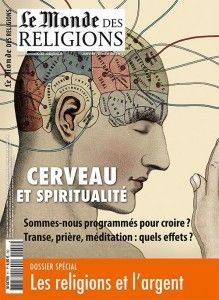افتتاحيات عالم الأديان
مدرجة بترتيب زمني تنازلي: من الأحدث (نوفمبر-ديسمبر 2013) إلى الأقدم (نوفمبر-ديسمبر 2004)
يحفظ
يحفظ
عالم الأديان، العدد 62 - نوفمبر/ديسمبر 2013 - فيما يتعلق بمسألة المعجزات، لا أعرف نصًا أعمق وأكثر إشراقًا من التأمل الذي يقدمه لنا سبينوزا في الفصل السادس من كتابه "رسالة في اللاهوت والسياسة". يكتب الفيلسوف الهولندي: "كما يُطلق الناس على أي علم يتجاوز إدراك العقل البشري اسم "إلهي"، فإنهم يرون يد الله في كل ظاهرة يكون سببها مجهولًا في الغالب". الآن، لا يمكن لله أن يتصرف خارج قوانين الطبيعة التي وضعها بنفسه. إذا وُجدت ظواهر غير مُفسَّرة، فإنها لا تتعارض أبدًا مع القوانين الطبيعية، ولكنها تبدو لنا "معجزة" أو "خارقة" لأن معرفتنا بقوانين الطبيعة المعقدة لا تزال محدودة. يوضح سبينوزا أن المعجزات المذكورة في الكتاب المقدس إما أسطورية أو ناتجة عن أسباب طبيعية تتجاوز فهمنا: هذا هو الحال مع البحر الأحمر، الذي يُقال إنه انشق بفعل ريح عاتية، أو مع شفاءات يسوع، التي يُفترض أنها حشدت موارد غير معروفة سابقًا في الجسم البشري أو العقل. ثم يُقدم الفيلسوف تحليلًا سياسيًا مُعمقًا للإيمان بالمعجزات، مُنددًا بـ"غطرسة" أولئك الذين يُريدون إثبات أن دينهم أو أمتهم "أعزّ على الله من غيرها". ولا يقتصر الأمر على أن الإيمان بالمعجزات، باعتبارها ظواهر خارقة للطبيعة، يبدو له "حماقة" تُخالف العقل، بل يُخالف أيضًا الإيمان الحق، ويُقوّضه: "إذا ما حدثت ظاهرة في الطبيعة لا تتوافق مع قوانينها، فلا بد من الاعتراف بأنها تُخالفها، وأنها تُخلّ بالنظام الذي وضعه الله في الكون بقوانين عامة تُنظّمه أزليًا". ومن هذا نستنتج أن الإيمان بالمعجزات يُفضي إلى الشك والإلحاد. أكتب هذه الافتتاحية بمشاعر جياشة، فهي الأخيرة. لقد مرّت عشر سنوات تقريبًا منذ أن توليت إدارة مجلة "عالم الأديان". حان الوقت لتسليم زمام الأمور وتكريس وقتي بالكامل لمشاريعي الشخصية: الكتب والمسرحيات، وفيلمٌ قريبًا، إن شاء الله. لقد استمتعتُ كثيرًا بهذه التجربة الاستثنائية في عالم النشر، وأشكركم من صميم قلبي على ولائكم الذي جعل هذه المجلة مرجعًا حقيقيًا للشؤون الدينية في جميع أنحاء العالم الناطق بالفرنسية (فهي تُوزّع في ست عشرة دولة ناطقة بالفرنسية). آمل بصدق أن تستمروا في دعمها، ويسعدني أن أعهد بقيادتها إلى فيرجيني لاروس، رئيسة التحرير، التي تتمتع بمعرفة ممتازة بالأديان وخبرة صحفية راسخة. سيساعدها في مهمتها لجنة تحريرية تضمّ عددًا من الوجوه المألوفة. نعمل معًا على صيغة جديدة ستكتشفونها في يناير، وستقدمها بنفسها في العدد القادم. أطيب التمنيات للجميع. اقرأوا مقالات من مجلة "عالم الأديان" على الإنترنت. الأديان: www.lemondedesreligions.fr [...]
عالم الأديان، العدد 61 - سبتمبر/أكتوبر 2013 - كما كتب القديس أوغسطين في كتابه "في الحياة السعيدة": "إن الرغبة في السعادة جوهرية للإنسان، وهي الدافع وراء جميع أفعالنا. إن أسمى وأفهم وأوضح وأثبت شيء في العالم ليس فقط رغبتنا في أن نكون سعداء، بل رغبتنا في أن نكون كل شيء إلا السعادة. هذا ما تحثنا عليه طبيعتنا." وبينما يتوق كل إنسان إلى السعادة، يبقى السؤال: هل يمكن أن توجد سعادة عميقة ودائمة هنا على الأرض؟ تقدم الأديان إجابات متباينة للغاية على هذا السؤال. ويبدو لي أن الموقفين الأكثر تعارضًا هما موقفا البوذية والمسيحية. فبينما تقوم عقيدة بوذا بأكملها على السعي وراء حالة من السكينة التامة في الدنيا والآخرة، تعد عقيدة المسيح المؤمنين بسعادة حقيقية في الآخرة. ينبع هذا من حياة مؤسسها - يسوع الذي توفي بشكل مأساوي في سن السادسة والثلاثين تقريبًا - ومن رسالته أيضًا: ملكوت الله الذي بشّر به ليس ملكوتًا أرضيًا بل ملكوتًا سماويًا، والنعيم لم يأتِ بعد: "طوبى للحزانى، لأنهم يُعزّون" (متى 5: 5). في عالم قديم كان يميل إلى البحث عن السعادة في الدنيا والآخرة، بما في ذلك داخل اليهودية، حوّل يسوع بوضوح محور السعادة إلى الآخرة. هذا الأمل في الفردوس السماوي سيتغلغل في تاريخ المسيحية الغربية، ويؤدي أحيانًا إلى أشكال عديدة من التطرف: الزهد الشديد والرغبة في الاستشهاد، والتقشف والمعاناة في سبيل الملكوت السماوي. ولكن مع عبارة فولتير الشهيرة - "الفردوس حيث أكون" - حدث تحوّل ملحوظ في المنظور في أوروبا بدءًا من القرن الثامن عشر: لم يعد يُنتظر الفردوس في الآخرة، بل أصبح يُدرك على الأرض، من خلال العقل والجهد البشري. سيتضاءل الإيمان بالحياة الآخرة، وبالتالي بالجنة السماوية، تدريجيًا، وسيسعى معظم معاصرينا إلى السعادة في الدنيا والآخرة. ونتيجةً لذلك، شهدت المواعظ المسيحية تحولًا جذريًا. فبعد أن شدد الوعاظ الكاثوليك والبروتستانت على عذاب جهنم ونعيم الجنة، باتوا نادرًا ما يتحدثون عن الحياة الآخرة. وقد تبنت الحركات المسيحية الأكثر شعبية - الإنجيليون والكاريزماتيون - هذا الواقع الجديد، وتؤكد باستمرار أن الإيمان بيسوع يجلب السعادة الأعظم، هنا على الأرض. ولأن الكثير من معاصرينا يربطون السعادة بالثروة، فإن بعضهم يذهب إلى حد وعد المؤمنين بـ"الرخاء الاقتصادي" على الأرض، بفضل الإيمان. إننا بعيدون كل البعد عن يسوع، الذي قال: "إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني ملكوت الله" (متى 19: 24)! لا شك أن جوهر المسيحية يكمن بين هذين النقيضين: رفض الحياة والزهد المرضي - الذي ندد به نيتشه بحق - باسم الحياة الأبدية أو الخوف من الجحيم من جهة، والسعي وراء السعادة الدنيوية وحدها من جهة أخرى. لم يحتقر يسوع، في جوهره، ملذات هذه الحياة ولم يمارس أي "تقشف": فقد كان يحب الشرب والأكل ومشاركة أصدقائه. وكثيراً ما نراه "يقفز فرحاً". لكنه أوضح جلياً أن السعادة الحقيقية لا تُنال في هذه الحياة. فهو لا يرفض السعادة الدنيوية، بل يضع قيماً أخرى فوقها: الحب والعدل والحق. وبذلك يُبين أنه بإمكان المرء التضحية بالسعادة الدنيوية وبذل حياته حباً، أو نضالاً ضد الظلم، أو تمسكاً بالحق. وتُعد شهادات غاندي ومارتن لوثر كينغ ونيلسون مانديلا المعاصرة أمثلة قوية على ذلك. ويبقى السؤال: هل سيجد عطاء حياتهم جزاءً عادلاً في الآخرة؟ هذا هو وعد المسيح وأمل مليارات المؤمنين حول العالم. اقرأ المقالات على الإنترنت من موقع "عالم الأديان": www.lemondedesreligions.fr [...]
عالم الأديان، العدد 60 - يوليو/أغسطس 2013 - تروي قصة يهودية أن الله خلق حواء قبل آدم. ولما شعرت حواء بالملل في الجنة، طلبت من الله أن يرزقها رفيقًا. وبعد تفكير عميق، استجاب الله لطلبها قائلًا: "حسنًا، سأخلق الإنسان. لكن احذري، فهو شديد الحساسية: لا تخبريه أبدًا أنكِ خُلقتِ قبله، سيغضب غضبًا شديدًا. فليكن هذا سرًا بيننا... بين النساء!" إذا كان الله موجودًا، فمن الواضح أنه لا جنس له. ولذلك قد يتساءل المرء لماذا خصصت معظم الأديان الكبرى تمثيلًا ذكوريًا له. وكما يذكرنا المقال في هذا العدد، لم يكن الأمر كذلك دائمًا. فقد سبقت عبادة الإلهة العظمى بلا شك عبادة "يهوه رب الجنود"، واحتلت الإلهات مكانة بارزة في مجمع آلهة الحضارات القديمة. لا شك أن هيمنة الذكورة على رجال الدين تُعدّ أحد الأسباب الرئيسية لهذا التحول الذي حدث على مدى ثلاثة آلاف عام سبقت عصرنا: كيف لمدينة ودين يحكمهما الرجال أن يُجلّوا إلهًا أعلى من الجنس الآخر؟ مع تطور المجتمعات الأبوية، حُسم الأمر: لم يعد من الممكن تصور الإله الأعلى، أو الإله الواحد، على أنه مؤنث. لم يقتصر هذا على صورته فحسب، بل شمل أيضًا شخصيته ووظيفته: فقد قُدّرت صفاته من قوة وهيمنة وسلطة. في السماء كما في الأرض، كان العالم محكومًا من قِبل رجل مهيمن. حتى وإن استمرت الصفة المؤنثة للإله في الأديان من خلال تيارات صوفية أو باطنية مختلفة، إلا أنه في العصر الحديث فقط تم تحدي هذه الهيمنة الذكورية المفرطة للإله بشكل حقيقي. ليس الأمر أننا انتقلنا من تمثيل ذكوري إلى تمثيل أنثوي للإله، بل شهدنا إعادة توازن. لم يعد يُنظر إلى الله في المقام الأول على أنه قاضٍ مهيب، بل قبل كل شيء على أنه خير ورحيم. يتزايد إيمان المؤمنين بعناية الله ورحمته. يمكن القول إن الصورة النمطية "الأبوية" لله تتلاشى لصالح صورة نمطية "أمومية". وبالمثل، تُقدَّر الحساسية والعاطفة والرقة في التجربة الروحية. يرتبط هذا التطور ارتباطًا وثيقًا بإعادة تقييم المرأة في مجتمعاتنا الحديثة، وهو ما يؤثر بشكل متزايد على الأديان، لا سيما من خلال تمكين المرأة من الوصول إلى مناصب التدريس والقيادة في العبادة. كما يعكس هذا التطور الاعتراف، في مجتمعاتنا الحديثة، بصفات وقيم تُعتبر "أنثوية" أكثر، حتى وإن كانت تهم الرجال والنساء على حد سواء: كالرحمة والانفتاح والترحاب وحماية الحياة. في مواجهة عودة النزعة الذكورية المقلقة بين الأصوليين الدينيين من مختلف المشارب، أنا مقتنعة بأن إعادة تقييم المرأة وتأنيث الإله يشكلان المفتاح الرئيسي لتجديد روحي حقيقي داخل الأديان. لا شك أن المرأة هي مستقبل الله. أغتنم هذه الفرصة لأحيي امرأتين معروفتين جيدًا لقرائنا الأوفياء. تنطلق جينيفر شوارتز، رئيسة تحرير مجلتكم السابقة، في مغامرات جديدة. أتقدم لها بجزيل الشكر والامتنان على حماسها وتفانيها في أداء مهامها لأكثر من خمس سنوات. كما أرحب ترحيباً حاراً بخليفتها: فيرجيني لاروس. أدارت السيدة لاروس مجلة أكاديمية متخصصة في الأديان لسنوات عديدة، وقامت بتدريس تاريخ الأديان في جامعة بورغوندي. كما أنها كاتبة في مجلة "لوموند دي ريليجن" منذ سنوات طويلة. [...]
عالم الأديان، العدد 59 - مايو/يونيو 2013 - عندما دُعيتُ للتعليق على الحدث مباشرةً على قناة فرانس 2، وعلمتُ أن البابا الجديد هو خورخي ماريو بيرغوليو، كان رد فعلي الفوري هو القول إنه حدث روحي بامتياز. كانت المرة الأولى التي سمعتُ فيها عن رئيس أساقفة بوينس آيرس قبل ذلك بعشر سنوات تقريبًا، من الأب بيير. خلال رحلة إلى الأرجنتين، انبهر ببساطة هذا اليسوعي الذي ترك القصر الأسقفي الفخم ليعيش في شقة متواضعة، والذي كان يذهب بمفرده كثيرًا إلى الأحياء الفقيرة. إن اختيار اسم فرنسيس، الذي يُذكّر بفقير أسيزي، لم يُؤكد إلا أننا على وشك أن نشهد تغييرًا عميقًا في الكنيسة الكاثوليكية. ليس تغييرًا في العقيدة، ولا حتى ربما في الأخلاق، بل في مفهوم البابوية نفسه وفي أسلوب إدارة الكنيسة. عرّف البابا فرنسيس نفسه لآلاف المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بصفته "أسقف روما"، وطلب من الحشد الصلاة من أجله قبل أن يصلي معهم، مُظهِرًا في دقائق معدودة، من خلال إيماءات عديدة، نيته العودة إلى فهم متواضع لدوره. هذا الفهم يُذكّرنا بفهم المسيحيين الأوائل، الذين لم يجعلوا من أسقف روما رأسًا عالميًا للمسيحية فحسب، بل ملكًا فعليًا على رأس دولة دنيوية. منذ انتخابه، ضاعف البابا فرنسيس أعماله الخيرية. والسؤال المطروح الآن هو: إلى أي مدى سيذهب في المهمة الجسيمة المتمثلة في تجديد الكنيسة التي تنتظره؟ هل سيُصلح أخيرًا الكوريا الرومانية وبنك الفاتيكان، اللذين هزتهما الفضائح لأكثر من ثلاثين عامًا؟ هل سيُطبّق نظامًا جماعيًا لإدارة الكنيسة؟ هل سيسعى للحفاظ على الوضع الحالي لدولة مدينة الفاتيكان، وهو إرث من الدولة البابوية السابقة، والذي يتناقض تمامًا مع شهادة يسوع عن الفقر ورفضه للسلطة الدنيوية؟ كيف سيتناول تحديات الحوار المسكوني والحوار بين الأديان، وهما موضوعان يثيران اهتمامه العميق؟ وماذا عن التبشير، في عالم تتسع فيه الفجوة بين خطاب الكنيسة وحياة الناس، لا سيما في الغرب؟ أمر واحد مؤكد: يمتلك البابا فرنسيس صفات القلب والعقل، بل والكاريزما، اللازمة لنشر هذه البشارة العظيمة في العالم الكاثوليكي وخارجه، كما يتضح من تصريحاته الأولى الداعية إلى سلام عالمي قائم على احترام تنوع الثقافات، بل واحترام الخليقة جمعاء (ولعلها المرة الأولى التي يحظى فيها الحيوانات ببابا يهتم لأمرها!). خفت حدة الانتقادات اللاذعة التي واجهها البابا فرنسيس فور انتخابه، والتي اتهمته بالتواطؤ مع المجلس العسكري السابق عندما كان رئيسًا شابًا لليسوعيين، بعد أيام قليلة، لا سيما بعد أن صرّح مواطنه الحائز على جائزة نوبل للسلام، أدولفو بيريز إسكيفيل - الذي سُجن لمدة 14 شهرًا وتعرض للتعذيب على يد المجلس العسكري - بأن البابا الجديد، على عكس رجال الدين الآخرين، "لا صلة له بالديكتاتورية". وهكذا، يتمتع البابا فرنسيس بفترة من النعمة قد تدفعه إلى اتخاذ أي خطوة جريئة. شريطة ألا يلقى المصير نفسه الذي لاقاه البابا يوحنا بولس الأول، الذي بثّ الكثير من الأمل قبل أن يرحل في ظروف غامضة بعد أقل من شهر من انتخابه. ولا شك أن البابا فرنسيس مُحِقٌّ في أن يطلب من المؤمنين الصلاة من أجله. www.lemondedesreligions.fr [...]
عالم الأديان، العدد 58 - مارس/أبريل 2013 - قد يبدو غريبًا لبعض قرائنا أننا، في أعقاب النقاش البرلماني المحتدم في فرنسا حول زواج المثليين، نخصص جزءًا كبيرًا من هذا العدد لكيفية نظر الأديان إلى المثلية الجنسية. بالتأكيد، نتناول العناصر الأساسية لهذا النقاش، الذي يتطرق أيضًا إلى مسألة النسب، في الجزء الثاني من العدد، من خلال وجهات النظر المتباينة للحاخام الأكبر لفرنسا، جيل بيرنهايم، والفيلسوفين أوليفييه أبيل وتيبو كولان، والمحللة النفسية وعالمة الأعراق جينيفيف ديلايسي دي بارسيفال، وعالمة الاجتماع دانييل هيرفيو ليجيه. لكن يبدو لي أن سؤالًا مهمًا قد تم تجاهله إلى حد كبير حتى الآن: ما رأي الأديان في المثلية الجنسية، وكيف تعاملت مع المثليين على مر القرون؟ تجاهل معظم الزعماء الدينيين هذا السؤال، وحصروا النقاش مباشرةً في مجال الأنثروبولوجيا والتحليل النفسي، بدلاً من اللاهوت أو الشريعة. وتتضح أسباب ذلك عند التدقيق في كيفية انتقاد المثلية الجنسية بشدة في معظم النصوص المقدسة، وكيف لا يزال يُعامل المثليون في أجزاء كثيرة من العالم باسم الدين. فبينما كانت المثلية الجنسية مقبولة إلى حد كبير في العصور القديمة، تُصوَّر على أنها انحراف كبير في الكتب المقدسة اليهودية والمسيحية والإسلامية. يقول سفر اللاويين (20: 13): "إذا اضطجع رجل مع ذكر مضاجعة امرأة، ففعلهما رجس. يُقتلان قتلاً، ودمهما عليهما". ولا تقول المشناه خلاف ذلك، ولم يجد آباء الكنيسة كلمات قاسية كافية لهذه الممارسة، التي، على حد تعبير توما الأكويني، "تُغضب الله"، لأنها، في نظره، تنتهك نظام الطبيعة الذي أراده الله القدير. في عهد الإمبراطورين المسيحيين المتدينين ثيودوسيوس وجستنيان، كان المثليون جنسيًا عرضة للموت، للاشتباه في تواطئهم مع الشيطان، وتحميلهم مسؤولية الكوارث الطبيعية والأوبئة. يدين القرآن الكريم، في نحو ثلاثين آية، هذا الفعل "غير الطبيعي" و"المشين"، ولا تزال الشريعة الإسلامية تُدين المثليين جنسيًا اليوم بعقوبات تختلف من بلد لآخر، تتراوح بين السجن والإعدام شنقًا، بما في ذلك مئة جلدة. تُعتبر الديانات الآسيوية عمومًا أكثر تسامحًا مع المثلية الجنسية، لكنها تُدان في الفينايا، وهي مدونة الرهبنة البوذية، وفي بعض فروع الهندوسية. ورغم أن مواقف المؤسسات اليهودية والمسيحية قد خفت حدتها بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة، إلا أن المثلية الجنسية لا تزال تُعتبر جريمة أو مخالفة في نحو مئة دولة، ولا تزال سببًا رئيسيًا للانتحار بين الشباب (في فرنسا، حاول واحد من كل ثلاثة مثليين جنسيًا دون سن العشرين الانتحار بسبب النبذ الاجتماعي). هذا التمييز العنيف، الذي غذته الحجج الدينية لآلاف السنين، هو ما أردنا تسليط الضوء عليه أيضًا. لا يزال النقاش المعقد والضروري قائمًا، ليس فقط حول الزواج، بل وأكثر من ذلك حول الأسرة (إذ لا تكمن القضية الحقيقية في المساواة في الحقوق المدنية بين الأزواج من نفس الجنس والأزواج من جنسين مختلفين، بل في مسألة النسب والأخلاقيات الحيوية). ويتجاوز هذا النقاش مطالب الأزواج من نفس الجنس، إذ يتناول قضايا التبني، والتلقيح الاصطناعي، وتأجير الأرحام، وهي قضايا قد تؤثر على الأزواج من جنسين مختلفين بنفس القدر. وقد أحسنت الحكومة صنعًا بتأجيله إلى الخريف، سعيًا منها للحصول على رأي اللجنة الوطنية للأخلاقيات. إنها بالفعل أسئلة مصيرية لا يمكن تجنبها أو حلها بحجج مبسطة من قبيل "هذا يُزعزع استقرار مجتمعاتنا" - وهي في الواقع مضطربة بالفعل - أو على العكس، "إنه المسار الحتمي للعالم": يجب تقييم أي تطور في ضوء ما هو خير للبشرية والمجتمع. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/58/ [...]
عالم الأديان، العدد 57 - يناير/فبراير 2013 - هل فكرة أن كل فرد يستطيع "إيجاد مساره الروحي" فكرة حديثة تمامًا؟ الإجابة هي نعم ولا. ففي الشرق، في زمن بوذا، نجد العديد من الباحثين عن المطلق الذين كانوا يبحثون عن طريق شخصي للتحرر. وفي اليونان ورومانيا القديمتين، قدمت الطوائف السرية والعديد من المدارس الفلسفية - من الفيثاغوريين إلى الأفلاطونيين الجدد، بما في ذلك الرواقيين والأبيقوريين - العديد من مسارات التلقين وسبل الحكمة للأفراد الساعين إلى حياة طيبة. إلا أن التطور اللاحق للحضارات الكبرى، التي تأسست كل منها على دين أعطى معنى للحياة الفردية والجماعية، حدّ من العروض الروحية. ومع ذلك، سنجد دائمًا ضمن كل تقليد رئيسي تيارات روحية متنوعة، تستجيب لتنوع معين من التطلعات الفردية. وهكذا، ضمن المسيحية، تقدم الرهبانيات المتعددة طيفًا واسعًا من التوجهات الروحية: من الأكثر تأملًا، كالكارثوسيين والكرمليين، إلى الأكثر فكرية، كالدومينيكان واليسوعيين، أو تلك التي تُركز على الفقر (الفرنسيسكان)، أو التوازن بين العمل والصلاة (البينديكتين)، أو العمل الخيري (إخوة وأخوات القديس فنسنت دي بول، مرسلو المحبة). وبعيدًا عن الملتزمين بالحياة الدينية، نشأت جمعيات من العلمانيين منذ أواخر العصور الوسطى، وغالبًا ما كانوا يعيشون ضمن نطاق نفوذ الرهبانيات الكبرى، حتى وإن لم تكن تحظى دائمًا بتقدير المؤسسة، كما يتضح من الاضطهاد الذي عانته البيغينيات. ويمكن ملاحظة الظاهرة نفسها في الإسلام مع ظهور العديد من الطرق الصوفية، التي تعرض بعضها للاضطهاد أيضًا. ووجدت الحساسية الصوفية اليهودية تعبيرًا عنها في نشأة الكابالا، واستمر ازدهار تنوع كبير من المدارس والحركات الروحية في آسيا. جلبت الحداثة عنصرين جديدين: تراجع الدين الجماعي وامتزاج الثقافات. أدى ذلك إلى ظهور توفيقات روحية جديدة مرتبطة بتطلعات كل فرد في سعيه نحو المعنى، وتطور روحانية علمانية تعبّر عن نفسها خارج أي معتقد أو ممارسة دينية. هذا الوضع ليس جديدًا تمامًا، إذ يُذكّرنا بالعصور الرومانية القديمة، لكن امتزاج الثقافات فيه أشدّ كثافة (فالجميع اليوم مُطّلع على التراث الروحي للبشرية جمعاء)، ونشهد أيضًا ديمقراطية حقيقية للبحث الروحي، الذي لم يعد حكرًا على نخبة اجتماعية. لكن وسط كل هذه التحولات، يبقى سؤال جوهري: هل ينبغي لكل فرد أن يبحث، وهل يستطيع أن يجد، المسار الروحي الذي يُتيح له تحقيق ذاته على أكمل وجه؟ إجابتي هي بلا شك: نعم. بالأمس، كما اليوم، المسار الروحي ثمرة رحلة شخصية، وهذه الرحلة أكثر نجاحًا إذا سعى كل شخص إلى مسار يُناسب حساسيته وقدراته وطموحه ورغباته وتساؤلاته. بالطبع، يجد بعض الأفراد أنفسهم تائهين أمام هذا الكم الهائل من المسارات المتاحة لنا اليوم. سُئل الدالاي لاما ذات مرة: "ما هو أفضل مسار روحي؟" فأجاب الزعيم التبتي: "المسار الذي يجعلك شخصًا أفضل". ولا شك أن هذا معيار ممتاز للتمييز. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/57/ حفظ [...]
عالم الأديان، العدد 56 - نوفمبر/ديسمبر 2012 - هناك المتعصبون باسم الله، أولئك الذين يقتلون باسم دينهم. من موسى، الذي أمر بمذبحة الكنعانيين، إلى جهاديي القاعدة، مرورًا بمفتش المباحث الكاثوليكية، يتخذ التعصب الديني أشكالًا مختلفة داخل الأديان التوحيدية، ولكنه ينبع دائمًا من نفس الجوهر: القتل - أو الأمر بالقتل - لحماية نقاء الدم أو العقيدة، وللدفاع عن المجتمع (أو حتى ثقافة، كما في حالة بريجفيك) ضد من يهددونه، ولتوسيع نفوذ الدين على المجتمع. إن التعصب الديني انحرافٌ صارخ عن الرسالة التوراتية والقرآنية التي تهدف في المقام الأول إلى تربية البشر على احترام الآخرين. هذا هو السم الذي تفرزه النزعة الجماعية: يصبح الشعور بالانتماء - إلى الناس، إلى المؤسسة، إلى المجتمع - أهم من الرسالة نفسها، ويُختزل "الله" إلى مجرد ذريعة للدفاع عن النفس والهيمنة. لقد خضع التعصب الديني لتحليل دقيق واستنكار شديد من قبل فلاسفة عصر التنوير قبل أكثر من قرنين. ناضلوا من أجل حرية الضمير والتعبير في المجتمعات التي لا تزال تهيمن عليها الديانة. وبفضلهم، نتمتع اليوم في الغرب بحرية ليس فقط في الإيمان أو عدم الإيمان، بل أيضاً في انتقاد الدين والتنديد بمخاطره. لكن هذا النضال وهذه الحرية التي تحققت بشق الأنفس يجب ألا ينسينا أن هؤلاء الفلاسفة أنفسهم سعوا إلى تمكين الجميع من العيش في وئام ضمن الحيز السياسي نفسه. لذا، فإن حرية التعبير، سواء كانت فكرية أو فنية، لا تهدف إلى مهاجمة الآخرين لمجرد إثارة الصراع أو تأجيجه. علاوة على ذلك، اعتقد جون لوك، باسم السلام الاجتماعي، أنه يجب إسكات أشد الملحدين تطرفاً في العلن، تماماً كما يُسكت أشد الكاثوليك تعصباً! فماذا سيقول اليوم لأولئك الذين ينتجون وينشرون عبر الإنترنت فيلماً رديئاً فنياً، يهاجم أقدس ما لدى المسلمين - شخصية النبي - بهدف وحيد هو إثارة التوترات بين الغرب والعالم الإسلامي؟ ماذا سيقول لمن يُزيدون الطين بلة بنشر رسوم كاريكاتورية جديدة للنبي محمد، بهدف بيع الصحف، مُؤججين جذوة الغضب الكامنة لدى العديد من المسلمين حول العالم؟ وما هي النتائج؟ وفيات، وتهديد متزايد للأقليات المسيحية في الدول الإسلامية، وتصاعد التوترات في جميع أنحاء العالم. إن النضال من أجل حرية التعبير - مهما كان نبيلاً - لا يُلغي الحاجة إلى تحليل جيوسياسي للوضع: فالجماعات المتطرفة تستغل الصور لحشد الجماهير حول عدو مشترك، وهو الغرب المُتخيل الذي اختُزل إلى خيال سينمائي وبعض الرسوم الكاريكاتورية. نحن نعيش في عالم مترابط يتعرض لتوترات عديدة تُهدد السلام العالمي. ما دعا إليه فلاسفة التنوير على المستوى الوطني أصبح الآن ساريًا على المستوى العالمي: الانتقادات الكاريكاتورية التي لا هدف لها سوى الإساءة إلى المؤمنين واستفزاز أكثرهم تطرفًا هي انتقادات حمقاء وخطيرة. إن أثرها الرئيسي هو تقوية صفوف المتعصبين الدينيين وتقويض جهود أولئك الذين يحاولون إقامة حوار بنّاء بين الثقافات والأديان. الحرية تعني المسؤولية والاهتمام بالصالح العام. بدون هذه العناصر، لا يمكن لأي مجتمع أن يستمر. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2012/56/ حفظ [...]
عالم الأديان، العدد 55 - سبتمبر/أكتوبر 2012 - قبل نحو ثلاثين عامًا، عندما بدأتُ دراستي في علم اجتماع وتاريخ الأديان، كان موضوع "العلمنة" هو محور النقاش الوحيد، وكان معظم المتخصصين في الدراسات الدينية يعتقدون أن الدين سيتحول تدريجيًا ثم يتلاشى داخل المجتمعات الأوروبية التي تتسم بشكل متزايد بالمادية والفردية. وكان من المفترض أن ينتشر النموذج الأوروبي إلى بقية العالم مع عولمة القيم وأنماط الحياة الغربية. باختصار، كان يُنظر إلى الدين على أنه محكوم عليه بالزوال على المدى البعيد. خلال السنوات العشر الماضية تقريبًا، انقلب النموذج والتحليل رأسًا على عقب: نتحدث الآن عن "نزع العلمنة"، ونشهد صعود الحركات الدينية المحافظة والقائمة على الهوية في كل مكان، ويلاحظ بيتر بيرغر، عالم الاجتماع الأمريكي البارز في مجال الأديان، أن "العالم لا يزال متدينًا بشدة كما كان دائمًا". وهكذا، يُنظر إلى أوروبا على أنها استثناء عالمي، لكنها معرضة لخطر التأثر بشكل متزايد بهذه الموجة الدينية الجديدة. فما هو سيناريو المستقبل؟ استنادًا إلى الاتجاهات الحالية، يقدم مراقبون دقيقون، في هذا العدد من المجلة، نظرة عامة محتملة على الأديان العالمية بحلول عام 2050. ستوسع المسيحية تفوقها على الأديان الأخرى، لا سيما بفضل التركيبة السكانية للدول النامية، وأيضًا بسبب النمو القوي للإنجيليين والخمسينيين في جميع القارات الخمس. سيستمر الإسلام في النمو نظرًا لتزايد عدد أتباعه، ولكن من المتوقع أن يتباطأ هذا النمو بشكل ملحوظ، خاصة في أوروبا وآسيا، مما سيحد في نهاية المطاف من انتشار الإسلام، الذي يجذب عددًا أقل بكثير من المتحولين إليه مقارنة بالمسيحية. ستبقى الهندوسية والبوذية مستقرتين نسبيًا، حتى لو استمرت قيم وممارسات معينة للبوذية (مثل التأمل) في الانتشار على نطاق أوسع في الغرب وأمريكا اللاتينية. ومثل غيرها من الديانات الصغيرة جدًا المرتبطة بالروابط الدموية، ستبقى اليهودية إما مستقرة أو ستشهد تراجعًا اعتمادًا على سيناريوهات ديموغرافية مختلفة وعدد الزيجات المختلطة. لكن بعيدًا عن هذه التوجهات العامة، وكما يذكرنا كل من جان بول ويليم ورافائيل ليوجيه بطريقته الخاصة، ستستمر الأديان في التحول والتأثر بالحداثة، ولا سيما الفردية والعولمة. فاليوم، يمتلك الأفراد رؤية شخصية متزايدة للدين، ويخلقون إطارهم الخاص للمعنى، وهو أحيانًا توفيقي، وغالبًا ما يكون مُركّبًا من عدة عناصر. حتى الحركات الأصولية أو التكاملية هي نتاج أفراد أو جماعات يُعيدون ابتكار "دين الأصول النقي". وطالما استمرت عملية العولمة، ستستمر الأديان في توفير نقاط مرجعية للهوية للأفراد الذين يفتقرون إليها، والذين يشعرون بالقلق أو الغزو الثقافي أو الهيمنة. وطالما أن البشرية تبحث عن المعنى، فستستمر في البحث عن إجابات في التراث الديني الإنساني الواسع. لكن هذه المساعي للهوية والروحانية لم تعد تُعاش، كما في الماضي، ضمن تقاليد ثابتة أو إطار مؤسسي معياري. لذا، فإن مستقبل الأديان لا يعتمد فقط على عدد المؤمنين، بل أيضًا على كيفية إعادة تفسيرهم لإرث الماضي. وهذه تحديدًا هي أكبر علامة استفهام تجعل أي تحليل استشرافي طويل الأمد محفوفًا بالمخاطر. لذا، في غياب العقلانية، يبقى لنا دائمًا أن نتخيل ونحلم. وهذا ما نقدمه لكم في هذا العدد، من خلال كتابنا الذين وافقوا على الإجابة عن السؤال: "ما هو الدين الذي تحلمون به لعام 2050؟" [...]
عالم الأديان، العدد 54 - يوليو/أغسطس 2012 - تُظهر دراسات علمية متزايدة وجود علاقة بين الإيمان والشفاء، مؤكدةً بذلك ملاحظاتٍ سُجّلت منذ القدم: فالإنسان، بوصفه كائنًا مفكرًا، له علاقة مختلفة بالحياة والمرض والموت، تبعًا لمستوى ثقته. انطلاقًا من الثقة بالنفس، والثقة بالمعالج، والثقة بالعلم، والثقة بالله، بما في ذلك تأثير الدواء الوهمي، يبرز سؤالٌ جوهري: هل يُساعد الإيمان على الشفاء؟ ما تأثير العقل - من خلال الصلاة أو التأمل، على سبيل المثال - على عملية الشفاء؟ ما مدى أهمية قناعات الطبيب في علاقته بالرعاية والدعم للمريض؟ تُلقي هذه الأسئلة المهمة ضوءًا جديدًا على أسئلة أساسية: ما هو المرض؟ ما معنى "الشفاء"؟ في نهاية المطاف، الشفاء هو دائمًا شفاء ذاتي: فجسد المريض وعقله هما اللذان يُحققان الشفاء. ومن خلال تجديد الخلايا، يستعيد الجسم توازنه المفقود. وغالبًا ما يكون من المفيد، بل من الضروري، دعم الجسم المريض من خلال التدخل العلاجي والأدوية. مع ذلك، لا تُسهم هذه العوامل إلا في عملية الشفاء الذاتي للمريض. فالبعد النفسي، والإيمان، والمعنويات، والبيئة الاجتماعية، كلها عوامل بالغة الأهمية في هذه العملية. لذا، يُشارك الإنسان بكامل كيانه في عملية الشفاء. ولا يُمكن استعادة توازن الجسد والعقل دون التزام حقيقي من المريض باستعادة صحته، ودون ثقة في الرعاية التي يتلقاها، وربما، بالنسبة للبعض، ثقة في الحياة عمومًا أو في قوة عليا رحيمة تُعينهم. وبالمثل، في بعض الأحيان، لا يُمكن للشفاء - أي العودة إلى التوازن - أن يتحقق دون تغيير في بيئة المريض: وتيرة حياته ونمطها، ونظامه الغذائي، وممارساته في التنفس والعناية بجسده، وعلاقاته العاطفية والودية والمهنية. لأن العديد من الأمراض ما هي إلا أعراض موضعية لاختلال أوسع في حياة المريض. فإذا لم يُدرك المريض ذلك، فسينتقل من مرض إلى آخر، أو يُعاني من أمراض مزمنة، واكتئاب، وما إلى ذلك. وما تُعلمنا إياه مسارات الشفاء هو أننا لا نستطيع معاملة الإنسان كآلة. لا يمكننا التعامل مع الإنسان كما نتعامل مع دراجة هوائية، بتغيير عجلة معوجة أو إطار مثقوب. فالأبعاد الاجتماعية والعاطفية والروحية للإنسان هي التي تتجلى في المرض، وهذا البُعد الشامل هو ما يجب أخذه في الاعتبار لعلاجه. وطالما لم نُدمج هذا البُعد بشكل كامل، فمن المرجح أن تبقى فرنسا رائدة العالم في استهلاك مضادات القلق والاكتئاب، وفي عجز نظام الضمان الاجتماعي لفترة طويلة قادمة [...]
عالم الأديان، العدد 53 - مايو/يونيو 2012 - اليوم، ينصب التركيز بشكل أكبر على البحث عن الهوية، وإعادة اكتشاف الجذور الثقافية، والتضامن المجتمعي. وللأسف، يتزايد أيضًا التركيز على الانطواء على الذات، والخوف من الآخر، والجمود الأخلاقي، والتعصب العقائدي. لا منطقة في العالم، ولا دين، بمنأى عن هذه الحركة العالمية الواسعة للهوية والعودة إلى المعايير السائدة. من لندن إلى القاهرة، مرورًا بدلهي وهيوستن والقدس، يتجه التوجه نحو الحجاب أو الشعر المستعار للنساء، والخطب الصارمة، وانتصار حُماة العقائد. على عكس ما شهدته في أواخر السبعينيات، فإن الشباب الذين ما زالوا مهتمين بالدين لا يحركهم في الغالب رغبة في الحكمة أو البحث عن الذات بقدر ما يحركهم حاجتهم إلى مرجعيات راسخة ورغبتهم في التمسك بتقاليد أجدادهم. لحسن الحظ، هذا التوجه ليس حتميًا. لقد وُلدت كعلاجٍ لتجاوزات العولمة الجامحة والفردية المفرطة في مجتمعاتنا. كما كانت رد فعلٍ على الليبرالية الاقتصادية المُجرِّدة من الإنسانية والتحرر الأخلاقي السريع. ولذلك، نشهد اليوم تأرجحًا كلاسيكيًا للبندول. فبعد الحرية، يأتي القانون. وبعد الفرد، تأتي الجماعة. وبعد الرؤى الطوباوية للتغيير، يأتي أمان النماذج السابقة. أُقرُّ بأن هناك جانبًا صحيًا في هذه العودة إلى الهوية. فبعد الإفراط في النزعة الفردية التحررية والاستهلاكية، من الجيد إعادة اكتشاف أهمية الروابط الاجتماعية والقانون والفضيلة. ما أستنكره هو الطبيعة المتشددة والمتعصبة لمعظم العودات الحالية إلى الدين. يُمكن للمرء أن يندمج في مجتمعٍ دون الانزلاق إلى النزعة الجماعية؛ وأن يتمسك بالرسالة العريقة لتقاليد عظيمة دون أن يصبح طائفيًا؛ وأن يرغب في عيش حياة فاضلة دون أن يكون متشددًا أخلاقيًا. في مواجهة هذه المواقف المتشددة، لحسن الحظ، يوجد علاجٌ داخل الأديان نفسها: الروحانية. كلما تعمّق المؤمنون في تراثهم، كلما اكتشفوا كنوزًا من الحكمة قادرة على التأثير في قلوبهم وتوسيع آفاقهم، مُذكّرةً إياهم بأن البشر جميعًا إخوة وأخوات، وأن العنف والحكم على الآخرين أشدّ وطأةً من مخالفة القواعد الدينية. يُقلقني تصاعد التعصب الديني والنزعة الطائفية، لا الأديان في حد ذاتها، التي قد تُنتج أسوأ النتائج، ولكنها قد تُنتج أيضًا أفضلها [...]
عالم الأديان، العدد 52 - مارس/أبريل 2012 - نادرًا ما يُطرح سؤال كيفية تصويت الفرنسيين وفقًا لدينهم. مع أن مبدأ العلمانية يمنع سؤال السكان عن انتماءاتهم الدينية في التعدادات السكانية منذ بداية الجمهورية الثالثة، إلا أن لدينا استطلاعات رأي تُقدم بعض المعلومات حول هذا الموضوع. ولكن نظرًا لصغر حجم عينات هذه الاستطلاعات، فإنها لا تستطيع قياس تأثير الأديان التي تُمثل أقليات صغيرة، كاليهودية والبروتستانتية والبوذية، حيث يقل عدد أتباع كل منها عن مليون شخص. مع ذلك، يُمكننا تكوين فكرة واضحة عن أنماط تصويت من يُعرّفون أنفسهم ككاثوليك (حوالي 60% من سكان فرنسا، منهم 25% يمارسون الكاثوليك) ومسلمين (حوالي 5%)، بالإضافة إلى من يُعلنون أنفسهم "بلا دين" (حوالي 30% من سكان فرنسا). يؤكد استطلاع رأي أجرته مجلة "سوفْر/بيليرين" في يناير الماضي ميول الكاثوليك الفرنسيين التاريخية نحو اليمين. ففي الجولة الأولى، أبدى 33% منهم استعدادهم للتصويت لنيكولا ساركوزي، وارتفعت هذه النسبة إلى 44% بين الكاثوليك الممارسين. كما أبدى 21% استعدادهم للتصويت لمارين لوبان، إلا أن هذه النسبة أقل من المتوسط الوطني بين الكاثوليك الممارسين (18%). وفي الجولة الثانية، أبدى 53% من الكاثوليك استعدادهم للتصويت لنيكولا ساركوزي مقابل 47% لفرانسوا هولاند، وبلغت نسبة المؤيدين للمرشح اليميني 67% بين الكاثوليك الممارسين، ووصلت إلى 75% بين المداومين على حضور الكنيسة. ويكشف هذا الاستطلاع أيضاً أنه بينما يتفق الكاثوليك مع الناخب الفرنسي العادي في إعطاء الأولوية للأمن الوظيفي والقدرة الشرائية، إلا أنهم أقل اهتماماً من غيرهم بالحد من عدم المساواة والفقر، وأكثر اهتماماً بمكافحة الجريمة. وفي نهاية المطاف، لا تحظى القيم الدينية والإنجيلية بنفس القدر من الأهمية في التصويت السياسي لأغلبية الكاثوليك مقارنةً بالمخاوف الاقتصادية أو الأمنية. في الواقع، لا يكاد يهمّ إن كان المرشح كاثوليكيًا أم لا. ومن اللافت للنظر أن المرشح الرئاسي الرئيسي الوحيد الذي يُعلن صراحةً عن ممارسته الكاثوليكية، فرانسوا بايرو، لا يحظى بأصواتٍ بين الكاثوليك أكثر مما يحظى به بين بقية السكان. فمعظم الكاثوليك الفرنسيين، ولا سيما الملتزمين منهم، يتمسكون في المقام الأول بمنظومة قيمٍ قائمة على النظام والاستقرار. ومع ذلك، يتبنى فرانسوا بايرو وجهة نظرٍ تقدمية بشأن قضايا اجتماعية مختلفة ذات آثار أخلاقية جوهرية. ومن المرجح أن يُثير هذا قلق شريحة كبيرة من الناخبين الكاثوليك التقليديين. ولا شك أن نيكولا ساركوزي قد استشعر ذلك، إذ يظل متسقًا مع المواقف الكاثوليكية التقليدية بشأن قوانين الأخلاقيات البيولوجية، وتربية الأطفال من قِبل المثليين، وزواج المثليين. وأخيرًا، تُظهر استطلاعات الرأي التي أجراها مركز العلوم السياسية (Sciences Po) أن المسلمين الفرنسيين، على عكس الكاثوليك، يُصوّتون بأغلبية ساحقة للأحزاب اليسارية (78%). على الرغم من أن ثلاثة أرباعهم يشغلون وظائف متدنية المهارة، إلا أن نمط تصويت مرتبط بالدين بشكل واضح، حيث يُعرّف 48% من العمال والموظفين المسلمين أنفسهم بأنهم يميلون إلى اليسار، مقارنةً بـ 26% من العمال والموظفين الكاثوليك و36% من العمال والموظفين غير المتدينين. كما أن السكان "غير المتدينين" ككل - وهي فئة مستمرة في النمو - يصوتون بقوة لليسار (71%). يكشف هذا عن تحالف غريب بين "غير المتدينين" - الذين غالباً ما يكونون تقدميين في القضايا الاجتماعية - والمسلمين الفرنسيين، الذين هم بلا شك أكثر تحفظاً في هذه القضايا نفسها، لكنهم ملتزمون بعقلية "أي شيء إلا ساركوزي". [...]
عالم الأديان، العدد 51 - يناير/فبراير 2012 - يسلط موضوعنا الضوء على حقيقة مهمة: التجربة الروحية بأشكالها المتنوعة - الصلاة، والغيبوبة الشامانية، والتأمل - تترك أثراً جسدياً على الدماغ. وبعيداً عن الجدل الفلسفي الذي ينشأ عن هذا، والتفسيرات المادية أو الروحانية التي يمكن استخلاصها منه، أستخلص درساً آخر من هذه الحقيقة، وهو أن الروحانية، قبل كل شيء، تجربة معيشية تمس العقل بقدر ما تمس الجسد. وبحسب الخلفية الثقافية لكل فرد، فإنها تشير إلى أشياء أو تمثيلات مختلفة تماماً: لقاء مع الله، أو مع قوة مطلقة لا توصف، أو مع أعماق الروح الغامضة. لكن هذه التمثيلات تشترك دائماً في خيط مشترك يتمثل في إثارة سلام داخلي عميق، وتوسيع الوعي، وفي كثير من الأحيان، وعي القلب. إن المقدس، أياً كان اسمه أو شكله، يُغير من يختبره، ويؤثر فيه تأثيراً عميقاً في كيانه كله: جسده العاطفي، ونفسيته، وروحه. مع ذلك، فإن العديد من المؤمنين لا يختبرون هذه التجربة. بالنسبة لهم، يُعدّ الدين في المقام الأول علامةً على الهوية الشخصية والجماعية، وميثاقًا أخلاقيًا، ومجموعةً من المعتقدات والقواعد الواجب اتباعها. باختصار، يُختزل الدين إلى بُعده الاجتماعي والثقافي. يُمكننا تحديد اللحظة التاريخية التي ظهر فيها هذا البُعد الاجتماعي للدين، وطغى تدريجيًا على التجربة الشخصية: الانتقال من حياة الترحال، حيث عاش البشر في انسجام مع الطبيعة، إلى حياة الاستقرار، حيث بُنيت المدن، وحلّت آلهة المدينة - التي كانت تُقدّم لها القرابين - محلّ أرواح الطبيعة - التي كان التواصل معها يتمّ عبر حالات وعي مُتغيّرة. إنّ أصل كلمة "تضحية" - "التقديس" - يُظهر بوضوح أنّ المُقدّس لم يعد يُعاش: بل يُمارس من خلال طقوس (تقديم القرابين للآلهة) تهدف إلى ضمان النظام العالمي وحماية المدينة. وقد فوّض السكان، الذين أصبح عددهم كبيرًا، هذه المهمة إلى رجال دين مُتخصّصين. وهكذا، يتخذ الدين بُعدًا اجتماعيًا وسياسيًا جوهريًا: فهو يُنشئ روابط ويُوحّد المجتمع حول معتقدات وقواعد أخلاقية وطقوس مُشتركة. كرد فعل على هذا البُعد الخارجي والجماعي المفرط، ظهرت في منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد تقريبًا مجموعة متنوعة من الحكماء في جميع الحضارات، ساعين إلى إعادة إحياء التجربة الشخصية للمقدس: لاو تزو في الصين، ومؤلفو الأوبانيشاد وبوذا في الهند، وزرادشت في بلاد فارس، ومؤسسو الطوائف السرية وفيثاغورس في اليونان، وأنبياء إسرائيل وصولًا إلى يسوع. غالبًا ما تنشأ هذه الحركات الروحية ضمن التقاليد الدينية، التي تميل إلى تغييرها من خلال تحديها من الداخل. هذه الموجة الاستثنائية من التصوف، التي لا تزال تُذهل المؤرخين بتقاربها وتزامنها عبر ثقافات العالم المتنوعة، تُغير الأديان من خلال إدخال بُعد شخصي يُعيد، من نواحٍ عديدة، التواصل مع تجربة المقدس البدائي في المجتمعات البدائية. ويدهشني مدى تشابه عصرنا مع تلك الحقبة القديمة: فهذا البُعد تحديدًا هو ما يثير اهتمام معاصرينا بشكل متزايد، والذين نأى الكثير منهم بأنفسهم عن الدين، الذي يرونه باردًا واجتماعيًا وخارجيًا. هذه هي مفارقة الحداثة الفائقة التي تسعى إلى إعادة التواصل مع أقدم أشكال القداسة: قدسية تُعاش أكثر مما تُخلق. ولذلك، فإن القرن الحادي والعشرين ديني، نظرًا لعودة الهوية في مواجهة المخاوف التي تولدها العولمة السريعة، وروحي، نظرًا لهذه الحاجة إلى التجربة والتحول التي يشعر بها الكثير من الأفراد، سواء كانوا متدينين أم لا. [...]
عالم الأديان، العدد 50 - نوفمبر/ديسمبر 2011 - هل ستنتهي الدنيا في 21 ديسمبر 2012؟ لفترة طويلة، لم أعر اهتمامًا للنبوءة الشهيرة المنسوبة إلى حضارة المايا. لكن خلال الأشهر القليلة الماضية، سألني الكثيرون عنها، مؤكدين لي في كثير من الأحيان أن أبناءهم المراهقين قلقون بسبب المعلومات التي يقرؤونها على الإنترنت أو تأثرهم بفيلم الكوارث الهوليوودي "2012". هل نبوءة المايا صحيحة؟ هل هناك نبوءات دينية أخرى عن قرب نهاية العالم، كما هو متداول على الإنترنت؟ ماذا تقول الأديان عن نهاية الزمان؟ يجيب المقال في هذا العدد على هذه الأسئلة. لكن انتشار هذه الشائعة حول 21 ديسمبر 2012 يثير سؤالًا آخر: كيف نفسر قلق الكثيرين من معاصرينا، ومعظمهم غير متدينين، والذين تبدو لهم هذه الشائعة معقولة؟ أرى تفسيرين. أولًا، نعيش حقبةً عصيبةً للغاية، حيث تشعر البشرية وكأنها على متن قطارٍ جامح. في الواقع، لا يبدو أن أي مؤسسة أو دولة قادرة على وقف الاندفاع المتهور نحو المجهول - وربما الهاوية - الذي تدفعنا إليه أيديولوجية الاستهلاك والعولمة الاقتصادية تحت رعاية الرأسمالية النيوليبرالية: زياداتٌ هائلةٌ في عدم المساواة؛ كوارث بيئية تهدد الكوكب بأكمله؛ مضاربات مالية جامحة تُضعف الاقتصاد العالمي برمته. ثم هناك الاضطرابات في أنماط حياتنا التي حوّلت الغربيين إلى أشخاصٍ مُقتلعين من جذورهم، فاقدين للذاكرة، غير قادرين على استشراف المستقبل. لا شك أن أنماط حياتنا قد تغيرت في القرن الماضي أكثر مما تغيرت في الألفيات الثلاثة أو الأربعة الماضية. عاش الأوروبي في الماضي في الغالب في الريف، مُتأملًا الطبيعة، مُتجذرًا في عالمٍ ريفي هادئ ومترابط، مُتشبثًا بتقاليد عريقة. وينطبق الشيء نفسه على الناس في العصور الوسطى والعصور القديمة. أما الأوروبي اليوم فهو مُدخِلٌ للمدينة في غالبيته العظمى. يشعرون بالارتباط بالكوكب بأسره، لكنهم يفتقرون إلى روابط محلية متينة؛ يعيشون حياة فردية بوتيرة محمومة، وغالبًا ما انفصلوا عن تقاليد أسلافهم العريقة. ربما علينا العودة إلى العصر الحجري الحديث (حوالي 10000 قبل الميلاد في الشرق الأدنى، وحوالي 3000 قبل الميلاد في أوروبا)، عندما تخلى البشر عن نمط حياة الصيد وجمع الثمار البدوي، واستقروا في قرى، وطوروا الزراعة وتربية الحيوانات، لنشهد ثورة جذرية كتلك التي نشهدها اليوم. لهذا الأمر عواقب وخيمة على نفسيتنا. فالسرعة التي حدثت بها هذه الثورة تولد حالة من عدم اليقين، وفقدانًا للبوصلة الأساسية، وضعفًا في الروابط الاجتماعية. إنها مصدر قلق وتوتر وشعور مشوش بالهشاشة لدى الأفراد والمجتمعات البشرية على حد سواء، ومن ثم حساسية متزايدة لمواضيع الدمار والتفكك والفناء. أمر واحد يبدو لي مؤكدًا: نحن لا نشهد أعراض نهاية العالم، بل نشهد نهاية عالم. إن العالم التقليدي، الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين، والذي وصفته للتو بكل أنماط التفكير المرتبطة به، وكذلك عالم الاستهلاكية الفردية المفرطة الذي خلفه، والذي ما زلنا غارقين فيه، والذي يُظهر علامات كثيرة على الإرهاق ويكشف عن قصوره الحقيقي أمام التقدم الحقيقي للبشرية والمجتمعات. قال برغسون إننا سنحتاج إلى "جرعة روحية" لمواجهة التحديات الجديدة. في الواقع، يمكننا أن نرى في هذه الأزمة العميقة ليس فقط سلسلة من الكوارث البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، بل أيضًا فرصة لنهضة، وتجديد إنساني وروحي، من خلال صحوة الوعي وشعور أعمق بالمسؤولية الفردية والجماعية. [...]
عالم الأديان، العدد 49 - سبتمبر/أكتوبر 2011 - يُعدّ تعزيز الأصوليات والنزعات الطائفية بشتى أنواعها أحد أبرز آثار أحداث 11 سبتمبر. فقد كشفت هذه المأساة، بتداعياتها العالمية، عن الفجوة بين الإسلام والغرب وزادتها حدة، كما كانت في الوقت نفسه عرضًا ومُسرِّعًا لجميع المخاوف المرتبطة بالعولمة فائقة السرعة في العقود السابقة وما نتج عنها من صدام ثقافي. إلا أن هذه التوترات القائمة على الهوية، والتي لا تزال تُثير القلق وتُغذي التغطية الإعلامية باستمرار (مذبحة أوسلو في يوليو/تموز خير مثال على ذلك)، قد طغت على نتيجة أخرى مُعاكسة تمامًا لأحداث 11 سبتمبر: وهي رفض الأديان التوحيدية تحديدًا بسبب التعصب الذي تُولِّده. تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة في أوروبا أن الأديان التوحيدية باتت تُثير مخاوف مُتزايدة لدى مُعاصرينا. فقد باتت كلمتا "العنف" و"التراجع" أكثر ارتباطًا بها من كلمتي "السلام" و"التقدم". إحدى نتائج عودة ظهور الهوية الدينية والتعصب الذي غالباً ما يصاحبها هي الزيادة الحادة في الإلحاد. وبينما تنتشر هذه الحركة في الغرب، فإن هذه الظاهرة تبرز بشكل لافت في فرنسا. فقد تضاعف عدد الملحدين مقارنةً بما كان عليه قبل عشر سنوات، وأصبح غالبية الفرنسيين يُعرّفون أنفسهم إما كملحدين أو لا أدريين. بالطبع، أسباب هذه الزيادة في عدم الإيمان واللامبالاة الدينية أعمق من ذلك، ونحللها في هذا التقرير: من بينها تطور التفكير النقدي والفردية، وأنماط الحياة الحضرية، وتراجع التبشير الديني. ولكن لا شك أن العنف الديني المعاصر يُفاقم ظاهرة واسعة الانتشار تتمثل في الانفصال عن الدين، وهي أقل فظاعة بكثير من جنون القتل لدى المتعصبين. وكما يقول المثل: صوت الشجرة الساقطة يُغطي على صوت الغابة النامية. ومع ذلك، ولأنها تُثير قلقنا بحق وتُهدد السلام العالمي على المدى القريب، فإننا نُركز بشكل مُفرط على عودة الأصولية والطائفية، متناسين أن التحول الحقيقي على المدى التاريخي البعيد هو التراجع العميق للدين والإيمان بالله، في جميع شرائح المجتمع. قد يقول البعض إن هذه الظاهرة أوروبية، ولا سيما في فرنسا. صحيح، لكنها تتفاقم باستمرار، بل إن هذا التوجه بدأ ينتشر إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. فرنسا، بعد أن كانت الابنة الكبرى للكنيسة، قد تُصبح الابنة الكبرى للامبالاة الدينية. كما يُظهر الربيع العربي أن التوق إلى الحريات الفردية عالمي، وقد تكون نتيجته النهائية، في العالم الإسلامي كما في العالم الغربي، تحرر الفرد من الدين و"موت الإله" الذي تنبأ به نيتشه. لقد أدرك حُماة العقيدة هذا الأمر بوضوح، مُدينين باستمرار مخاطر الفردية والنسبية. لكن هل يُمكن قمع حاجة إنسانية أساسية كهذه، كحرية الاعتقاد والتفكير واختيار القيم والمعنى الذي يرغب المرء في إضفاءه على حياته؟ على المدى البعيد، يبدو لي أن مستقبل الدين لا يكمن في الهوية الجماعية وخضوع الفرد للجماعة، كما كان الحال لآلاف السنين، بل في السعي الروحي الشخصي والمسؤولية. إن مرحلة الإلحاد ورفض الدين التي نغرق فيها تدريجيًا قد تؤدي، بلا شك، إلى نزعة استهلاكية متفشية، ولا مبالاة بالآخرين، وأشكال جديدة من الوحشية. لكنها قد تكون أيضًا مقدمة لأشكال جديدة من الروحانية، علمانية كانت أم دينية، مؤسسة حقًا على القيم العالمية العظيمة التي نتوق إليها جميعًا: الحقيقة والحرية والمحبة. حينها لن يكون الله - أو بالأحرى، جميع تجلياته التقليدية - قد مات عبثًا. [...]
عالم الأديان، العدد 48 - يوليو/أغسطس 2011 - بينما تستمر قضية دومينيك ستروس كان في إثارة الجدل وطرح العديد من التساؤلات، ثمة درسٌ من سقراط لقّنه للشاب ألكيبيادس جديرٌ بالتأمل: "لكي يدّعي المرء حكم المدينة، عليه أن يتعلم كيف يحكم نفسه". لو أُدين دومينيك ستروس كان، المرشح الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي حتى هذه القضية، بالاعتداء الجنسي على خادمة في فندق سوفيتيل بنيويورك، لما شعرنا بالشفقة على الضحية فحسب، بل ولتنفسنا الصعداء. فلو كان ستروس كان، كما تشير بعض الشهادات في فرنسا، مجرمًا جنسيًا قهريًا قادرًا على الوحشية، لكنا انتخبنا لأعلى منصب إما رجلًا مريضًا (إن لم يستطع ضبط نفسه) أو رجلًا شريرًا (إن رفض ضبط نفسه). وبالنظر إلى الصدمة التي أحدثها نبأ اعتقاله في بلادنا، يكاد المرء لا يجرؤ على التساؤل عما كان سيحدث لو اندلعت مثل هذه القضية بعد عام! إن حالة الذهول والذهول التي انتابت الشعب الفرنسي، والتي كادت تصل إلى حد الإنكار، تنبع في معظمها من الآمال التي عُلّقت على دومينيك ستيوارت كرجل جاد ومسؤول قادر على حكم فرنسا وتمثيلها بكرامة على الساحة الدولية. وقد نشأ هذا التوقع من خيبة الأمل التي سببها نيكولا ساركوزي، الذي وُجّهت إليه انتقادات لاذعة بسبب التناقضات بين تصريحاته الرنانة حول العدالة الاجتماعية والأخلاق، وسلوكه الشخصي، لا سيما فيما يتعلق بالمال. كان الناس يأملون في شخصية أكثر مثالية من الناحية الأخلاقية. إن سقوط ستيوارت، مهما كانت نتيجة المحاكمة، أمر يصعب تقبله. ومع ذلك، فإنه يحمل في طياته ميزة إعادة مسألة الفضيلة في السياسة إلى النقاش العام. فبينما تُعد هذه القضية حاسمة في الولايات المتحدة، إلا أنها تُهمَل تمامًا في فرنسا، حيث يوجد ميل إلى الفصل التام بين الحياة الخاصة والعامة، وبين الشخصية والكفاءة. أعتقد أن النهج الصحيح يكمن بين هذين النقيضين: الإفراط في الوعظ الأخلاقي في الولايات المتحدة، والإهمال الكافي للأخلاق الشخصية للسياسيين في فرنسا. فبدون الوقوع في فخّ "مطاردة" الشخصيات العامة على الطريقة الأمريكية، علينا أن نتذكر، كما قال سقراط لألكيبيادس، أنه يجوز لنا التشكيك في مهارات الحكم الرشيد لرجلٍ أسيرٍ لشهواته. تتطلب أسمى المسؤوليات اكتساب فضائل معينة: ضبط النفس، والحكمة، واحترام الحق والعدل. كيف يُمكن لرجلٍ لم يكتسب هذه الفضائل الأخلاقية الأساسية أن يُطبّقها في حكم المدينة؟ عندما يُسيء المرء التصرف في أعلى مستويات الحكم، كيف نتوقع من الجميع أن يتصرفوا على نحوٍ حسن؟ قال كونفوشيوس لحاكم جي كانغ قبل ألفين وخمسمائة عام: "اسعَ إلى الخير بنفسك، وسيتحسن الناس. فضيلة الرجل الصالح كفضيلة الريح". "فضيلة الشعب كفضيلة العشب، تنحني مع اتجاه الريح" (المحادثات، 12/19). حتى وإن بدت هذه المقولة أبوية بعض الشيء في نظرنا المعاصر، إلا أنها لا تخلو من الحقيقة. [...]
عالم الأديان، العدد 47، مايو-يونيو 2011 — إن رياح الحرية التي تهب على الدول العربية في الأشهر الأخيرة تُقلق الحكومات الغربية. فبعد أن صُدمنا بالثورة الإيرانية، دعمنا الأنظمة الديكتاتورية لعقود، زاعمين أنها حصن منيع ضد الإسلاموية. لم نُعر اهتمامًا يُذكر لانتهاك أبسط حقوق الإنسان، ولا لانعدام حرية التعبير، ولا لسجن الديمقراطيين، ولا لنهب نخبة فاسدة صغيرة موارد البلاد لمصلحتها الخاصة... كنا ننام قريري العين: هؤلاء الديكتاتوريون الخاضعون حمونا من الاستيلاء المحتمل من قِبل الإسلاميين المتطرفين. ما نراه اليوم هو أن هؤلاء الناس ينتفضون لأنهم يطمحون، مثلنا، إلى قيمتين أساسيتين لكرامة الإنسان: العدالة والحرية. لم تُشن هذه الثورات على يد أيديولوجيين ملتحين، بل على يد شباب يائسين عاطلين عن العمل، ورجال ونساء متعلمين ساخطين، ومواطنين من جميع مناحي الحياة يطالبون بإنهاء القمع والظلم. هؤلاء أناسٌ يتوقون للعيش بحرية، ولتقاسم الموارد وتوزيعها بإنصاف، وللعدالة واستقلال الصحافة. هؤلاء الذين ظننا أنهم لا يستطيعون البقاء إلا تحت قبضة دكتاتورٍ مستبد، يُقدمون لنا اليوم درسًا نموذجيًا في الديمقراطية. فلنأمل ألا تُطفئ الفوضى أو القمع العنيف شعلة الحرية. وكيف لنا أن نتجاهل أننا شهدنا ثوراتنا قبل قرنين من الزمان للأسباب نفسها؟ لا شك أن الإسلام السياسي سمٌ قاتل. فمن اغتيال الأقباط في مصر إلى اغتيال حاكم البنجاب في باكستان الذي أيّد تعديل قانون التجديف، يبثّون الرعب بلا هوادة باسم الله، وعلينا أن نحارب بكل قوتنا انتشار هذا الشر. لكننا لن نوقفه بدعم الدكتاتوريات القمعية، بل على العكس تمامًا. نعلم أن الإسلام السياسي يتغذى على كراهية الغرب، وينبع جزء كبير من هذه الكراهية تحديدًا من ازدواجية المعايير التي نمارسها باستمرار باسم الواقعية السياسية: نعم للمبادئ الديمقراطية الكبرى، ولا لتطبيقها في الدول الإسلامية بهدف السيطرة عليها بشكل أفضل. أود أن أضيف أن هذا الخوف من سيطرة الإسلاميين يبدو لي مستبعدًا على نحو متزايد. ليس فقط لأن قادة الانتفاضات الحالية في تونس ومصر والجزائر بعيدون كل البعد عن الأوساط الإسلامية، بل أيضًا لأنه حتى لو كان من المؤكد أن تلعب الأحزاب الإسلامية دورًا هامًا في العملية الديمقراطية المقبلة، فإن فرصها في الفوز بالأغلبية ضئيلة للغاية. وحتى لو فازت، كما حدث في تركيا في منتصف التسعينيات، فلا يوجد ما يضمن أن يسمح لها الشعب بفرض الشريعة الإسلامية وإعفائها من الرقابة الانتخابية. فالشعوب التي تسعى للتخلص من دكتاتوريات طويلة الأمد لا ترغب في العودة إلى نير طغاة جدد يحرمونها من حرية طالما تاقت إليها ونالتها بشق الأنفس. لقد راقبت الشعوب العربية التجربة الإيرانية عن كثب، وهي تدرك تمامًا الاستبداد الذي يمارسه رجال الدين على المجتمع بأسره. ليس من المرجح أن يحلم جيرانهم بمثل هذا الأمر في الوقت الذي يسعى فيه الإيرانيون إلى الفرار من تجربة الحكم الديني القاسية. لذا، فلنُنحّي جانبًا مخاوفنا وحساباتنا السياسية الضيقة، ولندعم بحماس وإخلاص الشعب الذي ينتفض ضد طغاةه [...]
مجلة "عالم الأديان"، العدد 44، نوفمبر-ديسمبر 2010 - يملأني النجاح الباهر لفيلم كزافييه بوفوا "عن الآلهة والبشر" بفرحة غامرة. هذا الحماس مفاجئ حقًا، وأود أن أشرح هنا لماذا أثر هذا الفيلم فيّ، ولماذا أعتقد أنه أثر في الكثير من المشاهدين. تكمن قوته الأولى في ضبطه لنفسه وإيقاعه البطيء. لا خطابات رنانة، موسيقى قليلة، لقطات طويلة تركز فيها الكاميرا على الوجوه والإيماءات، بدلًا من سلسلة من اللقطات السريعة المتناوبة كما في الإعلانات الترويجية. في عالم صاخب ومزدحم، حيث كل شيء يتحرك بسرعة فائقة، يتيح لنا هذا الفيلم الانغماس لمدة ساعتين في زمن مختلف يقود إلى التأمل الذاتي. قد لا يجد البعض ذلك، وقد يشعرون ببعض الملل، لكن معظم المشاهدين يخوضون رحلة داخلية ثرية للغاية. فرهبان تيبحرين، الذين يجسدهم ممثلون بارعون، يجذبوننا إلى إيمانهم وشكوكهم. وهذه هي ثاني نقاط قوة الفيلم: فبعيدًا عن أي مقاربة ثنائية، يُظهر لنا الفيلم ترددات الرهبان، ونقاط قوتهم وضعفهم. وبتصوير واقعي مذهل، وبدعمٍ مثالي من الراهب هنري كوينسون، يرسم كزافييه بوفوا صورةً لرجالٍ يُمثلون نقيض أبطال هوليوود الخارقين، فهم مُعذبون وهادئون في آنٍ واحد، قلقون وواثقون، يُشككون باستمرار في حكمة البقاء في مكانٍ يُهددهم بالقتل في أي لحظة. هؤلاء الرهبان، الذين يعيشون حياةً مُختلفة تمامًا عن حياتنا، يُصبحون قريبين منا. نتأثر، مؤمنين وغير مؤمنين، بإيمانهم الراسخ ومخاوفهم؛ نفهم شكوكهم، ونشعر بتعلقهم بهذا المكان وبأهله. هذا الولاء لأهل القرية الذين يعيشون بينهم، والذي سيكون في النهاية السبب الرئيسي لرفضهم المغادرة، وبالتالي لنهايتهم المأساوية، يُشكل بلا شك نقطة القوة الثالثة للفيلم. لأن هؤلاء الشخصيات الدينية الكاثوليكية اختاروا العيش في بلد مسلم يحبونه بشدة، ويحافظون على علاقة ثقة وصداقة مع السكان المحليين، مما يدل على أن صراع الحضارات ليس حتميًا بأي حال من الأحوال. عندما يعرف الناس بعضهم بعضًا، وعندما يعيشون معًا، تتلاشى المخاوف والأحكام المسبقة، ويستطيع كل فرد ممارسة شعائره الدينية مع احترام شعائر الآخر. هذا ما عبّر عنه رئيس الدير، الأب كريستيان دي شيرجيه، بأسلوب مؤثر في وصيته الروحية، التي قرأها لامبرت ويلسون بصوته في نهاية الفيلم، عندما اختُطف الرهبان وانطلقوا نحو مصيرهم المأساوي: "إذا أصبحتُ يومًا ما - وقد يكون اليوم - ضحية للإرهاب الذي يبدو الآن أنه يستهدف جميع الأجانب المقيمين في الجزائر، فأود أن يتذكر مجتمعي وكنيستي وعائلتي أن حياتي وُهبت لله ولهذا البلد". لقد عشتُ ما يكفي لأدرك أنني متواطئ في الشر الذي، للأسف، يبدو أنه يسود العالم، وحتى في ذلك الشر الذي قد يصيبني دون أن أشعر. أتمنى، حين يحين الوقت، أن أحظى بلحظة صفاء ذهني تُمكنني من طلب مغفرة الله ومغفرة إخواني في الإنسانية، وأن أسامح من صميم قلبي كل من أساء إليّ. إن قصة هؤلاء الرهبان، بقدر ما هي شهادة على الإيمان، درسٌ حقيقي في الإنسانية. رابط الفيديو حفظ [...]
عالم الأديان، العدد 43، سبتمبر-أكتوبر 2010 — في مقالته الأخيرة*، يُبيّن جان بيير دينيس، رئيس تحرير الأسبوعية المسيحية "لا في"، كيف أصبحت الثقافة المضادة التحررية، التي انبثقت من أحداث مايو 1968، الثقافة السائدة على مدى العقود القليلة الماضية، بينما أصبحت المسيحية ثقافة مضادة هامشية. يُقدّم الكاتب تحليلاً ثاقباً، ويُدافع بأسلوب بليغ عن "مسيحية الاعتراض" التي لا هي غزوية ولا دفاعية. تُثير قراءة هذا العمل بعض التأملات، بدءاً بسؤال قد يبدو مُستفزاً للكثيرين، على أقل تقدير: هل كان عالمنا مسيحياً يوماً؟ لا يُمكن إنكار وجود ما يُسمى بالثقافة "المسيحية"، التي تميّزت بمعتقدات ورموز وطقوس الديانة المسيحية. لا شك أن هذه الثقافة قد تغلغلت بعمق في حضارتنا، لدرجة أن المجتمعات العلمانية لا تزال مشبعة بإرث مسيحي حاضر في كل مكان - التقويم، والأعياد، والمباني، والتراث الفني، والتعبيرات الشعبية، وما إلى ذلك. لكن ما يسميه المؤرخون "العالم المسيحي"، تلك الفترة الممتدة لألف عام من نهاية العصور القديمة إلى عصر النهضة، والتي شهدت التقاء الدين المسيحي بالمجتمعات الأوروبية، هل كان يومًا مسيحيًا حقًا بمعناه الأعمق، أي وفيًا لرسالة المسيح؟ بالنسبة لسورين كيركغارد، المفكر المسيحي المتحمّس والمتألم، "ليس العالم المسيحي برمته إلا محاولة من البشرية للنهوض من جديد، والتخلص من المسيحية". ما يؤكده الفيلسوف الدنماركي ببراعة هو أن رسالة يسوع ثورية تمامًا فيما يتعلق بالأخلاق والسلطة والدين، لأنها تضع الحب والعجز فوق كل شيء. لدرجة أن المسيحيين سرعان ما كيّفوها لتناسب العقل البشري بشكل أفضل من خلال إعادة صياغتها ضمن إطار الفكر والممارسات الدينية التقليدية. إن نشأة هذا "الدين المسيحي"، وما لحق به من تشويهٍ مذهل منذ القرن الرابع فصاعدًا، في تداخله مع السلطة السياسية، غالبًا ما يتعارض تمامًا مع الرسالة التي ألهمته. فالكنيسة ضرورية كجماعة من التلاميذ مهمتهم نقل ذكرى يسوع وحضوره من خلال السر الوحيد الذي أسسه (الإفخارستيا)، ونشر كلمته، وقبل كل شيء، الشهادة لها. ولكن كيف يمكن للمرء أن يتعرف على رسالة الإنجيل في القانون الكنسي، والوقار المصطنع، والنزعة الأخلاقية الضيقة، والتسلسل الهرمي الكنسي، وكثرة الأسرار المقدسة، والصراع الدموي ضد البدع، وسيطرة رجال الدين على المجتمع بكل ما يترتب على ذلك من تجاوزات؟ إن المسيحية هي الجمال السامي للكاتدرائيات، ولكنها أيضًا كل هذا. وإذ أقر أحد آباء المجمع الفاتيكاني الثاني بنهاية حضارتنا المسيحية، هتف قائلًا: "ماتت المسيحية، عاشت المسيحية!" أضاف بول ريكور، الذي روى لي هذه الحكاية قبل وفاته بسنوات قليلة: "بل أفضّل أن أقول: لقد ماتت المسيحية، فليحيا الإنجيل!، إذ لم يكن هناك مجتمع مسيحي حقيقي قط". ألا يُمثّل تراجع المسيحية في نهاية المطاف فرصةً لسماع رسالة المسيح من جديد؟ قال يسوع: "لا يُمكن وضع خمر جديد في زقاق قديمة". لعلّ الأزمة العميقة التي تُعاني منها الكنائس المسيحية هي مقدمة لنهضة جديدة للإيمان الحيّ الذي ورد في الأناجيل. إيمانٌ، لأنه يُشير إلى محبة القريب كعلامة على محبة الله، لا يخلو من تقارب قوي مع النزعة الإنسانية العلمانية لحقوق الإنسان التي تُشكّل أساس قيمنا الحديثة. إيمانٌ سيكون أيضًا قوة مقاومة شرسة ضدّ النزعات المادية والتجارية لعالمٍ يزداد تجريدًا من إنسانيته. لذلك، يُمكن أن يظهر وجه جديد للمسيحية من بين أنقاض "حضارتنا المسيحية"، التي لن يشعر المؤمنون المُتعلّقون بالإنجيل أكثر من تعلّقهم بالثقافة والتقاليد المسيحية بالحنين إليها. * لماذا تُثير المسيحية الفضائح (دار سوي للنشر، 2010). http://www.youtube.com/watch?v=fELBzF4iSg4 [...]
عالم الأديان، العدد 42، يوليو-أغسطس 2010 — إن استمرار المعتقدات والممارسات الفلكية في جميع ثقافات العالم أمرٌ مثيرٌ للدهشة، لا سيما بالنسبة للمتشككين. فمنذ أقدم حضارات الصين وبلاد ما بين النهرين، لم تخلُ أي منطقة ثقافية رئيسية من ازدهار المعتقدات الفلكية. وبينما كان يُعتقد أنها في طريقها إلى الزوال في الغرب منذ القرن السابع عشر وظهور علم الفلك العلمي، يبدو أنها عادت للظهور من جديد في العقود الأخيرة في شكلين: شعبي (أبراج الصحف) وثقافي - علم النفس الفلكي لخريطة الميلاد، والذي لا يتردد إدغار موران في تعريفه بأنه نوع من "العلم الجديد للموضوع". في الحضارات القديمة، كان علم الفلك والتنجيم متداخلين: فالمراقبة الدقيقة للقبة السماوية (علم الفلك) مكّنت من التنبؤ بالأحداث التي تقع على الأرض (التنجيم). إن هذا الترابط بين الظواهر الفلكية (كالكسوف، واقتران الكواكب، والمذنبات) والظواهر الأرضية (كالمجاعات، والحروب، ووفاة الملوك) هو أساس علم التنجيم. ورغم أنه يستند إلى آلاف السنين من الملاحظات، إلا أن التنجيم ليس علمًا بالمعنى الحديث للكلمة، إذ أن أساسه غير قابل للإثبات وممارسته عرضة لتفسيرات لا حصر لها. ولذلك، فهو معرفة رمزية، تقوم على الاعتقاد بوجود ترابط غامض بين العالم الأكبر (الكون) والعالم الأصغر (المجتمع، والفرد). في العصور القديمة، استمد التنجيم نجاحه من حاجة الإمبراطوريات إلى التمييز والتنبؤ بالاعتماد على نظام أعلى، ألا وهو الكون. فقد مكّنهم تفسير علامات السماء من فهم التحذيرات التي ترسلها الآلهة. ومن منظور سياسي وديني، تطور التنجيم عبر القرون نحو تفسير أكثر فردية وعلمانية. في روما، في مطلع عصرنا، كان الناس يستشيرون المنجمين لتحديد مدى ملاءمة إجراء طبي معين أو مشروع مهني محدد. ويكشف الإحياء الحديث لعلم التنجيم عن حاجة أكبر إلى معرفة الذات من خلال أداة رمزية، هي خريطة الميلاد، التي يُعتقد أنها تكشف شخصية الفرد والخطوط العريضة لمصيره. يُنبذ الاعتقاد الديني الأصلي، لكن لا يُنبذ الإيمان بالقدر، إذ يُفترض أن يولد الفرد في لحظة محددة تتجلى فيها إمكانات السماء. هذا القانون للتوافق الكوني، الذي يربط الكون بالبشرية، هو أيضًا أساس ما يُسمى بالباطنية، وهو تيار ديني متعدد الأوجه يوازي الأديان الكبرى، ويستمد في الغرب جذوره من الرواقية (روح العالم)، والأفلاطونية المحدثة، والهرمسية القديمة. وتساهم الحاجة الحديثة للتواصل مع الكون في هذه الرغبة في "إعادة سحر العالم"، وهي سمة مميزة لما بعد الحداثة. عندما انفصل علم الفلك عن التنجيم في القرن السابع عشر، كان معظم المفكرين مقتنعين بأن المعتقدات الفلكية ستختفي إلى الأبد، لتتحول إلى مجرد خرافات. لكن ظهر صوتٌ معارض: صوت يوهانس كيبلر، أحد مؤسسي علم الفلك الحديث، الذي واصل رسم الخرائط الفلكية، موضحًا أنه لا ينبغي البحث عن تفسير منطقي للتنجيم، بل الاعتراف بفعاليته العملية. واليوم، من الواضح أن التنجيم لا يشهد انتعاشًا في الغرب فحسب، بل لا يزال يُمارس في معظم المجتمعات الآسيوية، مُلبيًا بذلك حاجةً قديمة قدم البشرية نفسها: إيجاد المعنى والنظام في عالمٍ يبدو غير قابل للتنبؤ وفوضويًا. أتقدم بجزيل الشكر لصديقينا إيمانويل ليروي لادوري وميشيل كازيناف على كل ما قدماه من خلال مقالاتهما في صحيفتنا على مر السنين. وهما الآن يُسلمان الراية إلى ريمي براغ وألكسندر جوليان، اللذين يسعدنا انضمامهما إلينا. http://www.youtube.com/watch?v=Yo3UMgqFmDs&feature=player_embedded [...]
عالم الأديان، العدد 41، مايو-يونيو 2010 — نظرًا لأهميته الجوهرية في الوجود الإنساني، يكمن سؤال السعادة في صميم التقاليد الفلسفية والدينية العظيمة للبشرية. وينبع تجدد الاهتمام به في مجتمعاتنا الغربية في مطلع القرن الحادي والعشرين من انهيار الأيديولوجيات الكبرى واليوتوبيا السياسية التي سعت إلى تحقيق السعادة للبشرية. لقد فشلت الرأسمالية البحتة، تمامًا كما فشلت الشيوعية والقومية، كنظام جماعي للمعنى. وما تبقى إذن هو السعي الشخصي، الذي يُمكّن الأفراد من محاولة عيش حياة سعيدة. ومن هنا ينبع الاهتمام المتجدد بالفلسفات القديمة والشرقية، فضلًا عن ظهور حركات داخل الأديان التوحيدية، كالحركة الإنجيلية في العالم المسيحي، التي تُركز على السعادة الدنيوية، وليس فقط على الآخرة. عند قراءة وجهات النظر المتعددة التي عبّر عنها حكماء البشرية العظام ومعلموها الروحيون في هذه المجموعة، يلمس المرء توترًا مستمرًا، يتجاوز التنوع الثقافي، بين مفهومين للسعادة. من جهة، يُنظر إلى السعادة كحالة مستقرة، نهائية، ومطلقة. إنها الجنة الموعودة في الآخرة، والتي يمكن للمرء أن يتذوقها هنا على الأرض من خلال عيش حياة مقدسة. وهذا أيضًا هو مسعى حكماء البوذية والرواقية، الذي يهدف إلى تحقيق سعادة دائمة هنا والآن، بعيدًا عن كل معاناة هذا العالم. تكمن مفارقة هذا المسعى في أنه متاح نظريًا للجميع، ولكنه يتطلب زهدًا وتخليًا عن الملذات العادية، وهو ما لا يرغب فيه إلا قلة قليلة من الأفراد. على النقيض من ذلك، تُصوَّر السعادة على أنها عشوائية، ومؤقتة بالضرورة، وغير عادلة إلى حد ما، لأنها تعتمد بشكل كبير على شخصية كل فرد: فكما يذكرنا شوبنهاور، متأثرًا بأرسطو، تكمن السعادة في تحقيق إمكاناتنا، وهناك بالفعل تفاوت كبير في طباع كل شخص. السعادة، كما يوحي أصلها اللغوي، هي إذن نتيجة للحظ: "حسن الحظ". وتشير الكلمة اليونانية "eudaimonia" إلى امتلاك روح طيبة. ولكن بعيدًا عن هذا التنوع في وجهات النظر، ثمة شيء يتردد صداه لدى العديد من الحكماء من مختلف المدارس الفكرية، وأنا أؤيده تمامًا: السعادة في جوهرها تكمن في حب الذات والحياة حبًا سليمًا. حياة يتقبلها المرء كما هي، بما فيها من فرح وحزن، محاولًا دحر التعاسة قدر الإمكان، ولكن دون الوقوع في وهم السعادة المطلقة. تبدأ الحياة التي نحبها بتقبل أنفسنا وحبها كما هي، في "صداقة" مع ذواتنا، كما دعا مونتين. حياة يجب التعامل معها بمرونة، مواكبة حركتها الدائمة، كالتنفس، كما تذكرنا الحكمة الصينية. أفضل طريقة لنكون سعداء قدر الإمكان هي أن نقول "نعم" للحياة. شاهد الفيديو: حفظ حفظ حفظ حفظ [...]
مجلة "عالم الأديان"، العدد 40، مارس-أبريل 2010 — أثار قرار البابا بنديكت السادس عشر بمواصلة إجراءات تطويب البابا بيوس الثاني عشر جدلاً واسعاً، مُقسِّماً العالمين اليهودي والمسيحي. وقاطع رئيس الجالية الحاخامية في روما زيارة البابا إلى الكنيس الكبير في روما احتجاجاً على موقف بيوس الثاني عشر "السلبي" تجاه مأساة المحرقة. وبرر بنديكت السادس عشر مجدداً قرار تقديس سلفه، مُدعياً أنه لا يستطيع إدانة الفظائع التي ارتكبها النظام النازي بشكلٍ أكثر صراحةً دون المخاطرة بأعمال انتقامية ضد الكاثوليك، الذين كان اليهود المختبئون في الأديرة من أوائل ضحاياها. وهذا الادعاء وجيه تماماً. أكد المؤرخ ليون بولياكوف هذه النقطة بالفعل عام ١٩٥١، في الطبعة الأولى من كتابه "مختصر الكراهية: الرايخ الثالث واليهود": "من المؤلم ملاحظة أنه طوال فترة الحرب، بينما كانت مصانع الموت تعمل بكامل طاقتها، التزمت البابوية الصمت. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأنه كما أظهرت التجربة على المستوى المحلي، يمكن أن تُعقب الاحتجاجات العامة على الفور بعقوبات قاسية". حاول بيوس الثاني عشر، الدبلوماسي المحنك، الجمع بين المتناقضات: فقد دعم اليهود سرًا، وأنقذ حياة آلاف اليهود الرومان مباشرة بعد الاحتلال الألماني لشمال إيطاليا، بينما تجنب في الوقت نفسه إدانة المحرقة بشكل مباشر، حتى لا يقطع كل حوار مع النظام النازي ويمنع رد فعل وحشي. يمكن وصف هذا الموقف بأنه مسؤول وعقلاني وحكيم، بل وحتى حكيم. لكنه ليس نبويًا ولا يعكس أفعال قديس. مات يسوع على الصليب لأنه ظل وفيًا حتى النهاية لرسالته عن المحبة والحقيقة. بعده، ضحّى الرسولان بطرس وبولس بحياتهما لأنهما لم يتخلّيا عن إعلان رسالة المسيح أو يُكيّفاها مع الظروف "لأسباب دبلوماسية". تخيّل لو كانا بابا بدلاً من بيوس الثاني عشر؟ من الصعب تصوّرهما يُساومان مع النظام النازي، بل يختاران الموت مُرحّلين مع ملايين الأبرياء. هذا هو فعل القداسة، ذو الدلالة النبوية، الذي يُمكن توقّعه من خليفة بطرس في ظلّ هذه الظروف التاريخية المأساوية. بابا يُضحّي بحياته ويقول لهتلر: "أُفضّل الموت مع إخوتي اليهود على التغاضي عن هذه الفظاعة". بالتأكيد، كانت أعمال الانتقام ستكون مروّعة ضدّ الكاثوليك، لكن الكنيسة كانت ستُرسل رسالة ذات قوة غير مسبوقة إلى العالم أجمع. كان المسيحيون الأوائل قديسين لأنهم وضعوا إيمانهم ومحبّة جارهم فوق حياتهم. سيُعلن قداسة بيوس الثاني عشر لأنه كان رجلاً تقياً، وإدارياً كفؤاً في الكوريا الرومانية، ودبلوماسياً بارعاً. يوضح هذا الفرق الجوهري بين كنيسة الشهداء وكنيسة ما بعد قسطنطين، التي كانت أكثر اهتماماً بالحفاظ على نفوذها السياسي من اهتمامها بالشهادة للإنجيل [...]
عالم الأديان، العدد 39، يناير-فبراير 2010 — بعد مرور ما يقارب أربعة قرون على إدانة غاليليو، لا يزال النقاش العام حول موضوع العلم والدين يبدو منقسمًا بين طرفين متناقضين. فمن جهة، نجد الحماس الخلقي الذي يسعى إلى إنكار بعض النتائج العلمية التي لا جدال فيها باسم تفسير أصولي للكتاب المقدس. ومن جهة أخرى، نجد الاهتمام الإعلامي الذي توليه وسائل الإعلام لأعمال بعض العلماء، مثل ريتشارد دوكينز (وهم الإله، روبرت لافونت، 2008)، الذين يهدفون إلى إثبات عدم وجود الله باستخدام حجج علمية. ومع ذلك، فإن هذه المواقف هامشية إلى حد كبير في كلا المعسكرين. ففي الغرب، تقبل غالبية المؤمنين بشرعية العلم، ويؤكد معظم العلماء أن العلم لن يتمكن أبدًا من إثبات وجود الله أو عدم وجوده. في نهاية المطاف، وباستعارة عبارة من غاليليو نفسه، يُسلّم بأن العلم والدين يتناولان سؤالين مختلفين جذريًا، لا يمكن أن يتعارضا: "إن غاية الروح القدس هي أن يعلمنا كيف نصل إلى الجنة، لا كيف نصل إلى الجنة". في القرن الثامن عشر، أكد كانط مجددًا على التمييز بين الإيمان والعقل، واستحالة أن يجيب العقل المجرد على سؤال وجود الله. ومع ذلك، فقد وُلدت النزعة العلمية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأصبحت بحق "دين العقل"، تُعلن مرارًا وتكرارًا موت الله بفضل انتصارات العلم. ويُعد ريتشارد دوكينز أحد أحدث تجلياتها. كما ظهرت نظرية الخلق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كرد فعل على نظرية داروين في التطور. وقد أعقب نسختها الكتابية الأصولية نسخة أكثر اعتدالًا، تقبل نظرية التطور ولكنها تسعى إلى إثبات وجود الله من خلال العلم عبر نظرية التصميم الذكي. هذه الأطروحة مقبولة على نطاق أوسع، لكنها تقع في فخ الخلط بين المناهج العلمية والدينية. فإذا قبلنا هذا التمييز بين أشكال المعرفة، والذي أراه ركيزة أساسية في الفكر الفلسفي، فهل يُلزمنا ذلك بالقول باستحالة الحوار بين العلم والدين؟ وبشكل أعم، بين الرؤية العلمية والتصور الروحي للإنسانية والعالم؟ يُتيح ملف هذا العدد الفرصة لعلماء مرموقين عالميًا للدعوة إلى هذا الحوار. في الواقع، ليس رجال الدين هم من يدعون بشكل متزايد إلى حوار جديد بين العلم والروحانية، بل العلماء. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تطور العلم نفسه خلال القرن الماضي. فمنذ دراسة ما هو متناهي الصغر (عالم الجسيمات دون الذرية)، أظهرت نظريات ميكانيكا الكم أن الواقع المادي أكثر تعقيدًا وعمقًا وغموضًا مما كان يُمكن تصوره وفقًا لنماذج الفيزياء الكلاسيكية الموروثة من نيوتن. على النقيض تمامًا، في عالم الكون اللامتناهي الكبر، أدت الاكتشافات في الفيزياء الفلكية المتعلقة بأصول الكون، ولا سيما نظرية الانفجار العظيم، إلى دحض نظريات الكون الأبدي الساكن، التي اعتمد عليها العديد من العلماء لتأكيد استحالة وجود مبدأ إبداعي. وبدرجة أقل، تميل الأبحاث حول تطور الحياة والوعي الآن إلى تعديل الرؤى العلمية لـ"الصدفة التي تفسر كل شيء" و"الإنسان العصبي". في الجزء الأول من هذا الملف، يشارك العلماء الحقائق - ما تغير في العلم خلال القرن الماضي - وآراءهم الفلسفية: لماذا يمكن للعلم والروحانية أن ينخرطا في حوار مثمر مع احترام مناهجهما. ويذهب باحثون آخرون، بمن فيهم اثنان من الحائزين على جائزة نوبل، إلى أبعد من ذلك، ليقدموا شهاداتهم كعلماء ومؤمنين، موضحين سبب اعتقادهم بأن العلم والدين، بدلًا من أن يكونا متعارضين، يميلان إلى التقارب. يُخصّص الجزء الثالث من هذا الملف للفلاسفة: ما رأيهم في هذا النموذج العلمي الجديد، وفي خطاب هؤلاء الباحثين الذين يدعون إلى حوار جديد، أو حتى تقارب، بين العلم والروحانية؟ ما هي المنظورات المنهجية وحدود هذا الحوار؟ بعيدًا عن الجدال العقيم والعاطفي، أو على النقيض من ذلك، المقارنات السطحية، تبدو هذه أسئلة ونقاشات جوهرية لفهم أفضل للعالم ولأنفسنا [...]
عالم الأديان، نوفمبر-ديسمبر 2009 - تُثير الأديان الخوف. اليوم، يبرز البُعد الديني، بدرجات متفاوتة، في معظم النزاعات المسلحة. حتى دون ذكر الحرب، تُعدّ الخلافات المحيطة بالقضايا الدينية من بين الأكثر عنفًا في الدول الغربية. من المؤكد أن الدين يُفرّق بين الناس أكثر مما يوحّدهم. لماذا؟ منذ نشأته، امتلك الدين بُعدًا مزدوجًا للتواصل. عموديًا، يُنشئ رابطًا بين الناس ومبدأ أسمى، أيًا كان الاسم الذي نُطلقه عليه: روح، إله، المطلق. هذا هو بُعده الصوفي. أفقيًا، يجمع بين البشر الذين يشعرون بالوحدة من خلال هذا الإيمان المشترك بهذا التجاوز غير المرئي. هذا هو بُعده السياسي. يُعبّر عن هذا بوضوح من خلال الأصل اللاتيني لكلمة "religion": religere، "يربط". ترتبط الجماعة البشرية بمعتقدات مشتركة، وتكون هذه المعتقدات أقوى، كما أوضح ريجيس ديبري ببراعة، لأنها تُشير إلى كيان غائب، إلى قوة غير مرئية. وهكذا، يكتسب الدين بُعدًا بارزًا في تشكيل الهوية: يشعر كل فرد بالانتماء إلى جماعة من خلال هذا البُعد الديني، الذي يُشكّل أيضًا جزءًا هامًا من هويته الشخصية. يسود السلام عندما يتشارك جميع الأفراد نفس المعتقدات. يبدأ العنف عندما ينحرف بعض الأفراد عن المعيار السائد: وهذا هو الاضطهاد الأبدي لـ"الزنادقة" و"الكفار"، الذين يُهددون التماسك الاجتماعي للجماعة. يُمارس العنف أيضًا، بطبيعة الحال، خارج المجتمع، ضد مدن أو جماعات أو دول أخرى تحمل معتقدات مختلفة. وحتى عندما تكون السلطة السياسية منفصلة عن السلطة الدينية، غالبًا ما يستغل السياسيون الدين لما له من قدرة على حشد القوى لتشكيل الهوية. نتذكر صدام حسين، الكافر وقائد دولة علمانية، الذي دعا إلى الجهاد ضد "الصليبيين اليهود والمسيحيين" خلال حربَي الخليج. ويُقدّم تحقيقنا في المستوطنات الإسرائيلية مثالًا آخر. في عالم يتجه نحو العولمة بوتيرة متسارعة، مُؤجّجًا الخوف والرفض، يشهد الدين عودة ظهور سياسات الهوية في كل مكان. يخشى الناس الآخر، وينكفئون على أنفسهم وجذورهم الثقافية، فيُولدون التعصب. لكن ثمة نهج مختلف تمامًا للمؤمنين: التمسك بجذورهم مع الانفتاح والحوار مع الآخرين رغم اختلافهم، ورفض استغلال الدين من قِبل السياسيين لأغراض عدائية، والعودة إلى المبادئ الأساسية لكل دين، التي تُعلي قيم احترام الآخرين والسلام والترحيب بالغريب، وتجربة الدين في بُعده الروحي لا في بُعده القائم على الهوية. وبالاستناد إلى هذا التراث المشترك من القيم الروحية والإنسانية، بدلًا من تنوع الثقافات والمذاهب التي تُفرق بينها، يُمكن للأديان أن تُؤدي دورًا مُهدئًا على مستوى العالم. ما زلنا بعيدين عن ذلك، لكن العديد من الأفراد والجماعات يعملون على تحقيقه، وهذا جدير بالذكر. إذا كان، على حد تعبير بيغي، "كل شيء يبدأ بالتصوف وينتهي بالسياسة"، فليس من المستحيل على المؤمنين العمل على بناء فضاء سياسي عالمي سلمي، قائم على الأساس الصوفي المشترك للأديان: أولوية الحب والرحمة والمغفرة. أي العمل على بناء عالم أخوّي. لذا، لا أرى أن الأديان تشكل عائقًا لا يُمكن تجاوزه أمام هذا المشروع، الذي يتوافق مع رؤية الإنسانيين، سواء كانوا مؤمنين أو ملحدين أو لا أدريين. [...]
عالم الأديان، سبتمبر-أكتوبر 2009 - تمتلك فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوروبا. ومع ذلك، أثار النمو السريع للإسلام في أرض باسكال وديكارت خلال العقود القليلة الماضية مخاوف وتساؤلات. دعونا لا نتطرق حتى إلى الخطاب الخيالي لليمين المتطرف، الذي يحاول استغلال هذه المخاوف بالتنبؤ باضطراب في المجتمع الفرنسي تحت "ضغط دين مُقدّر له أن يصبح دين الأغلبية". والأهم من ذلك، أن بعض المخاوف مشروعة تمامًا: كيف يمكننا التوفيق بين تقاليدنا العلمانية، التي تُهمّش الدين في المجال الخاص، وبين المطالب الدينية الجديدة الخاصة بالمدارس والمستشفيات والأماكن العامة؟ كيف يمكننا التوفيق بين رؤيتنا للمرأة المتحررة وصعود دين ذي رموز هوية قوية، مثل الحجاب سيئ السمعة - ناهيك عن النقاب - الذي يُوحي لنا بخضوع المرأة لسلطة الرجل؟ هناك بالفعل صدام ثقافي وتضارب في القيم، ومن الخطورة إنكاره. لكن التساؤل أو التعبير عن النقد لا يعني ترسيخ الأحكام المسبقة أو وصم الآخرين بدافع دفاعي نابع من الخوف من الآخر واختلافه. لهذا السبب، خصصت مجلة "لوموند دي ريليجن" (Le Monde des Religions) مقالًا رئيسيًا من 36 صفحة للمسلمين الفرنسيين ومسألة الإسلام في فرنسا. لقد كانت هذه المسألة واقعًا ملموسًا على مدى قرنين من الزمان، منذ وصول المهاجرين الأوائل، بل وترسخت في مخيلتنا الجماعية لأكثر من اثني عشر قرنًا، مع الحروب ضد المسلمين ومعركة بواتييه الشهيرة. لذلك، من الضروري إلقاء نظرة تاريخية على هذه القضية لفهم المخاوف والأحكام المسبقة والقيمية التي نحملها تجاه دين محمد (وليس "محمد" كما تكتب وسائل الإعلام، متجاهلة أنه اسم تركي للنبي، ورثناه من الصراع ضد الإمبراطورية العثمانية). ثم حاولنا استكشاف طيف المسلمين الفرنسيين من خلال تقارير عن خمس مجموعات رئيسية شديدة التنوع (وليست حصرية): المهاجرون الجزائريون السابقون الذين قدموا للعمل في فرنسا منذ عام 1945 فصاعدًا؛ شباب مسلمون فرنسيون يُعطون الأولوية لهويتهم الدينية؛ وآخرون، مع تبنيهم للهوية الإسلامية، يسعون أولًا إلى إخضاعها للتفكير النقدي والقيم الإنسانية الموروثة من عصر التنوير؛ ومن نأوا بأنفسهم عن الإسلام كدين؛ وأخيرًا، المنتمون إلى الحركة السلفية الأصولية. تكشف هذه الفسيفساء من الهويات عن التعقيد الشديد لقضية حساسة للغاية من الناحية العاطفية والسياسية، لدرجة أن السلطات العامة ترفض استخدام الانتماءات الدينية والعرقية في التعدادات السكانية، والتي من شأنها أن تُتيح فهمًا أفضل للمسلمين الفرنسيين وأعدادهم. لذلك، بدا من المفيد لنا أن نختتم هذه السلسلة بمقالات تُحلل العلاقة بين الإسلام والجمهورية، أو قضية "الإسلاموفوبيا"، وأن نُتيح الفرصة لعدد من الأكاديميين ذوي منظور أكثر موضوعية. يُعد الإسلام ثاني أكبر ديانة في العالم من حيث عدد الأتباع، بعد المسيحية. وهو أيضًا ثاني أكبر ديانة في فرنسا، متأخرًا بفارق كبير عن الكاثوليكية، ولكنه متقدم بفارق كبير عن البروتستانتية واليهودية والبوذية. بغض النظر عن رأي المرء في هذا الدين، فهذه حقيقة. أحد أكبر التحديات التي تواجه مجتمعنا هو العمل على تحقيق أفضل اندماج ممكن للإسلام مع التقاليد الثقافية والسياسية الفرنسية. ولا يمكن تحقيق ذلك، للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء، في جو من الجهل أو انعدام الثقة أو العدوان [...]
عالم الأديان، يوليو/أغسطس 2009 - نحن غارقون في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أزمةٌ تُشكك في نموذجنا التنموي القائم على النمو المتواصل للإنتاج والاستهلاك. كلمة "أزمة" في اليونانية تعني "قرار" أو "حكم"، وتشير إلى لحظة محورية "يجب فيها اتخاذ قرار". نحن نمر بفترة حاسمة تتطلب اتخاذ خيارات جوهرية، وإلا سيزداد الوضع سوءًا، ربما بشكل دوري، ولكن حتمًا. وكما يُذكّرنا جاك أتالي وأندريه كونت سبونفيل في حوارهما الشيق، يجب أن تكون هذه الخيارات سياسية، تبدأ بإصلاح شامل ضروري وتنظيم أكثر فعالية وعدلًا للنظام المالي المختل الذي نعيش فيه اليوم. ويمكن أن تُؤثر هذه الخيارات بشكل مباشر على جميع المواطنين، من خلال توجيه الطلب نحو شراء سلع أكثر مراعاةً للبيئة ومسؤولية اجتماعية. من المؤكد أن التعافي الدائم من الأزمة سيعتمد على التزام حقيقي بتغيير قواعد اللعبة المالية وعاداتنا الاستهلاكية. ولكن من المرجح ألا يكون هذا كافيًا. إن أنماط حياتنا، القائمة على النمو المتواصل للاستهلاك، هي التي تحتاج إلى التغيير. فمنذ الثورة الصناعية، ولا سيما منذ ستينيات القرن الماضي، عشنا في حضارة تجعل من الاستهلاك المحرك الأساسي للتقدم. وهذا ليس محركًا اقتصاديًا فحسب، بل هو أيضًا محرك أيديولوجي: فالتقدم يعني امتلاك المزيد. والإعلانات، المنتشرة في كل مكان في حياتنا، تعزز هذا الاعتقاد بكل أشكاله. هل يمكننا أن نكون سعداء بدون أحدث سيارة؟ أو أحدث مشغل أقراص DVD أو هاتف محمول؟ أو تلفزيون وحاسوب في كل غرفة؟ نادرًا ما تُناقش هذه الأيديولوجية: طالما أن الأمر ممكن، فلماذا لا؟ ويتطلع معظم الناس حول العالم الآن إلى هذا النموذج الغربي، الذي يجعل من امتلاك السلع المادية وتكديسها وتبادلها المستمر المعنى الأسمى للوجود. عندما ينهار هذا النموذج، عندما ينحرف النظام عن مساره؛ عندما يتضح أننا ربما لا نستطيع الاستمرار في الاستهلاك إلى ما لا نهاية بهذه الوتيرة المحمومة، وأن موارد الكوكب محدودة، وأن المشاركة تصبح ضرورة ملحة؛ حينها فقط يمكننا طرح الأسئلة الصحيحة. يمكننا التساؤل عن معنى الاقتصاد، وقيمة المال، والشروط الحقيقية لتوازن المجتمع وسعادة الفرد. في هذا الصدد، أعتقد أن الأزمة قادرة، بل يجب أن تكون، على إحداث أثر إيجابي. فهي تُساعدنا على إعادة بناء حضارتنا، التي أصبحت عالمية لأول مرة، على معايير أخرى غير المال والاستهلاك. هذه الأزمة ليست اقتصادية ومالية فحسب، بل فلسفية وروحية أيضًا. إنها تُثير تساؤلات كونية: ما الذي يُمكن اعتباره تقدمًا حقيقيًا؟ هل يُمكن للبشر أن يكونوا سعداء ويعيشوا في وئام مع الآخرين في حضارة مبنية بالكامل على مُثُل التملك؟ على الأرجح لا. فالمال واقتناء السلع المادية ليسا سوى وسائل، مهما كانت قيمتها، لكنها ليست غاية في حد ذاتها. إن الرغبة في التملك، بطبيعتها، لا تُشبع. وهي تُولد الإحباط والعنف. فالبشر بطبيعتهم يرغبون باستمرار في امتلاك ما لا يملكون، حتى لو كان ذلك يعني انتزاعه بالقوة من جارهم. لكن بمجرد تلبية احتياجاتهم المادية الأساسية - الغذاء والمأوى ومستوى معيشي لائق - يحتاج الإنسان إلى تبني منطق آخر غير منطق التملك ليشعر بالرضا ويصبح إنسانًا كاملًا: منطق الوجود. عليه أن يتعلم معرفة نفسه والتحكم بها، وأن يفهم العالم من حوله ويحترمه. عليه أن يكتشف كيف يحب، وكيف يعيش مع الآخرين، وكيف يدير إحباطاته، ويكتسب السكينة، ويتغلب على معاناة الحياة الحتمية، بل وأن يستعد للموت بوعي كامل. فبينما الوجود حقيقة، فإن الحياة فن. فن يمكن تعلمه، من خلال التساؤل مع الحكماء والعمل على الذات. [...]
عالم الأديان، مايو-يونيو 2009 - أثار قرار الحرمان الكنسي الذي أصدره رئيس أساقفة ريسيفي بحق والدة الطفلة البرازيلية البالغة من العمر تسع سنوات، والفريق الطبي الذي أجرى لها عملية إجهاض بعد تعرضها للاغتصاب وحملها بتوأم، غضبًا عارمًا في الأوساط الكاثوليكية. وقد عبّر العديد من المؤمنين، من كهنة وحتى أساقفة، عن استنكارهم لهذا الإجراء التأديبي، الذي اعتبروه مفرطًا وغير لائق. وقد كان رد فعلي قويًا أيضًا، حيث سلطت الضوء على التناقض الصارخ بين هذا الإدانة القاسية والمتشددة ورسالة الإنجيل التي تدعو إلى الرحمة والتعاطف مع الآخرين، وتجاوز القانون من خلال المحبة. وبعد أن تهدأ حدة الغضب الأولي، يبدو من المهم إعادة النظر في هذه القضية، ليس لتأجيج المزيد من الغضب، بل لمحاولة تحليل المشكلة الأساسية التي تكشفها للكنيسة الكاثوليكية من منظور موضوعي. وفي مواجهة الغضب الشعبي إزاء هذا القرار، حاول مؤتمر الأساقفة البرازيلي التقليل من شأن الحرمان الكنسي وإعفاء والدة الطفلة، مدعيًا أنها تأثرت بالفريق الطبي. مع ذلك، كان الكاردينال باتيستا ري، رئيس مجمع الأساقفة، أكثر وضوحًا، إذ أوضح أن رئيس أساقفة ريسيفي كان ببساطة يُعيد التأكيد على القانون الكنسي. ينص هذا القانون على أن أي شخص يُجري عملية إجهاض يُحرم تلقائيًا من الشركة مع الكنيسة: "كل من يُسبب الإجهاض، إذا ترتب عليه أثر، يُحرم تلقائيًا" (القانون 1398). لا حاجة لأحد أن يُحرمه رسميًا: فهو قد حرم نفسه بفعله. بالتأكيد، كان بإمكان رئيس أساقفة ريسيفي الامتناع عن تأجيج الموقف باللجوء إلى القانون الكنسي، وبالتالي إثارة جدل عالمي، لكن هذا لا يُساهم في حل المشكلة الأساسية التي أثارت غضب الكثير من المؤمنين: كيف يُمكن لقانون مسيحي - لا يعتبر الاغتصاب، علاوة على ذلك، فعلًا خطيرًا بما يكفي لتبرير الحرمان الكنسي - أن يُدين من يُحاولون إنقاذ حياة فتاة مُغتصبة بإجراء عملية إجهاض لها؟ من الطبيعي أن يكون لأي دين قواعد ومبادئ وقيم، وأن يسعى للدفاع عنها. في هذه الحالة، يمكن فهم أن الكاثوليكية، كغيرها من الأديان، تعارض الإجهاض. ولكن هل ينبغي تكريس هذا التحريم في قانون جامد ينص على إجراءات تأديبية تلقائية، متجاهلاً اختلاف الحالات الفردية؟ في هذا الصدد، تختلف الكنيسة الكاثوليكية عن الأديان الأخرى والطوائف المسيحية، التي لا تملك ما يُعادل القانون الكنسي، الموروث من القانون الروماني، وإجراءاته التأديبية. فهي تدين بعض الأفعال من حيث المبدأ، لكنها تعرف أيضاً كيف تتكيف مع كل حالة على حدة، وتعتبر أن تجاوز القاعدة أحياناً يُعد "أهون الشرين". ويتضح هذا جلياً في حالة هذه الفتاة البرازيلية. وقد قال الأب بيير الشيء نفسه عن الإيدز: من الأفضل مكافحة خطر انتقال المرض من خلال العفة والإخلاص، ولكن بالنسبة لمن لا يستطيعون ذلك، فمن الأفضل استخدام الواقي الذكري بدلاً من نقل الموت. ويجب التذكير، كما فعل العديد من الأساقفة الفرنسيين، بأن رعاة الكنيسة يمارسون لاهوت "أهون الشرين" يوميًا، متكيفين مع الحالات الفردية، ومواسين من يمرون بظروف صعبة برحمة، مما يدفعهم أحيانًا إلى تجاوز القواعد. وبذلك، فهم ببساطة يطبقون رسالة الإنجيل: يدين يسوع الزنا نفسه، لا المرأة التي تُضبط متلبسة بالزنا، والتي يريد المتشددون في تطبيق الشريعة رجمها، والتي يقول لها هذا القول القاطع: "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر" (يوحنا 8). هل يمكن لجماعة مسيحية تسعى إلى الوفاء برسالة مؤسسها، وأن تظل مؤثرة في عالم يزداد حساسية لمعاناة كل فرد وتعقيداته، أن تستمر في تطبيق الإجراءات التأديبية بشكل عشوائي؟ ألا ينبغي لها أيضًا أن تؤكد، إلى جانب المثل الأعلى والمعيار، على ضرورة التكيف مع كل حالة على حدة؟ وقبل كل شيء، أن تشهد بأن المحبة أقوى من الشريعة؟ [...]
عالم الأديان، مارس-أبريل 2009 - الأزمة التي أثارها قرار البابا بنديكت السادس عشر برفع الحرمان الكنسي عن الأساقفة الأربعة الذين رُسِّموا على يد رئيس الأساقفة لوفيفر عام 1988 لم تنتهِ بعد. لا يمكن لأحد أن يلوم البابا على قيامه بواجبه في محاولة إعادة دمج المنشقين الذين يطالبون بذلك في الكنيسة. تكمن المشكلة في مكان آخر. كان هناك، بالطبع، تزامن هذا الإعلان مع نشر تصريحات إنكار المحرقة البغيضة لأحدهم، وهو الأسقف ويليامسون. إن عدم إبلاغ الكوريا الرومانية البابا بمواقف هذا المتطرف، المعروفة لدى الأوساط المطلعة منذ نوفمبر 2008، يُعد مؤشراً سيئاً. إن عدم اشتراط البابا بنديكت السادس عشر رفع الحرمان الكنسي (المنشور في 24 يناير) بتراجع فوري عن تلك التصريحات (التي أصبحت معروفة للعامة في 22 يناير)، وتأخره أسبوعًا كاملًا قبل إصدار بيان حاسم بشأن هذه المسألة، أمرٌ مثير للقلق. ليس المقصود هنا أنه يُشتبه بتواطئه مع المعادين للسامية الأصوليين - فقد أكد بوضوح تام في 12 فبراير أن "الكنيسة ملتزمة التزامًا عميقًا لا رجعة فيه برفض معاداة السامية" - لكن مماطلته أوحت بأنه جعل إعادة دمج الأصوليين أولوية مطلقة، بل تكاد تكون عمياء، رافضًا إدراك أن معظم هؤلاء المتشددين ما زالوا عالقين في وجهات نظر تتعارض تمامًا مع الكنيسة التي أسسها المجمع الفاتيكاني الثاني. برفع الحرمان الكنسي وبدء عملية دمج تهدف إلى منح جمعية القديس بيوس العاشر مكانة خاصة داخل الكنيسة، اعتقد البابا بلا شك أن آخر تلاميذ رئيس الأساقفة لوفيفر سيغيرون موقفهم في نهاية المطاف ويقبلون الانفتاح على العالم الذي دعا إليه المجمع الفاتيكاني الثاني. لكن المحافظين اعتقدوا عكس ذلك تمامًا. فقد صرّح الأسقف تيسييه دي ماليريه، أحد الأساقفة الأربعة الذين رُسِموا على يد رئيس الأساقفة لوفيفر، بعد أيام قليلة من رفع الحرمان الكنسي في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية: "لن نغير مواقفنا، لكننا نعتزم تغيير روما، أي جعل الفاتيكان يتبنى مواقفنا". قبل ذلك بستة أشهر، في المجلة الأمريكية "الملاك"، أكد الأسقف نفسه أن أولوية جمعية القديس بيوس العاشر هي "مثابرتنا على رفض أخطاء المجمع الفاتيكاني الثاني"، وتنبأ بظهور "جمهوريات إسلامية" في فرنسا وبريطانيا العظمى وألمانيا وهولندا. وفي روما، تُعتبر هذه نهاية الكاثوليكية، و"ارتدادًا منظمًا عن الديانة اليهودية". أصبحت جمعية القديس بيوس العاشر على وشك الانهيار، نظرًا لاختلاف مواقفها حول أفضل استراتيجية للتعامل مع روما. أمر واحد مؤكد: معظم هؤلاء المتطرفين الطائفيين لا ينوون التخلي عما شكّل أساس هويتهم ونضالهم على مدى الأربعين عامًا الماضية: رفض مبادئ الانفتاح على العالم، والحرية الدينية، والحوار مع الأديان الأخرى التي دعا إليها المجمع. كيف يُعقل أن يرغب البابا، من جهة، في ضم هؤلاء المتعصبين إلى الكنيسة بأي ثمن، وفي الوقت نفسه يسعى إلى الحوار مع الطوائف المسيحية الأخرى والأديان غير المسيحية؟ كان لدى يوحنا بولس الثاني وضوح الرؤية ليختار بشكل قاطع، وكان اجتماع أسيزي عام ١٩٨٦ مع الأديان الأخرى هو القشة التي قصمت ظهر البعير، ودفعت رئيس الأساقفة لوفيفر إلى قطع علاقته بروما. منذ انتخابه، اتخذ البابا بنديكت السادس عشر العديد من التصريحات تجاه الأصوليين، ويواصل تقويض الحوار المسكوني والحوار بين الأديان. ومن المفهوم وجود قلق بالغ بين العديد من الكاثوليك، بمن فيهم الأساقفة، الذين يتمسكون بروح الحوار والتسامح التي تبناها مجمعٌ كان يهدف إلى القطيعة، نهائيًا، مع روح الكاثوليكية المتشددة المعادية للحداثة، والرافضة للعلمانية والمسكونية وحرية الضمير وحقوق الإنسان. احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها، تقدم لكم صحيفة "لو موند دي ريليجن" شكلاً جديداً، يطور الصحيفة من حيث الشكل (تصميم جديد، المزيد من الرسوم التوضيحية) والمحتوى: ملف أكثر شمولاً مع مراجع ببليوغرافية، المزيد من الفلسفة تحت إشراف أندريه كونت سبونفيل، تصميم جديد - حيث تفسح أقسام "التاريخ" و"الروحانية" المجال لأقسام "المعرفة" و"التجربة" - وأقسام جديدة: "الحوار بين الأديان"، "24 ساعة في حياة..."، "3 مفاتيح لفهم فكر..."، "الفنان والمقدس"؛ عمود أدبي جديد بقلم ليلي أنور؛ المزيد من الصفحات المخصصة للأخبار الثقافية المتعلقة بالدين (السينما، المسرح، المعارض). [...]
عالم الأديان، يناير-فبراير 2009 - ثمة قواسم مشتركة أقل مما قد يتصوره المرء بين مختلف أديان العالم. وفوق كل ذلك، هناك القاعدة الذهبية الشهيرة، التي تُعبَّر عنها بألف طريقة مختلفة: لا تُعامل الآخرين بما لا تُحب أن يُعاملوك به. وهناك قاعدة أخرى، تُناقض هذا المبدأ تناقضًا صارخًا، وهي مُدهشة في قدمها ودوامها وشبه عالميتها: ازدراء المرأة. وكأن المرأة كائن بشري ناقص أو فاشل، أدنى شأنًا من الرجل. إن العناصر التاريخية والنصية التي نعرضها في ملف هذا العدد لدعم هذه الملاحظة المؤسفة بليغة للغاية. لماذا هذا الازدراء؟ لا شك أن الدوافع النفسية حاسمة. وكما يُذكِّرنا ميشيل كازيناف، مُقتديًا برواد التحليل النفسي، فإن الرجل يشعر بالغيرة من متعة المرأة وفي الوقت نفسه يخشى رغبته فيها. لا شك أن الجنسانية هي جوهر المشكلة، والرجال المسلمون الذين لا يتسامحون إلا مع النساء المحجبات لا يختلفون عن آباء الكنيسة الذين لم يروا في المرأة إلا مغريات محتملة. وهناك أيضًا أسباب اجتماعية وتاريخية لهذا الخضوع للمرأة في كل الثقافات تقريبًا، وهو خضوع ساهمت فيه الأديان بشكل حاسم. وتشهد عبادة "الإلهة العظيمة" القديمة جدًا على تمجيد المبدأ الأنثوي. وكان شيوخ الديانات الأولى للبشرية ذكورًا أو إناثًا، مثل الأرواح التي كانوا يعبدونها، كما يتضح من التقاليد الشفوية التي وصلت إلينا حتى يومنا هذا. لكن قبل بضعة آلاف من السنين، عندما تطورت المدن ونشأت الممالك الأولى، برزت الحاجة إلى التنظيم الاجتماعي، وظهرت إدارة سياسية ودينية. وكان الرجال هم من تولوا أدوار الحكم. وسرعان ما حوّل الكهنة المكلفون بإدارة العبادة الدينية الآلهة إلى آلهة ذكورية، واستولت الآلهة الذكور، انعكاسًا لما كان يحدث على الأرض، على السلطة في السماء. بدورها، لم تفعل الديانات التوحيدية سوى إعادة إنتاج هذا النموذج الوثني، بل وأحيانًا تضخيمه، من خلال إضفاء طابع ذكوري حصري على الإله الواحد. مفارقة عظيمة في الديانات منذ آلاف السنين: فرغم احتقار النساء في كثير من الأحيان، إلا أنهن غالبًا ما يمثلن جوهرها الحقيقي؛ فهن يصلين، وينقلن المعرفة، ويتعاطفن مع معاناة الآخرين. اليوم، تتطور المواقف بفضل علمنة المجتمعات الحديثة وتحرر المرأة الذي عززته. مع ذلك، تُظهر بعض الممارسات المروعة - مثل الهجمات الأخيرة بالأسيد على خمس عشرة فتاة أفغانية مراهقة في طريقهن إلى المدرسة في قندهار - وتصريحات عفا عليها الزمن - كتلك التي أدلى بها رئيس أساقفة باريس: "لا يكفي ارتداء التنانير، بل يجب أن يكون لديكِ أيضًا ما يكفي من المعرفة" - أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن تعترف التقاليد الدينية أخيرًا بمساواة المرأة بالرجل، وأن تمحو آثار كراهية النساء القديمة هذه من عقائدها وممارساتها. [...]
عالم الأديان، نوفمبر-ديسمبر 2008 - في الذكرى الأربعين لصدور الرسالة البابوية "هيوماني فيتاي"، أكد البابا بنديكت السادس عشر مجددًا معارضة الكنيسة الكاثوليكية لوسائل منع الحمل، باستثناء "مراعاة الإيقاعات الطبيعية لخصوبة المرأة" عندما يمر الزوجان "بظروف استثنائية" تبرر المباعدة بين الولادات. أثارت هذه التصريحات بطبيعة الحال موجة من الانتقادات التي سلطت الضوء مرة أخرى على التناقض بين العقيدة الأخلاقية للكنيسة والمعايير الاجتماعية المتطورة. لا يبدو لي هذا التناقض، في حد ذاته، نقدًا مبررًا. فالكنيسة ليست مؤسسة تجارية تسعى لترويج رسالتها بأي ثمن. كما أن كون خطابها لا يتماشى مع تطور مجتمعاتنا قد يكون أيضًا مؤشرًا صحيًا على مقاومة روح العصر. ليس دور البابا أن يبارك ثورة الأخلاق، بل أن يدافع عن حقائق معينة يؤمن بها، حتى لو كان ذلك على حساب فقدان بعض المؤمنين. إن النقد الحقيقي الذي يمكن توجيهه إلى هذا الاستنكار لمنع الحمل يتعلق بالحجة المستخدمة لتبريره. وقد أكد البابا بنديكت السادس عشر على هذه النقطة: إن استبعاد إمكانية إنجاب الحياة "عن طريق فعل يهدف إلى منع الإنجاب" يُعد بمثابة "إنكار لحقيقة الحب الزوجي الحميمة". من خلال ربط حب الزوجين بالإنجاب ربطًا وثيقًا، يظل تعليم الكنيسة متسقًا مع تقليد كاثوليكي قديم يعود إلى القديس أوغسطين، الذي لا يثق بالجسد واللذة الجسدية، ويتصور العلاقات الجنسية في نهاية المطاف من منظور الإنجاب فقط. وفقًا لهذا الرأي، هل يمكن لزوجين عقيمين أن يختبرا الحب حقًا؟ ومع ذلك، لا يوجد في الأناجيل ما يؤيد هذا التفسير، وتقدم التقاليد المسيحية الأخرى، ولا سيما الشرقية منها، منظورًا مختلفًا تمامًا عن الحب والجنس البشري. لذلك، ثمة مشكلة لاهوتية جوهرية هنا تستحق إعادة النظر فيها بالكامل، ليس بسبب تغير الأعراف الاجتماعية، بل بسبب نظرة مشكوك فيها للغاية للجنس والحب الزوجي. ناهيك عن العواقب الاجتماعية الوخيمة التي قد تترتب على مثل هذا الخطاب في المجتمعات الفقيرة، حيث يُعدّ منع الحمل في كثير من الأحيان الوسيلة الفعّالة الوحيدة لمكافحة الفقر المتزايد. وقد كتب رجال دين، مثل الأب بيير والأخت إيمانويل - وهي معمرة شابة أتمنى لها عيد ميلاد سعيد! - إلى البابا يوحنا بولس الثاني في هذا السياق. ومما لا شك فيه أن هذه الأسباب العميقة، وليس الثورة الجنسية فحسب، هي التي دفعت العديد من الكاثوليك إلى ترك الكنائس منذ عام ١٩٦٨. وكما ذكر الكاردينال إتشيغاراي مؤخرًا، شكّلت رسالة "هيوماني فيتاي" انشقاقًا صامتًا في وقتها، إذ صُدم العديد من المؤمنين برؤية الحياة الزوجية التي نقلتها الرسالة البابوية. هؤلاء الكاثوليك المحبطون ليسوا أزواجًا متحررين يدعون إلى ممارسة الجنس بلا قيود، بل هم مؤمنون يحبون بعضهم بعضًا ولا يفهمون لماذا يجب أن تُطمس حقيقة حبهم بحياة جنسية منفصلة عن الرغبة في إنجاب الأطفال. باستثناء الطوائف المتطرفة، لا توجد طائفة مسيحية أخرى، بل ولا أي دين آخر، يتبنى مثل هذا الرأي. لماذا لا تزال الكنيسة الكاثوليكية تخشى المتعة الجسدية إلى هذا الحد؟ يمكن فهم تأكيد الكنيسة على قدسية هبة الحياة. ولكن ألا تُشكل العلاقة الجنسية، عندما تُمارس في إطار حب صادق، تجربةً مقدسةً أيضاً؟ [...]
عالم الأديان، سبتمبر-أكتوبر 2008 - كما يشير اسمه، يهدف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أن يكون عالميًا، أي أنه ينطلق من أساس طبيعي وعقلاني يتجاوز جميع الاعتبارات الثقافية الخاصة: فبغض النظر عن مكان ميلادهم أو جنسهم أو دينهم، يتمتع جميع البشر بالحق في احترام سلامتهم الجسدية، والتعبير بحرية عن معتقداتهم، والعيش بكرامة، والعمل، والتعليم، وتلقي الرعاية الصحية. وبعد أن برز هذا الهدف العالمي في القرن الثامن عشر ضمن عصر التنوير الأوروبي، أعربت بعض الدول، على مدى العشرين عامًا الماضية تقريبًا، عن تحفظات جدية بشأن عالمية حقوق الإنسان. وهذه الدول هي في المقام الأول دول في آسيا وأفريقيا كانت ضحايا للاستعمار، وهي تُساوي بين عالمية حقوق الإنسان والموقف الاستعماري: فبعد أن فرض الغرب هيمنته السياسية والاقتصادية، يعتزم فرض قيمه على بقية العالم. وتعتمد هذه الدول على مفهوم التنوع الثقافي للدفاع عن فكرة نسبية حقوق الإنسان. تختلف هذه الحقوق باختلاف تقاليد وثقافة كل بلد. هذا المنطق مفهوم، لكن يجب ألا ننخدع به. فهو يخدم الأنظمة الديكتاتورية ويسمح باستمرار ممارسات تفرض هيمنة تقليدية على الفرد: هيمنة على المرأة بأشكال لا حصر لها (ختان الإناث، الإعدام بتهمة الزنا، وصاية الأب أو الزوج)، وعمالة الأطفال في سن مبكرة، ومنع تغيير الدين، وما إلى ذلك. أولئك الذين يرفضون عالمية حقوق الإنسان يدركون هذا جيدًا: فممارسة هذه الحقوق تُمكّن الفرد من التحرر من قيود الجماعة. وأي فرد لا يتوق إلى احترام سلامته الجسدية والمعنوية؟ مصلحة الجماعة ليست دائمًا مصلحة الفرد، وهنا يكمن خيار حضاري جوهري. من جهة أخرى، من المشروع تمامًا انتقاد الحكومات الغربية لعدم التزامها دائمًا بما تدعو إليه! ستكون شرعية حقوق الإنسان أقوى بكثير لو كانت الديمقراطيات مثالًا يُحتذى به. ومع ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، فإن الطريقة التي عامل بها الجيش الأمريكي السجناء العراقيين أو معتقلي غوانتانامو (التعذيب، وانعدام المحاكمات، والاغتصاب، والإذلال) قد أفقدت الغرب مصداقيته الأخلاقية تمامًا في نظر العديد من الشعوب التي نخاطبها بشأن حقوق الإنسان. ونتعرض لانتقادات محقة لغزو العراق باسم الدفاع عن قيم كالديمقراطية، في حين أن الاعتبارات الاقتصادية وحدها هي التي كانت تُؤخذ في الحسبان. ويمكننا أيضًا انتقاد مجتمعاتنا الغربية الحالية التي تعاني من النزعة الفردية المفرطة. فقد اختفى الشعور بالصالح العام إلى حد كبير، مما يُشكل تحديات أمام التماسك الاجتماعي. ولكن بين هذا الخلل وخلل مجتمع يخضع فيه الفرد كليًا لسلطة الجماعة والتقاليد، من ذا الذي سيختار الأخير حقًا؟ إن احترام حقوق الإنسان الأساسية يبدو لي إنجازًا جوهريًا، ونطاقه العالمي مشروع. ويكمن التحدي إذًا في إيجاد تطبيق متناغم لهذه الحقوق في ثقافات لا تزال متأثرة بشدة بالتقاليد، ولا سيما التقاليد الدينية، وهو أمر ليس بالهين دائمًا. ومع ذلك، عند الفحص الدقيق، فإن كل ثقافة تمتلك أساسًا جوهريًا لحقوق الإنسان، ولو فقط من خلال القاعدة الذهبية الشهيرة، التي كتبها كونفوشيوس منذ 2500 عام ونُقشت بطريقة أو بأخرى في قلب جميع الحضارات الإنسانية: "لا تفعل بالآخرين ما لا ترغب أن يُفعل بك" [...]
عالم الأديان، يوليو/أغسطس 2008 - قبل أشهر قليلة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في بكين، أعادت أعمال الشغب التي اندلعت في مارس الماضي في التبت القضية التبتية إلى دائرة الضوء الدولية. وأمام الغضب الشعبي، دعت الحكومات الغربية بالإجماع الحكومة الصينية إلى استئناف الحوار مع الدالاي لاما، الذي لم يعد يطالب، خلافًا لرغبة معظم مواطنيه، باستقلال بلاده، بل بالحكم الذاتي الثقافي داخل الصين. وقد أُجريت اتصالات مبدئية، لكن جميع المراقبين الفطناء يدركون أن فرص نجاحها ضئيلة للغاية. كان الرئيس الصيني الحالي، هو جين تاو، حاكمًا للتبت قبل عشرين عامًا، وقد قمع أعمال الشغب التي اندلعت بين عامي 1987 و1989 بعنف شديد حتى لُقّب بـ"جزار لاسا". وقد أكسبه هذا اللقب صعودًا صاروخيًا داخل الحزب، ولكنه غرس فيه أيضًا استياءً عميقًا من الزعيم التبتي الذي نال جائزة نوبل للسلام في العام نفسه. إن سياسة القيادة الصينية في تشويه صورة الدالاي لاما وانتظار موته، بالتزامن مع انتهاجها سياسة استعمارية وحشية في التبت، سياسة بالغة الخطورة. فعلى عكس ادعاءاتهم، لم تكن أعمال الشغب التي اندلعت في مارس الماضي، كما حدث قبل عشرين عامًا، بتحريض من الحكومة التبتية في المنفى، بل بتحريض من شباب تبتيين لم يعودوا قادرين على تحمل القمع الذي يعانونه: السجن بسبب آرائهم، ومنع التحدث باللغة التبتية في المكاتب الحكومية، والعقبات العديدة التي تحول دون ممارسة شعائرهم الدينية، والمحاباة الاقتصادية للمستوطنين الصينيين الذين يفوق عددهم عدد التبتيين، وغير ذلك. فمنذ غزو جيش التحرير الشعبي الصيني للتبت عام 1950، لم تُسفر سياسة العنف والتمييز هذه إلا عن تعزيز النزعة القومية لدى التبتيين، الذين كانوا في السابق متمردين على الدولة، والذين شعروا بانتمائهم إلى التبت من خلال الهوية المشتركة للغة والثقافة والدين، أكثر من شعورهم بالانتماء إلى دوافع سياسية. لم تُؤدِّ قرابة ستين عامًا من الاستعمار الوحشي إلا إلى تعزيز هذا الشعور القومي، وترغب أغلبية ساحقة من التبتيين في استعادة استقلال بلادهم. وحده شخصٌ يتمتع بالشرعية والكاريزما كالدالاي لاما قادر على إقناعهم بالتخلي عن هذا المطلب المشروع والتوصل إلى اتفاق مع السلطات في بكين بشأن شكل من أشكال الحكم الذاتي الثقافي التبتي ضمن فضاء وطني صيني، حيث يمكن للشعبين محاولة التعايش بانسجام. في الثاني والعشرين من مارس/آذار، نشر ثلاثون مثقفًا صينيًا معارضًا يعيشون في الصين مقالًا جريئًا في الصحافة الأجنبية، مؤكدين أن تشويه صورة الدالاي لاما ورفض تقديم أي تنازلات جوهرية للتبت يقود الصين إلى طريق مسدود مأساوي يتمثل في القمع الدائم. لا يؤدي هذا القمع إلا إلى تعزيز المشاعر المعادية للصين لدى الشعوب الثلاثة الرئيسية المستعمرة - التبتيون، والإيغور، والمغول - الذين تُطلق عليهم السلطات الشيوعية اسم "الأقليات"، والذين لا يمثلون سوى 3% من السكان، لكنهم يشغلون ما يقرب من 50% من الأراضي. فلنأمل ألا تكون دورة الألعاب الأولمبية في بكين دورةً مخزيةً، بل دورةً تُتيح للسلطات الصينية تسريع انفتاحها على العالم وعلى قيم احترام حقوق الإنسان، بدءًا من حرية الأفراد والشعوب في تقرير مصيرهم. [...]
عالم الأديان، مايو-يونيو 2008 - شهدت الأشهر القليلة الماضية جدلاً واسعاً حول موضوع بالغ الحساسية في فرنسا، ألا وهو العلاقة بين الجمهورية والدين. فكما نعلم، بُنيت الأمة الفرنسية على تحرير مؤلم للمجال السياسي من الدين. فمنذ الثورة الفرنسية وحتى قانون فصل الدين عن الدولة لعام 1905، خلّفت عنف الصراعات بين الكاثوليك والجمهوريين ندوباً عميقة. وبينما لعب الدين دوراً هاماً في بناء السياسة الحديثة في بلدان أخرى، ولم يكن فصل السلطات فيها موضع خلاف، اتسمت العلمانية الفرنسية بطابعها النضالي. أتفق مبدئياً مع فكرة نيكولا ساركوزي بالانتقال من العلمانية النضالية إلى علمانية أكثر سلمية. ولكن أليس هذا هو الواقع بالفعل؟ إن رئيس الجمهورية مُحِقٌّ في تأكيده على أهمية التراث المسيحي، وفي شدده على الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه الأديان، سواء في المجالين الخاص والعام. تكمن المشكلة في أن تصريحاته تجاوزت الحد، مما أثار ردود فعل قوية، وهو أمرٌ مُبرَّر. في روما (20 ديسمبر)، قارن البابا بين الكاهن والمعلم، رمز الجمهورية العلمانية، مؤكدًا تفوق الأول على الثاني في غرس القيم. أما تصريح الرياض (14 يناير) فهو أكثر إشكالية. فبينما يُشير نيكولا ساركوزي، مُحِقًّا، إلى أن "الخطر ليس في المشاعر الدينية، بل في استغلالها لأغراض سياسية"، يُدلي بتصريح إيماني مُثير للدهشة: "إلهٌ مُتعالٍ حاضرٌ في أفكار وقلوب كل إنسان. إلهٌ لا يستعبد البشرية بل يُحررها". لم يكن البابا ليُعبّر عن ذلك أفضل من هذا. وبالفعل، تُثير هذه التصريحات، الصادرة عن رئيس دولة علمانية، الاستغراب. ليس الأمر أن نيكولا ساركوزي، كشخص، لا يملك الحق في اعتناق مثل هذه الآراء، ولكن عندما تُعبّر عنها في سياق رسمي، فإنها تُلزم الأمة، ولا يُمكن إلا أن تُصدم، بل وتُثير استياء، جميع الفرنسيين الذين لا يُشاركون السيد ساركوزي آراءه الروحية. يجب على رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، الحفاظ على الحياد تجاه الأديان: فلا ينتقص منها ولا يدافع عنها. قد يُعترض بأن الرؤساء الأمريكيين لا يترددون في الإشارة إلى الله في خطاباتهم، رغم أن الدستور الأمريكي يفصل بين السلطات السياسية والدينية بشكل رسمي كما هو الحال لدينا. صحيح، لكن الإيمان بالله وبالدور المسياني للأمة الأمريكية من الحقائق البديهية التي يشترك فيها غالبية الشعب، ويشكل أساسًا لنوع من الدين المدني. في فرنسا، لا يوحد الدين، بل يفرق. وكما نعلم، فإن الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة. فبنية نبيلة للتوفيق بين الجمهورية والدين، يخاطر نيكولا ساركوزي، بسبب غفلته وحماسته المفرطة، بإحداث عكس النتيجة المرجوة تمامًا. وقد ارتكبت زميلته إيمانويل ميغنون الخطأ نفسه في قضية الطوائف الحساسة بنفس القدر. في محاولة منها للتخلي عن سياسة التبسيط المفرط التي تُوصم بها الجماعات الدينية الأقلية - وهي سياسة أدانها العديد من الخبراء القانونيين والأكاديميين (وقد انتقدتُ شخصيًا بشدة تقرير البرلمان لعام 1995 والقائمة الشاذة التي رافقته) - إلا أنها بالغت في تأكيدها على أن الطوائف الدينية "ليست قضيةً تُذكر". ونتيجةً لذلك، يجد أولئك الذين تنتقدهم بحق سهولةً في تذكير الجميع، وبحق أيضًا، بوجود انتهاكات خطيرة تُشبه انتهاكات الطوائف الدينية، والتي لا يُمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها قضيةً لا تُذكر! وللمرة الأولى، عندما تُناقش المسألة الدينية على أعلى مستويات الحكومة بطريقة جديدة وصريحة، فمن المؤسف أن المواقف القطعية أو غير المناسبة تجعل هذا الخطاب غير مسموع وذا نتائج عكسية. [...]
عالم الأديان، مارس-أبريل 2008 — عزيزي ريجيس ديبري، في مقالك، الذي أنصح القارئ بقراءته قبل المتابعة، أثرتَ نقطةً بالغة الأهمية بالنسبة لي. حتى وإن كنتَ تُبسّط أطروحتي حول المسيحية بعض الشيء، فإنني أُقرّ تمامًا باختلاف وجهات نظرنا. فأنت تُشدّد على طابعها الجماعي والسياسي، بينما أُصرّ على الطبيعة الشخصية والروحية لرسالة مؤسسها. وأتفهم تمامًا أنك تُشكّك في أساس الرابطة الاجتماعية. في كتاباتك السياسية، بيّنتَ بشكلٍ مُقنع أنها تستند دائمًا، بشكلٍ أو بآخر، إلى عنصر "خفي"، أي شكلٍ من أشكال التسامي. كان إله المسيحيين هو هذا التسامي في أوروبا حتى القرن الثامن عشر؛ ثمّ تلا ذلك تأليه العقل والتقدّم، ثمّ عبادة الأمة والأيديولوجيات السياسية الكبرى في القرن العشرين. بعد الفشل المأساوي أحيانًا لهذه الأديان العلمانية، أشارككم قلقكم إزاء الدور المتنامي للمال كشكل جديد من أشكال الدين في مجتمعاتنا الفردية. ولكن ما العمل؟ هل ينبغي لنا أن نتوق إلى المسيحية، أي إلى مجتمع تحكمه المسيحية، كما توجد مجتمعات يحكمها الإسلام اليوم؟ هل نشتاق إلى مجتمع ضُحّيَ على مذبحه بالحرية الفردية والحق في اختلاف الأفكار والأديان؟ ما أنا مقتنع به هو أن هذا المجتمع، الذي حمل اسم "المسيحي" والذي حقق إنجازات عظيمة، لم يكن وفيًا حقًا لرسالة يسوع، الذي دعا، من جهة، إلى فصل السياسة عن الدين، ومن جهة أخرى، أصرّ على الحرية الفردية وكرامة الإنسان. لا أقول إن المسيح أراد إلغاء الدين برمته، بطقوسه وعقائده، باعتباره أساس المجتمع، بل أردت أن أبين أن جوهر رسالته يميل إلى تحرير الفرد من الجماعة من خلال التأكيد على الحرية الشخصية والحقيقة الداخلية والكرامة المطلقة. لدرجة أن أقدس قيمنا الحديثة - قيم حقوق الإنسان - تستمد جذورها إلى حد كبير من هذه الرسالة. المسيح، كبوذا من قبله، وعلى عكس مؤسسي الأديان الآخرين، لا يهتم بالسياسة بالدرجة الأولى. إنه يقترح ثورة في الوعي الفردي قادرة على أن تؤدي، على المدى البعيد، إلى تغيير في الوعي الجماعي. فبفضل كون الأفراد أكثر عدلاً ووعياً وصدقاً ومحبة، ستتطور المجتمعات في نهاية المطاف. لا يدعو يسوع إلى ثورة سياسية، بل إلى تحول شخصي. فهو يعارض المنطق الديني القائم على طاعة التقاليد، ويعارض منطق المسؤولية الفردية. أقر بأن هذه الرسالة تبدو مثالية إلى حد ما، وأننا نعيش حالياً في فوضى معينة حيث لم تعد طرق التفكير القديمة، القائمة على طاعة القوانين المقدسة للجماعة، فعالة، وحيث لا يزال قليل من الأفراد ملتزمين بمسار حقيقي من المحبة والمسؤولية. ولكن من يدري ما سيحدث بعد بضعة قرون؟ أودّ أن أضيف أن هذه الثورة في الوعي الفردي لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع المعتقدات الدينية أو السياسية التي يشترك فيها عامة الناس، ولا مع ترسيخ الرسالة في المؤسسات، وهو أمرٌ أشرتَ إليه بحقّ. إلا أنها قد تفرض عليها قيدًا: ألا وهو احترام كرامة الإنسان. في رأيي، هذا هو جوهر تعاليم المسيح، التي لا تنفي الدين بأي حال من الأحوال، بل تُؤطّره ضمن ثلاثة مبادئ لا تُنتهك: المحبة، والحرية، والعلمانية. ويبدو لي أن هذا شكلٌ من أشكال القداسة قادرٌ على التوفيق بين المؤمنين وغير المؤمنين اليوم. [...]
عالم الأديان، يناير-فبراير 2008 - تدور أحداث القصة في المملكة العربية السعودية. تلتقي امرأة متزوجة تبلغ من العمر 19 عامًا بصديق طفولتها، فيدعوها إلى سيارته ليلتقط لها صورة. فجأة، يظهر سبعة رجال ويختطفونهما، ويعتدون على الرجل ويغتصبون المرأة مرارًا. تقدمت المرأة بشكوى. حُكم على المغتصبين بأحكام مخففة، لكن المحكمة حكمت أيضًا على الضحية وصديقها بـ 90 جلدة بتهمة الخلوة مع شخص من الجنس الآخر ليس من أفراد أسرتهما (وهي جريمة تُسمى الخلوة في الشريعة الإسلامية). قررت الشابة استئناف الحكم، واستعانت بمحامٍ، ونشرت القضية. في 14 نوفمبر، رفعت المحكمة عقوبتها إلى 200 جلدة، وأضافت إليها ست سنوات أخرى في السجن. أوضح مسؤول في محكمة القطيف العامة، التي أصدرت الحكم في 14 نوفمبر، أن المحكمة شددت عقوبة المرأة بسبب "محاولتها تأجيج الموقف والتأثير على القضاء عبر وسائل الإعلام". كما مارست المحكمة ضغوطًا على محاميها، ومنعته من تولي القضية، وصادرت رخصته المهنية. وقد تبنت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية القضية، وتسعىان للتدخل لدى الملك عبد الله لإلغاء قرار المحكمة الجائر. ربما ينجحان؟ ولكن مقابل كل امرأة تحلت بالشجاعة للتحدث علنًا ونشر قصتها المؤلمة، كم من النساء الأخريات يتعرضن للاغتصاب دون أن يجرؤن على تقديم شكوى خوفًا من اتهامهن بإغواء المغتصب أو بإقامة علاقات غير شرعية مع رجل ليس زوجهن؟ إن وضع المرأة في السعودية، كما هو الحال في أفغانستان وباكستان وإيران وغيرها من الدول الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية بصرامة، لا يُطاق. في السياق الدولي الراهن، يُنظر إلى أي انتقاد من المنظمات غير الحكومية أو الحكومات الغربية على أنه تدخل غير مقبول، ليس فقط من قبل السلطات السياسية والدينية، بل أيضًا من قبل شريحة من السكان. لذا، فإن وضع المرأة في الدول الإسلامية لا يملك فرصة حقيقية للتحسن إلا إذا تفاعل الرأي العام في هذه الدول أيضًا. وقد حظيت القضية التي ذكرتها للتو باهتمام إعلامي واسع وأثارت ضجة في السعودية. بفضل الشجاعة الاستثنائية لبعض النساء ضحايا الظلم، وكذلك الرجال الذين يتفهمون محنتهن، سيتغير الوضع. في البداية، يمكن لهؤلاء المصلحين الاستناد إلى التراث لإثبات وجود قراءات وتفسيرات بديلة للقرآن والشريعة، تمنح المرأة مكانة أسمى وتوفر لها حماية أكبر من تعسف القوانين الأبوية. هذا ما حدث في المغرب عام ٢٠٠٤ مع إصلاح قانون الأسرة، الذي يمثل تقدماً ملحوظاً. ولكن بمجرد اتخاذ هذه الخطوة الأولى، ستواجه الدول الإسلامية حتماً تحدياً أعمق، ألا وهو التحرر الحقيقي للمرأة من مفهوم ديني وقانون وُضعا قبل قرون في مجتمعات أبوية لم تعترف بأي مساواة بين الرجل والمرأة. لقد مكّنت العلمانية هذه الثورة الحديثة في المواقف في الغرب. ومما لا شك فيه أن التحرر النهائي للمرأة في العالم الإسلامي سيتطلب أيضاً فصلاً تاماً بين الدين والسياسة. [...]
عالم الأديان، سبتمبر-أكتوبر 2007 - لقد فوجئتُ إلى حدٍ ما بسيل الانتقادات، حتى داخل الكنيسة نفسها، التي أثارها قرار البابا بإعادة القداس اللاتيني. على مدى العامين الماضيين، أشرتُ مرارًا وتكرارًا إلى سياسات البابا بنديكت السادس عشر الرجعية للغاية في جميع المجالات، لذا لا يسعني إلا أن أدافع عنه هنا! من الواضح أن البابا يريد إعادة إحياء ما كان يُعتبر تقليدًا خاطئًا من قِبَل رئيس الأساقفة لوفيفر. لكن لا مجال للانتهازية من جانبه، فقد كرّر الكاردينال راتزينغر بلا كلل لأكثر من ثلاثين عامًا قلقه من تطبيق الإصلاحات الليتورجية للمجمع الفاتيكاني الثاني، ورغبته في منح المؤمنين حرية الاختيار بين الطقس الجديد والقديم الموروث من البابا بيوس الخامس (الذي أصدره عام 1570). سيتحقق ذلك ابتداءً من 14 سبتمبر. فلماذا الاعتراض على إجراء يُتيح للمؤمنين، في خطوة نادرة، حرية اختيار حقيقية؟ بمجرد تجريد الطقوس القديمة من عباراتها المعادية للسامية، التي شهدت على معاداة السامية المسيحية المتأصلة التي استمرت حتى المجمع الفاتيكاني الثاني، أعجز عن فهم كيف يمكن لقداس بيوس الخامس، الذي يُقام والمصلون فيه يواجهون غيرهم وباللغة اللاتينية، أن يشكل انتكاسة خطيرة للكنيسة. على النقيض من ذلك، تُقنعني ثلاث تجارب شخصية بصواب البابا. لقد أذهلني، عند زيارتي لمدينة تايزيه، أن أرى آلاف الشباب من جميع أنحاء العالم يُنشدون باللاتينية! شرح لي الأخ روجر السبب حينها: نظراً لتنوع اللغات المُتحدث بها، فقد رسخت اللاتينية مكانتها كلغة طقسية يُمكن للجميع استخدامها. حدثت تجربة مماثلة في كلكتا، في كنيسة راهبات المحبة التابعة للأم تيريزا، خلال قداس أُقيم للمتطوعين الذين قدموا من جميع أنحاء العالم: تمكن الجميع تقريباً من المشاركة في القداس لأنه كان يُقام باللاتينية، ومن الواضح أن ذكريات الطفولة لدى المشاركين كانت لا تزال حاضرة بقوة. اللاتينية، اللغة الليتورجية العالمية للكنيسة الكاثوليكية، إلى جانب القداسات باللغات المحلية - لم لا؟ تجربة أخيرة، صادفتها خلال بحث اجتماعي أجريته قبل نحو عشر سنوات مع عشرات الفرنسيين من أتباع البوذية التبتية: فوجئتُ جدًا عندما سمعت من بعضهم أنهم يُقدّرون الطقوس التبتية لأنها تُؤدى بلغة ليست لغتهم الأم! أخبروني أنهم وجدوا قداس الأحد بالفرنسية فقيرًا ويفتقر إلى القداسة، بينما شعروا بالقداسة في الممارسات التبتية. كانت التبتية بمثابة لاتينيتهم. من يدري: قد لا يُعيد البابا بنديكت السادس عشر الأصوليين فقط إلى حظيرة الكنيسة (1). ... تأسست مجلة "عالم الأديان" في سبتمبر 2003، وتحتفل اليوم بذكراها السنوية الرابعة. بإمكانكم الحكم على جودة المجلة بأنفسكم. لكن النتائج المالية إيجابية للغاية. بلغ متوسط توزيع المجلة 42,000 نسخة عام 2004، ثم قفز إلى 57,000 نسخة عام 2005، واستمر نموه القوي بمتوسط توزيع بلغ 66,000 نسخة عام 2006. ووفقًا لمجلة "ستراتيجيز"، حققت "لو موند دي ريليجن" ثالث أعلى معدل نمو بين المطبوعات الفرنسية عام 2006. وهذه فرصة لأشكركم، أيها القراء الأعزاء، وكل من يساهم في المجلة، ولأطلعكم على إعادة تصميم صفحات المنتدى، التي أصبحت الآن أكثر حيوية. كما أود أن أشكر جان ماري كولومباني، الذي تنحى هذا الصيف عن منصبه كمدير لمجموعة "لا في لو موند". فلولاه، لما وُجدت "لو موند دي ريليجن". عندما عيّنني رئيسًا للتحرير، أخبرني بمدى أهمية وجود مجلة تتناول القضايا الدينية من منظور علماني بحت. لقد دعمنا باستمرار، حتى عندما كانت المجلة لا تزال تعاني من خسائر، ومنحنا دائمًا حرية كاملة في خياراتنا التحريرية. (1) انظر المناقشة في الصفحة 17. [...]
عالم الأديان، نوفمبر-ديسمبر 2007 - شكّت الأم تيريزا في وجود الله. لعقود، شعرت أن السماء خالية. كان هذا الكشف صادمًا. تبدو الحقيقة مذهلة بالنظر إلى إشاراتها المتكررة إلى الله. مع ذلك، الشك ليس إنكارًا لله، بل هو تساؤل، والإيمان ليس يقينًا. غالبًا ما يُخلط بين اليقين والاقتناع. يأتي اليقين من أدلة حسية لا جدال فيها (هذه القطة سوداء) أو من معرفة عقلانية شاملة (قوانين العلم). أما الإيمان فهو قناعة فردية وذاتية. بالنسبة لبعض المؤمنين، يشبه رأيًا غامضًا أو إرثًا لا جدال فيه؛ وبالنسبة لآخرين، هو قناعة راسخة وقوية إلى حد ما. لكن في جميع الأحوال، لا يمكن أن يكون يقينًا حسيًا أو عقلانيًا: لن يمتلك أحد دليلًا قاطعًا على وجود الله. الإيمان لا يعني المعرفة. سيظل لدى المؤمنين وغير المؤمنين حجج قوية لتفسير وجود الله من عدمه: لن يثبت أحد أي شيء. كما بيّن كانط، فإن نظام العقل يختلف جوهريًا عن نظام الإيمان. فالإلحاد والإيمان مسألتان قناعة، بل إن عددًا متزايدًا من الناس في الغرب يُعرّفون أنفسهم بأنهم لا أدريون: فهم يُقرّون بعدم امتلاكهم قناعة قاطعة في هذه المسألة. ولأن الإيمان لا يستند إلى دليل حسي (فالله غير مرئي) ولا إلى معرفة موضوعية، فإنه يستلزم بالضرورة الشك. وما يبدو متناقضًا، ولكنه منطقي تمامًا، هو أن هذا الشك يتناسب طرديًا مع قوة الإيمان نفسه. فالمؤمن الذي لا يلتزم إيمانه بوجود الله إلا قليلًا، سيُعاني من الشكوك بشكل أقل؛ فلن يُؤثر إيمانه ولا شكوكه تأثيرًا عميقًا على حياته. وعلى النقيض، فإن المؤمن الذي اختبر لحظات إيمان عميقة ومُلهمة، أو حتى الذي كرّس حياته كلها للإيمان كالأم تيريزا، سيشعر في النهاية بغياب الله ألمًا شديدًا. وسيُصبح الشك محنة وجودية. هذا ما يختبره ويصفه كبار المتصوفين، مثل تيريزا دي ليزيو ويوحنا الصليب، عندما يتحدثون عن "ليلة الروح المظلمة"، حيث تنطفئ كل الأنوار الداخلية، تاركةً المؤمن في أشد حالات إيمانه عُريًا لأنه لم يعد لديه ما يعتمد عليه. يوضح يوحنا الصليب أن الله، بهذه الطريقة، ومن خلال إعطاء انطباع بالانسحاب، يختبر قلوب المؤمنين ليقودهم أكثر على طريق كمال المحبة. هذا تفسير لاهوتي سليم. من منظور عقلاني خارج نطاق الإيمان، يمكن تفسير هذه الأزمة بسهولة بحقيقة بسيطة، وهي أن المؤمنين لا يمكنهم أبدًا أن يمتلكوا اليقين، أو المعرفة الموضوعية، حول أسس إيمانهم، ويبدأون حتمًا في التساؤل عنه. ستكون شدة شكهم متناسبة مع الأهمية الوجودية لإيمانهم. بالتأكيد، هناك مؤمنون ملتزمون للغاية، متدينون للغاية، يدّعون أنهم لم يختبروا الشك أبدًا: الأصوليون. بل الأسوأ من ذلك، أنهم يعتبرون الشك ظاهرة شيطانية. بالنسبة لهم، الشك هو فشل، وخيانة، وانزلاق إلى الفوضى. لأنهم يرفعون الإيمان خطأً إلى مرتبة اليقين، فإنهم يمنعون أنفسهم، داخليًا واجتماعيًا، من الشك. ويؤدي قمع الشك إلى شتى أنواع التوترات: التعصب، والتشدد الطقوسي، والجمود العقائدي، وتشويه صورة غير المؤمنين، والتعصب الذي قد يتصاعد أحيانًا إلى عنف دموي. يتشابه الأصوليون من جميع الأديان في رفضهم للشك، ذلك الجانب المظلم من الإيمان، والذي يُعد مع ذلك نتيجة حتمية له. اعترفت الأم تيريزا بشكوكها، مهما كان ألم تجربتها والتعبير عنها، لأن إيمانها كان مدفوعًا بالحب. أما الأصوليون فلن يرحبوا بشكوكهم أو يعترفوا بها أبدًا، لأن إيمانهم قائم على الخوف. والخوف يمنع الشك. ملاحظة: يسعدني أن أرحب بكريستيان بوبين في زاويتنا. [...]
عالم الأديان، يوليو/أغسطس 2007 - بعد قلق السادس من يونيو/حزيران 2006 (666)، حلّت نشوة السابع من يوليو/تموز 2007 (777). يؤكد تجار القمار على الأهمية الرمزية لهذين التاريخين، واستغلت سينما هوليوود الرقم الشهير للوحش من سفر الرؤيا (666)، ويتلقى رؤساء البلديات، بدهشة، عددًا كبيرًا من عروض الزواج في هذا السابع من يوليو/تموز الشهير. ولكن من بين أولئك الذين يؤمنون بالرقم 7، من يفهم رمزيته حقًا؟ رسّخ هذا الرقم نفسه في العصور القديمة كعلامة على الكمال والتمام بسبب الكواكب السبعة التي كانت مرئية آنذاك. وقد احتفظ بهذا المعنى من الإنجاز في الكتاب المقدس العبري: ففي اليوم السابع، يستريح الله بعد ستة أيام من الخلق. في العصور الوسطى، تبنى اللاهوتيون المسيحيون هذا المعنى وأكدوا أن الرقم 7 يجسد اتحاد السماء (3) والأرض (4). منذ ذلك الحين، شرعوا في تتبع وتفسير وجوده في الكتب المقدسة: مواهب الروح السبع، والكلمات السبع الأخيرة للمسيح على الصليب، والطلبات السبع في الصلاة الربانية، والكنائس السبع في سفر الرؤيا، ناهيك عن الملائكة السبعة، والأبواق السبعة، والأختام السبعة. كما سعت الفلسفة المدرسية في العصور الوسطى إلى اختزال كل شيء إلى هذا العدد المثالي: الفضائل السبع (الفضائل الأربع الأساسية من صنع الإنسان، والفضائل اللاهوتية الثلاث من الله)، والأسرار المقدسة السبعة، والخطايا السبع المميتة، ودوائر الجحيم السبع... إلا أن الحماس الذي أبداه عدد من معاصرينا مؤخرًا لرمزية الأرقام (يكفي أن نتذكر النجاح العالمي لـ"ألغاز" شيفرة دافنشي، أو النجاح العابر للمحيط الأطلسي للكابالا الرخيصة) لم يعد قائمًا على ثقافة دينية منحتها معنىً وتماسكًا، بل غالبًا ما يختزل إلى نهج خرافي. ومع ذلك، ألا يعكس هذا حاجة حقيقية لإعادة التواصل مع الفكر الرمزي، الذي نُفي من مجتمعاتنا الحديثة منذ انتصار النزعة العلمية؟ من بين التعريفات العديدة للإنسان، يمكن القول إنه الكائن الوحيد القادر على التعبير الرمزي. الكائن الوحيد الذي يبحث في العالم المحيط به عن معنى خفي وعميق يربطه بعالم داخلي أو غير مرئي. يشير الأصل اليوناني لكلمة "رمز"، *sumbolon*، إلى شيء مُجزأ إلى عدة أجزاء، ويُشكل اجتماعها علامة على التعرّف. على عكس الشيطان (diabolon) الذي يُفرّق، يوحّد الرمز ويربط. إنه يستجيب لحاجة متأصلة في النفس لربط المرئي وغير المرئي، الخارجي والداخلي. لهذا السبب، منذ فجر البشرية، يظهر الرمز كجوهر تجلّي لعمق الروح الإنسانية والشعور الديني (الدين، الذي يعني أصله اللاتيني *religare* أيضًا "الربط"). عندما كان الإنسان ما قبل التاريخ يضع موتاه على وسادة من الزهور، كان يربط رمز الزهرة بالمودة التي تربطه بهم. وعندما كان يضع الجثث في وضعية الجنين، ورؤوسها متجهة نحو الشرق، كان يربط رمزية الجنين وشروق الشمس بالولادة الجديدة، معبرًا بذلك عن إيمانه، أو أمله، في الحياة الآخرة. وعلى غرار الرومانسيين الألمان، بيّن كارل غوستاف يونغ أن روح الإنسان المعاصر تعاني من نقص في الأساطير والرموز. صحيح أن الحداثة قد ابتكرت أساطير ورموزًا جديدة - كالإعلانات مثلاً - لكنها لا تستجيب للتوق العميق والعالمي للمعنى في نفوسنا. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية تقريبًا، كان انتعاش علم التنجيم والباطنية، والنجاح العالمي لأعمال روائية مثل سيد الخواتم، والخيميائي، وهاري بوتر، وسجلات نارنيا، مؤشرات على الحاجة إلى "إعادة سحر العالم". في الواقع، لا يستطيع الإنسان التواصل مع العالم والحياة بالمنطق وحده، بل يحتاج إلى التواصل معهما أيضاً بقلبه، وحساسيته، وحدسه، وخياله. عندها يصبح الرمز بوابةً إلى العالم وإلى ذاته، شريطة أن يبذل جهداً ولو بسيطاً في سبيل المعرفة والتمييز العقلاني. فالاستسلام للتفكير السحري المحض، على العكس، سيحبسه في هيمنة الخيال، مما قد يؤدي إلى هذيان تفسيري للرموز. [...]
مجلة "لوموند دي ريليجن"، مايو-يونيو 2007 - "معسكر يسوع". هذا هو اسم فيلم وثائقي مثير للقلق عن الإنجيليين الأمريكيين، عُرض في 18 أبريل في دور السينما الفرنسية. يتناول الفيلم "التنشئة الدينية" لأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا من عائلات تنتمي إلى الحركة الإنجيلية. يحضرون دروسًا في التعليم المسيحي يُدرّسها مُبشّر، من مؤيدي بوش، وتصريحاته مُرعبة. يتمنى الأطفال قراءة هاري بوتر، مثل زملائهم، لكن المُبشّر يمنعهم منعًا باتًا، مُذكّرًا إياهم، دون أدنى سخرية، بأن السحرة أعداء الله، وأنه "في العهد القديم، كان هاري بوتر سيُقتل". ثم تلتقط الكاميرا لحظة فرح عابرة: طفل لأبوين مُطلقين يُفضي بمرح إلى جاره بأنه تمكّن من مشاهدة قرص DVD لأحدث أجزاء السلسلة... في منزل والده! لكن إدانة جرائم الساحر الخيالي تتضاءل أمام غسيل الدماغ الذي يتعرض له هؤلاء الأطفال في المخيم الصيفي. تُكشف أجندة المحافظين الأمريكيين برمتها، وبأبشع صورة ممكنة: زيارة من مجسم كرتوني للرئيس بوش، يُجبرون على استقباله كما لو كان المسيح المنتظر؛ توزيع أجنة بلاستيكية صغيرة لإدراكهم فظاعة الإجهاض؛ نقد جذري لنظريات داروين حول تطور الأنواع... كل هذا في جو احتفالي دائم، مع تصفيق وأغانٍ بلغات غير مفهومة. في نهاية الفيلم الوثائقي، تتهم صحفية معلمة التعليم المسيحي بغسل أدمغة الأطفال. لا يصدمها السؤال قيد أنملة: "نعم"، تجيب، "لكن المسلمين يفعلون الشيء نفسه تمامًا مع أطفالهم". الإسلام هو أحد هواجس هؤلاء الإنجيليين المؤيدين لبوش. يختتم الفيلم بمشهدٍ مؤثر: فتاةٌ صغيرةٌ تعمل مبشرةً، لا يتجاوز عمرها العشر سنوات، تقترب من مجموعةٍ من السود في الشارع لتسألهم: "أين تظنون أنكم ستذهبون بعد الموت؟" يُصيبها الجواب بالذهول. تُفضي إلى صديقها المبشر الصغير قائلةً: "إنهم متأكدون من أنهم سيذهبون إلى الجنة... رغم أنهم مسلمون". يُضيف بعد لحظة تردد: "لا بد أنهم مسيحيون". هؤلاء الناس "إنجيليون" بالاسم فقط. أيديولوجيتهم الطائفية (نحن المختارون الحقيقيون) وموقفهم العدائي (سنسيطر على العالم لنُهديه) يُناقضان رسالة الإنجيل تمامًا. يُثير هوسهم بالخطيئة، وخاصةً الخطيئة الجنسية، الاشمئزاز. لا يسع المرء إلا أن يعتقد أن هذا الإصرار على إدانة الجنس (قبل الزواج، خارج الزواج، بين أفراد الجنس الواحد) يُخفي وراءه رغباتٍ مكبوتةٍ كثيرة. ما حدث للتو للقس تيد هاغارد، الرئيس الكاريزمي للجمعية الإنجيلية الوطنية الأمريكية، التي تضم 30 مليون عضو، خير مثال على ذلك. نراه في الفيلم وهو يلقي خطبة على الأطفال. لكن ما لم يذكره الفيلم، لأن الفضيحة ظهرت لاحقًا، هو أن هذا البطل في مكافحة المثلية الجنسية قد وُصف قبل بضعة أشهر من قبل مومس في دنفر بأنه زبون متكرر ومنحرف بشكل خاص. بعد إنكاره المبدئي للادعاءات، اعترف القس أخيرًا بمثليته الجنسية، "هذا القذارة" التي يدعي أنه كان ضحية لها لسنوات، في رسالة مطولة أرسلها إلى رعيته لشرح استقالته. هذه أمريكا المخادعة والمنافقة، أمريكا بوش، مخيفة. ومع ذلك، يجب علينا تجنب التعميمات المؤسفة. بينما يُمثل هؤلاء الأصوليون المسيحيون، المُحاصرون في يقينياتهم الضيقة وتعصبهم المُخيف، صورةً طبق الأصل لحركة طالبان الأفغانية، إلا أنهم لا يُمثلون كامل الإنجيليين الأمريكيين البالغ عددهم نحو 50 مليونًا، والذين، كما يجب التذكير، عارضوا الحرب في العراق بشكلٍ كبير. ويجب علينا أيضًا توخي الحذر من مُساواة هؤلاء المُتعصبين دينيًا بالإنجيليين الفرنسيين، الذين استقروا في فرنسا لأكثر من قرن، ويبلغ عددهم الآن أكثر من 350 ألفًا في 1850 دار عبادة. إن حماستهم العاطفية ودعوتهم، المُستوحاة من الكنائس الأمريكية الضخمة، قد تكون مُقلقة. لكن هذا ليس مُبررًا لمُساواتهم بالطوائف الخطيرة، كما فعلت السلطات العامة بسهولة بالغة خلال العقد الماضي. لكن هذا الفيلم الوثائقي يُظهر لنا أن اليقين بـ"امتلاك الحقيقة" قد يدفع الناس، ذوي النوايا الحسنة بلا شك، إلى الانزلاق نحو الكراهية الطائفية. [...]
مجلة "عالم الأديان"، مارس-أبريل 2007 - حظي استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة الإحصاءات الكاثوليكية (CSA) حول الكاثوليك الفرنسيين، والذي نشرناه في عددنا الأخير، بتغطية إعلامية واسعة من أكثر من 200 وسيلة إعلامية، وكان له أثر كبير وأثار ردود فعل عديدة في فرنسا وخارجها. حتى الفاتيكان، ممثلاً بالكاردينال بوبار، علّق على الاستطلاع مندداً بـ"الجهل الديني" لدى الفرنسيين. أودّ أن أستعرض بعض هذه الردود. أشار أعضاء الكنيسة، بحق، إلى أن الانخفاض الحاد في عدد الفرنسيين الذين يُعرّفون أنفسهم ككاثوليك (51% مقارنةً بـ63% في أحدث استطلاعات الرأي) يعود في المقام الأول إلى صياغة السؤال: "ما هو دينك، إن كان لديك دين؟" بدلاً من العبارة الأكثر شيوعاً: "إلى أي دين تنتمي؟". تشير الصياغة الأخيرة إلى شعور بالانتماء الاجتماعي: أنا كاثوليكي لأنني تعمّدت. بدت الصياغة التي اعتمدناها أكثر ملاءمةً لقياس الالتزام الشخصي، مع إتاحة المجال في الوقت نفسه لإمكانية إعلان المرء نفسه "غير متدين". من الواضح تمامًا، كما أكدت مرارًا منذ نشر هذا الاستطلاع، أن عدد الكاثوليك المعمدين يفوق عدد من يُعرّفون أنفسهم ككاثوليك. من المرجح أن يُسفر استطلاعٌ بصياغةٍ أكثر تقليدية عن أرقامٍ مختلفة. ولكن ما هو الأهم؟ عدد من نشأوا على المذهب الكاثوليكي أم عدد من يعتبرون أنفسهم كاثوليك اليوم؟ إن طريقة طرح السؤال ليست العامل الوحيد المؤثر في النتائج. يُذكّرنا هنري تينك بأنه في عام ١٩٩٤، طرح معهد CSA السؤال نفسه تمامًا في استطلاعٍ نُشر في صحيفة لوموند كما في الاستطلاع الذي نُشر عام ٢٠٠٧ في مجلة لوموند دي ريليجن: ٦٧٪ من الفرنسيين عرّفوا أنفسهم ككاثوليك في ذلك الوقت، مما يُظهر الانخفاض الكبير الذي حدث على مدى اثني عشر عامًا. شعر العديد من الكاثوليك، رجال دين وعلمانيين على حد سواء، بالإحباط إزاء تراجع الإيمان في فرنسا، كما يتضح من سلسلة من الإحصاءات: فمن بين من يُعرّفون أنفسهم ككاثوليك، لم يبقَ سوى أقلية ملتزمة التزامًا حقيقيًا بالإيمان. ولا يسعني إلا أن أضع هذه الدراسة في سياقها الصحيح مع رحيل اثنين من المؤمنين العظماء مؤخرًا، وهما الراهبة الدومينيكانية ماري دومينيك فيليب والأب بيير (1)، اللذان كانا صديقين عزيزين. هذان الشخصان الكاثوليكيان، من خلفيات مختلفة تمامًا، قالا لي في جوهرهما الشيء نفسه: إن هذا الانهيار، على مدى قرون عديدة، للكاثوليكية كدين سائد يمكن أن يمثل فرصة حقيقية لرسالة الإنجيل: إذ يمكن إعادة اكتشافها بطريقة أصدق وأكثر شخصية وأكثر واقعية. في نظر الأب بيير، كان وجود عدد قليل من "المؤمنين المخلصين" أفضل من وجود حشد من المؤمنين الفاترين الذين تتناقض أفعالهم مع قوة الرسالة المسيحية. كان الأب فيليب يعتقد أن الكنيسة، اقتداءً بالمسيح، يجب أن تمر بآلام الجمعة العظيمة والحداد الصامت لسبت النور قبل أن تشهد اضطراب أحد القيامة. لم يثنِ تراجع الإيمان هؤلاء المؤمنين المتدينين، بل على العكس، رأوا فيه بذورًا محتملة لتجديد عظيم، وحدثًا روحيًا جللًا، يضع حدًا لأكثر من سبعة عشر قرنًا من الخلط بين الإيمان والسياسة، وهو الخلط الذي شوّه رسالة يسوع: "هذه وصيتي الجديدة: أحبوا بعضكم بعضًا كما أحببتكم". وكما قال اللاهوتي أورس فون بالتازار: "الحب وحده جدير بالإيمان". وهذا ما يفسر الشعبية الهائلة للأب بيير، ويُظهر أن الفرنسيين، حتى وإن لم يعتبروا أنفسهم كاثوليك، ما زالوا شديدي الحساسية للرسالة الأساسية للأناجيل. [...]
مجلة "عالم الأديان"، يناير-فبراير 2007 - "فرنسا، الابنة الكبرى للكنيسة". تشير هذه العبارة، التي نطق بها الكاردينال لانجينيو عام 1896، إلى الواقع التاريخي لبلد دخلت إليه المسيحية في القرن الثاني، والذي قدّم، منذ القرن التاسع فصاعدًا، نموذجًا لشعب يعيش في وئام حول الإيمان الكاثوليكي ورموزه وتقويمه الليتورجي. هذا ما أطلق عليه المؤرخون "العالم المسيحي". مع الثورة الفرنسية، ثم فصل الكنيسة عن الدولة عام 1905، أصبحت فرنسا دولة علمانية، مما أدى إلى تهميش الدين في المجال الخاص. ولأسباب عديدة (كالهجرة من الريف، وتغير الأعراف الاجتماعية، وصعود النزعة الفردية، إلخ)، فقدت الكاثوليكية نفوذها على المجتمع تدريجيًا منذ ذلك الحين. هذا التراجع الحاد يظهر جليًا في إحصاءات الكنيسة في فرنسا، والتي تُظهر انخفاضًا مطردًا في حالات التعميد والزواج وعدد الكهنة (انظر الصفحتين 43-44). ويتضح ذلك جلياً في استطلاعات الرأي، التي تُبرز ثلاثة مؤشرات: الممارسة (حضور القداس)، والإيمان (بالله)، والانتماء (التعريف بالكاثوليكية). فعلى مدى الأربعين عاماً الماضية، شهد المؤشر الأهم للتدين، وهو الحضور المنتظم للقداس، انخفاضاً حاداً، إذ لم يتجاوز 10% من سكان فرنسا عام 2006. أما الإيمان بالله، الذي ظل مستقراً نسبياً حتى أواخر الستينيات (حوالي 75%)، فقد انخفض إلى 52% عام 2006. في حين ظل المؤشر الأقل أهمية، وهو الانتماء، الذي يشمل البُعدين الديني والثقافي، مرتفعاً جداً حتى أوائل التسعينيات (حوالي 80%). وقد شهد بدوره انخفاضاً حاداً خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، حيث تراجع إلى 69% عام 2000، ثم إلى 61% عام 2005، ويكشف استطلاعنا أنه يبلغ الآن 51%. استغربنا هذه النتيجة، فطلبنا من معهد CSA إعادة إجراء الاستطلاع بعينة تمثيلية على المستوى الوطني تضم 2012 شخصًا بالغًا (18 عامًا فأكثر). وكانت النتيجة مماثلة. يُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى رفض 5% من المشاركين إدراج أنفسهم ضمن قائمة الأديان التي تقدمها مؤسسات استطلاع الرأي (كاثوليكي، بروتستانتي، أرثوذكسي، يهودي، مسلم، بوذي، لا ديني، إلخ) وإجابتهم التلقائية بـ"مسيحي". وخلافًا للممارسة المعتادة المتمثلة في إدراج هذه النسبة قسرًا ضمن فئة "الكاثوليكي"، فقد أدرجناها بشكل منفصل. ويبدو لنا أن من المهم أن يرفض أشخاص من خلفية كاثوليكية هذا الانتماء مع احتفاظهم بهويتهم المسيحية. على أي حال، يتناقص عدد الفرنسيين الذين يُعرّفون أنفسهم ككاثوليك، بينما يتزايد عدد من يصفون أنفسهم بأنهم "غير متدينين" (31%). أما الديانات الأخرى، التي تُمثل أقليات صغيرة جدًا، فتبقى مستقرة نسبيًا (4% مسلمون، 3% بروتستانت، 1% يهود). كما أن الاستطلاع الذي أُجري بين 51% من الفرنسيين الذين يُعرّفون أنفسهم ككاثوليك (انظر الصفحات 23-28) يُعدّ بالغ الأهمية، إذ يكشف عن مدى ابتعاد المؤمنين عن العقيدة. فليس نصف الكاثوليك فقط لا يؤمنون بوجود الله أو يشكّون فيه، بل إنّ 18% فقط من المؤمنين يؤمنون بإله شخصي (وهو أحد أسس المسيحية)، بينما يؤمن 79% بقوة أو طاقة. ويزداد هذا البُعد عن المؤسسة الدينية وضوحًا فيما يتعلق بقضايا الأخلاق والانضباط: إذ يؤيد 81% زواج الكهنة، و79% يؤيدون رسامة النساء. ولا يعتبر الكاثوليكية الدين الحق الوحيد إلا 7% فقط. وبذلك، فقدت تعاليم الكنيسة سلطتها على المؤمنين تقريبًا. ومع ذلك، يُبدي 76% رأيًا إيجابيًا تجاه الكنيسة، و71% تجاه البابا بنديكت السادس عشر. تُظهر هذه المفارقة المثيرة للاهتمام أن الكاثوليك الفرنسيين، الذين باتوا أقلية في المجتمع - والذين يرون أنفسهم كذلك بالفعل - يتبنون القيم السائدة في مجتمعاتنا الحديثة العلمانية، لكنهم يظلون، كأي أقلية، متمسكين بهويتهم الجماعية: الكنيسة ورمزها الرئيسي، البابا. لنكن واضحين: لم تعد فرنسا دولة كاثوليكية، ليس فقط في مؤسساتها، بل في عقليتها أيضاً. إنها دولة علمانية، حيث تبقى الكاثوليكية، وستبقى بلا شك لفترة طويلة، الدين الأهم. لنأخذ مثالاً: ما نراه "تراجعاً" في أعداد الكاثوليك الممارسين بانتظام، يُعادل عددياً إجمالي عدد السكان الفرنسيين من اليهود والبروتستانت والمسلمين (بمن فيهم غير المؤمنين وغير الممارسين). [...]
عالم الأديان، نوفمبر-ديسمبر 2006 - منذ الجدل الدائر حول الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، تزايدت مؤشرات التوتر بين الغرب والإسلام، أو بالأحرى بين جزء من العالم الغربي وجزء من العالم الإسلامي. لكن هذه السلسلة من الأزمات تطرح السؤال: هل يجوز انتقاد الإسلام؟ يرغب العديد من الزعماء المسلمين، وليس فقط المتطرفين منهم، في حظر انتقاد الأديان بموجب القانون الدولي باسم احترام المعتقدات. هذا الموقف مفهوم في سياق المجتمعات التي يشمل فيها الدين كل شيء، حيث يُعتبر المقدس القيمة العليا. لكن المجتمعات الغربية أصبحت علمانية منذ زمن بعيد، وفصلت بوضوح بين المجال الديني والمجال السياسي. وفي هذا الإطار، تضمن الدولة حرية الضمير والتعبير لجميع المواطنين. لذلك، لكل فرد حرية انتقاد الأحزاب السياسية والأديان على حد سواء. هذا المبدأ يسمح لمجتمعاتنا الديمقراطية بالبقاء مجتمعات حرة. ولهذا السبب، ورغم اختلافي مع تصريحات روبرت ريديكر ضد الإسلام، سأدافع عن حقه في التعبير عنها، وأدين بأشد العبارات الإرهاب الفكري والتهديدات بالقتل التي تلقاها. خلافًا لما زعمه البابا بنديكت السادس عشر، لم تكن علاقة المسيحية المتميزة بالعقل اليوناني، ولا حتى خطاب مؤسسها السلمي، هي ما مكّنها من نبذ العنف. فالعنف الذي مارسته المسيحية لقرون - بما في ذلك خلال العصر الذهبي للاهوت العقلاني التوماوي - لم يتوقف إلا مع قيام الدولة العلمانية. لذا، لا سبيل أمام الإسلام الذي ينوي دمج قيم التعددية والحرية الفردية الحديثة إلا قبول العلمانية وقواعدها. وكما أوضحنا في تقريرنا الأخير عن القرآن، فإن هذا يستلزم إعادة قراءة نقدية للمصادر النصية والشريعة الإسلامية، وهو ما يفعله العديد من المثقفين المسلمين. يجب أن نكون واضحين لا لبس فيه بشأن العلمانية وحرية التعبير. فالاستسلام لابتزاز المتشددين سيقوض آمال وجهود جميع المسلمين في أنحاء العالم الذين يطمحون للعيش في فضاء من الحرية والعلمانية. ومع ذلك، وبكل حزم، أنا مقتنع أيضًا بضرورة تبني موقف مسؤول والتحدث بعقلانية عن الإسلام. في السياق الراهن، لا تُجدي الإهانات والاستفزازات والمغالطات نفعًا سوى إرضاء مُرتكبيها، وتُزيد من صعوبة مهمة المسلمين المعتدلين. فعندما يُطلق المرء نقدًا مُبسطًا لا أساس له، أو يُطلق خطابًا عنيفًا ضد الإسلام، فإنه سيُثير حتمًا رد فعلٍ أشد عنفًا من المتطرفين. وقد يستنتج المرء حينها: "أرأيتم، كنتُ مُحقًا". إلا أنه مقابل كل ثلاثة مُتعصبين يُجيبون بهذه الطريقة، هناك 97 مسلمًا يُمارسون شعائرهم الدينية بسلام، أو مُتمسكين بثقافتهم الأصلية، يتألمون بشدة من هذه التصريحات، ومن رد فعل المتطرفين الذي يُشوه صورة دينهم. وللمساعدة في تحديث الإسلام، يُعد الحوار النقدي والعقلاني والمُحترم أفضل بمئة مرة من الشتائم والتصريحات المُشوهة. وأُضيف أن الخلط بين الأمور لا يقل ضررًا. فمصادر الإسلام مُتنوعة، والقرآن الكريم مُتعدد الأوجه، والتفسيرات لا تُحصى عبر التاريخ، والمسلمون اليوم مُتنوعون بنفس القدر في علاقتهم بالدين. لذا، دعونا نتجنب التعميمات المُبسطة. لقد أصبح عالمنا قريةً صغيرة. علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع اختلافاتنا. فلنتحاور، من كلا الجانبين، بهدف بناء جسور التواصل لا بهدف بناء الجدران، وهو الهدف الرائج حالياً. [...]
مجلة عالم الأديان، سبتمبر-أكتوبر 2006 — كان إنجيل يهوذا الكتاب الأكثر مبيعًا عالميًا في صيف ذلك العام (1). مصيرٌ استثنائي لهذه البردية القبطية، التي عُثر عليها في الرمال بعد سبعة عشر قرنًا من النسيان، والتي لم يُعرف وجودها سابقًا إلا من خلال كتاب القديس إيريناوس "ضد الهرطقات" (180). ولذلك، يُعد اكتشافًا أثريًا هامًا (2). ومع ذلك، فهي لا تُقدم أي كشف عن اللحظات الأخيرة من حياة يسوع، ولا يُرجح أن يُثير هذا الكتاب الصغير "ضجة في الكنيسة"، كما يُعلن الناشر على الغلاف الخلفي. أولًا، لأن مؤلف هذا النص، الذي كُتب في منتصف القرن الثاني، ليس يهوذا، بل جماعة غنوصية نسبت القصة إلى أحد رسل المسيح لإضفاء مزيد من المعنى والسلطة عليها (وهي ممارسة شائعة في العصور القديمة). ثانيًا، منذ اكتشاف مخطوطات نجع حمادي (1945)، التي كشفت عن مكتبة غنوصية ضخمة تضم العديد من الأناجيل المنحولة، أصبح لدينا فهم أفضل بكثير للغنوصية المسيحية، وفي النهاية، لا يُلقي إنجيل يهوذا أي ضوء جديد على فكر هذه الحركة الباطنية. إن نجاحه الباهر، الذي نسقته ناشيونال جيوغرافيك ببراعة، بعد شرائها حقوق النشر العالمية، يعود بلا شك إلى عنوانه الاستثنائي: "إنجيل يهوذا". إنه مزيج مذهل، لا يُصدق، ومثير للجدل. فكرة أن الشخص الذي وصفته الأناجيل الأربعة القانونية والتقاليد المسيحية على مدى ألفي عام بأنه "الخائن"، "الشرير"، "عميل الشيطان" الذي باع يسوع ببضعة فضة، قد يكون كتب إنجيلًا، لهي فكرة مثيرة للاهتمام. إن رغبته في سرد روايته للأحداث في محاولة لإزالة الوصمة التي لحقت به أمرٌ في غاية الروعة والجاذبية، وكذلك إعادة اكتشاف هذا الإنجيل المفقود بعد قرون طويلة من النسيان. باختصار، حتى دون معرفة أي شيء عن محتوى هذا الكتاب الصغير، لا يسع المرء إلا أن يفتن بهذا العنوان. ويتجلى هذا الأمر بوضوح في نجاح رواية "شفرة دافنشي"، إذ يشكك عصرنا في الرواية الرسمية للمؤسسات الدينية بشأن أصول المسيحية، وفي أن شخصية يهوذا، كغيرها من شخصيات ضحايا الكنيسة الكاثوليكية أو خصومها المهزومين، تُعاد صياغتها في الفن والأدب المعاصرين. يهوذا بطلٌ معاصر، رجلٌ مؤثرٌ وصادق، صديقٌ خائب الأمل، كان في نهاية المطاف أداةً للإرادة الإلهية. فكيف كان للمسيح أن يُتم عمله في الخلاص الشامل لولا خيانة هذا الرجل التعيس؟ يحاول الإنجيل المنسوب إلى يهوذا حلّ هذه المفارقة بجعل يسوع يصرح صراحةً بأن يهوذا هو أعظم الرسل، لأنه هو من سيسمح بموته: «لكنك ستتفوق عليهم جميعًا! لأنك ستضحي بالرجل الذي هو وعاء جسدي لي» (56). يلخص هذا القول الفكر الغنوصي خير تلخيص: العالم والمادة والجسد من صنع إله شرير (إله اليهود والعهد القديم)؛ وهدف الحياة الروحية، من خلال التلقين السري، هو تمكين المختارين النادرين الذين يمتلكون روحًا إلهية خالدة، منبثقة من الله الخير الذي لا يُدرك، من تحريرها من سجن أجسادهم. ومن المثير للسخرية أن نلاحظ أن معاصرينا، المولعين بالتسامح، والماديين إلى حد ما، والذين ينتقدون المسيحية لازدرائها للجسد، مفتونون بنص من مدرسة فكرية أدانتها السلطات الكنسية في زمانها بسبب طائفيتها ولأنها اعتبرت الكون المادي والجسد المادي رجسًا. 1. إنجيل يهوذا، ترجمة وتعليق ر. كاسر، م. ماير، وج. فورست، فلاماريون، 2006، 221 صفحة، 15 يورو. 2. انظر عالم الأديان، العدد 18. [...]
عالم الأديان، يوليو-أغسطس 2006 - يكمن أحد الأسباب الرئيسية لجاذبية البوذية في الغرب في شخصية الدالاي لاما الكاريزمية وخطابه الذي يركز على القيم الأساسية كالتسامح واللاعنف والرحمة. يثير هذا الخطاب الإعجاب لخلوه من التبشير، وهي سمة نادرة في الأديان التوحيدية: "لا تُغيّر دينك، ابقَ على دينك"، كما يقول المعلم التبتي. هل هذا خطاب سطحي، يهدف في نهاية المطاف إلى استمالة الغربيين؟ كثيرًا ما يُطرح عليّ هذا السؤال. سأجيب عليه من خلال سرد تجربة مررت بها أثرت بي بشدة. كان ذلك قبل بضع سنوات في دارامسالا، الهند. رتب الدالاي لاما للقاء بي لمناقشة كتاب. لقاء استمر ساعة. في اليوم السابق، في الفندق، التقيت ببوذي إنجليزي يُدعى بيتر، وابنه جاك البالغ من العمر 11 عامًا. توفيت زوجة بيتر قبل بضعة أشهر، بعد مرض طويل ومعاناة شديدة. أبدى جاك رغبته في لقاء الدالاي لاما. فكتب إليه بيتر وحصل على موعدٍ مدته خمس دقائق، كافية لنيل البركة. غمرت الفرحة الأب والابن. في اليوم التالي، التقيتُ بالدالاي لاما؛ واستُقبل بيتر وجاك مباشرةً بعدي. توقعتُ عودتهما إلى الفندق سريعًا، لكنهما لم يصلا إلا في نهاية اليوم، وهما في حالة يرثى لها. استمر لقاؤهما ساعتين. إليكم ما قاله لي بيتر عن ذلك: "أخبرتُ الدالاي لاما أولًا بوفاة زوجتي، فانفجرتُ بالبكاء. ضمّني إلى صدره، وبقي معي طويلًا وأنا أبكي، ثم ذهب إلى ابني وتحدث إليه. بعد ذلك سألني عن ديني: فأخبرته عن أصولي اليهودية وترحيل عائلتي إلى أوشفيتز، وهو أمرٌ كنتُ أكبته في نفسي." انفتح جرحٌ عميقٌ في داخلي، وغمرتني المشاعر، فبكيتُ مجددًا. ضمّني الدالاي لاما إلى صدره. شعرتُ بدموعه المفعمة بالشفقة: كان يبكي معي، كما كنتُ أبكي. بقيتُ بين ذراعيه وقتًا طويلًا. ثمّ تحدّثتُ إليه عن رحلتي الروحية: عدم اهتمامي باليهودية، واكتشافي ليسوع من خلال قراءة الأناجيل، واعتناقي المسيحية التي كانت، قبل عشرين عامًا، نور حياتي. ثمّ خيبة أملي لعدم عثوري على نفس قوة رسالة يسوع في الكنيسة الأنجليكانية، وابتعادي التدريجي عنها، وحاجتي المُلِحّة إلى روحانية تُعينني على الحياة، واكتشافي للبوذية، التي أمارسها منذ سنوات عديدة بصورتها التبتية. عندما انتهيتُ، التزم الدالاي لاما الصمت. ثمّ التفت إلى سكرتيره وتحدّث إليه باللغة التبتية. غادر السكرتير وعاد ومعه أيقونة ليسوع. انتابتني الدهشة. أعطاني الدالاي لاما الأيقونة قائلًا: "بوذا هو طريقي، يسوع هو طريقك". انفجرتُ بالبكاء للمرة الثالثة. فجأةً، استعدتُ كلّ الحبّ الذي شعرتُ به تجاه يسوع وقت اعتناقي المسيحية قبل عشرين عامًا. أدركتُ أنني ما زلتُ مسيحيًا. كنتُ أبحث في البوذية عن سندٍ للتأمل، لكن في أعماقي، لم يُؤثر فيّ شيءٌ أكثر من شخص يسوع. في أقل من ساعتين، صالحني الدالاي لاما مع نفسي وشفى جراحًا عميقة. عند مغادرته، وعد جاك بأنه سيراه كلما زار إنجلترا. لن أنسى أبدًا هذا اللقاء ووجوه هذا الأب وابنه التي تغيرت، والتي كشفت لي أن رحمة الدالاي لاما ليست مجرد كلمة جوفاء، وأنها لا تقلّ بأي حال من الأحوال عن رحمة القديسين المسيحيين. (لو موند دي ريليجن، يوليو-أغسطس 2006). [...]
عالم الأديان، مايو-يونيو 2006 - بعد الرواية، يأتي الفيلم. من المؤكد أن العرض الفرنسي لفيلم "شفرة دافنشي" في 17 مايو سيُعيد إشعال التكهنات حول أسباب النجاح العالمي لرواية دان براون. السؤال مثير للاهتمام، وربما أكثر إثارة من الرواية نفسها. بالنسبة لمحبي روايات الإثارة التاريخية - وأنا منهم - هناك إجماع شبه تام: "شفرة دافنشي" ليست عملاً كلاسيكياً. صحيح أنها مكتوبة بأسلوب مشوق، تجذب القارئ من الصفحات الأولى، ويُعدّ الثلثان الأولان منها ممتعين للقراءة، على الرغم من أسلوبها المتسرع وافتقارها إلى المصداقية والعمق النفسي للشخصيات. ثم تفقد الحبكة زخمها قبل أن تنهار في نهاية سخيفة. لذا، فإن بيع أكثر من 40 مليون نسخة والشغف الكبير الذي تُثيره هذه الرواية لدى العديد من قرائها، هو أقرب إلى تفسير اجتماعي منه إلى تحليل أدبي. لطالما اعتقدتُ أن سرّ هذا الحماس يكمن في المقدمة القصيرة التي كتبها الكاتب الأمريكي، والتي يُشير فيها إلى أن روايته مبنية على أحداث حقيقية، بما في ذلك وجود جماعة أوبوس داي (وهو أمرٌ معروف للجميع) ودير صهيون الشهير، هذه الجمعية السرية التي يُزعم أنها تأسست في القدس عام 1099، والتي قيل إن ليوناردو دافنشي كان رئيسها. بل والأفضل من ذلك: أن "مخطوطات" مودعة في المكتبة الوطنية تُثبت وجود هذا الدير الشهير. تدور حبكة الرواية بأكملها حول هذه الأخوية السرية، التي يُقال إنها احتفظت بسرٍّ خطير حاولت الكنيسة إخفاءه منذ نشأتها: زواج يسوع ومريم المجدلية والدور المحوري للمرأة في الكنيسة الأولى. هذه النظرية ليست جديدة. لكن دان براون تمكّن من إخراجها من الأوساط النسوية والباطنية وتقديمها للجمهور العام في صورة رواية بوليسية تدّعي أنها مبنية على حقائق تاريخية مجهولة للجميع تقريبًا. الأسلوب ذكي، لكنه مُخادع. تأسست جماعة سيون عام ١٩٥٦ على يد بيير بلانتارد، وهو كاتب قصص خيالية معادٍ للسامية، كان يعتقد أنه من سلالة ملوك الميروفنجيين. أما "الرقّات" الشهيرة المودعة في المكتبة الوطنية، فهي في الواقع صفحات عادية مطبوعة على الآلة الكاتبة، كتبها هذا الرجل نفسه وأتباعه في أواخر الستينيات. ومع ذلك، بالنسبة لملايين القراء، وربما قريبًا للمشاهدين، تمثل رواية "شفرة دافنشي" كشفًا حقيقيًا: الدور المحوري للمرأة في المسيحية المبكرة، والمؤامرة التي دبرتها الكنيسة في القرن الرابع لإعادة السلطة إلى الرجال. للأسف، لا تزال نظريات المؤامرة، مهما كانت بغيضة - كبروتوكولات حكماء صهيون سيئة السمعة - تلقى صدى لدى جمهور يزداد انعدام ثقته بالمؤسسات الرسمية، الدينية منها والأكاديمية. لكن مهما كانت أدلة التاريخ على وجود خلل في هذه النظرية، ومهما كان مظهرها التآمري مثيرًا للشك، فإن أطروحة التمييز الجنسي في الكنيسة تزداد جاذبية لأنها تستند أيضًا إلى حقيقة لا جدال فيها: الرجال وحدهم هم من يملكون السلطة داخل الكنيسة الكاثوليكية، ومنذ عهد بولس وأوغسطين، تم التقليل من شأن الجنسانية. لذلك، من المفهوم أن العديد من المسيحيين، وغالبًا ما يكونون غير ملتزمين دينيًا، قد انجذبوا إلى أطروحة دان براون المناهضة للأيقونات، وانطلقوا في هذا البحث الجديد عن الكأس المقدسة للعصر الحديث: إعادة اكتشاف مريم المجدلية والمكانة اللائقة للجنسانية والأنوثة في الدين المسيحي. بمجرد أن نتجاوز هراء براون، أليس هذا، في نهاية المطاف، بحثًا جميلًا؟ (لو موند دي ريليجن، مايو-يونيو 2006). [...]
عالم الأديان، مارس-أبريل 2006 - هل يجوز لنا السخرية من الأديان؟ في عالم الأديان، حيث نواجه هذا السؤال باستمرار، نجيب بنعم، بل وبكل تأكيد. فالمعتقدات والسلوكيات الدينية ليست بمنأى عن الفكاهة، ولا عن الضحك والنقد اللاذع، ولذا اخترنا منذ البداية، ودون تردد، إدراج رسوم كاريكاتورية فكاهية في هذه المجلة. توجد ضوابط لاحتواء أخطر التجاوزات: قوانين تدين العنصرية ومعاداة السامية، والتحريض على الكراهية، والتشهير بالأفراد. فهل من المناسب إذن نشر كل ما لا يندرج تحت القانون؟ لا أعتقد ذلك. لطالما رفضنا نشر أي رسم كاريكاتوري سخيف وخبيث لا يحمل أي رسالة فكرية، وإنما يهدف فقط إلى إيذاء أو تشويه معتقد ديني دون مبرر، أو يخلط بين جميع أتباع دين ما، على سبيل المثال، من خلال شخصية مؤسسه أو رمزه. لقد نشرنا رسومًا كاريكاتورية تدين القساوسة المتحرشين بالأطفال، لكننا لم ننشر رسومًا تصوّر السيد المسيح كمتحرش بالأطفال. كانت الرسالة ستكون: جميع المسيحيين متحرشون محتملون بالأطفال. وبالمثل، نشرنا رسومًا كاريكاتورية لأئمة وحاخامات متعصبين، لكننا لن ننشر أبدًا رسمًا كاريكاتوريًا يُظهر محمدًا كصانع قنابل أو موسى كقاتل لأطفال فلسطينيين. نرفض الإيحاء بأن جميع المسلمين إرهابيون أو جميع اليهود قتلة أبرياء. أود أن أضيف أن رئيس تحرير صحيفة لا يمكنه تجاهل القضايا المعاصرة. مسؤوليته الأخلاقية والسياسية تتجاوز الإطار القانوني الديمقراطي. المسؤولية لا تقتصر على احترام القانون فحسب، بل هي أيضًا مسألة فهم ووعي سياسي. إن نشر رسوم كاريكاتورية معادية للإسلام في المناخ الحالي يُؤجج التوترات بلا داعٍ ويصب في مصلحة المتطرفين من جميع الأطياف. بالتأكيد، الانتقام العنيف غير مقبول. علاوة على ذلك، فإنها تُقدم صورة كاريكاتورية للإسلام أكثر بكثير من أي من الرسوم الكاريكاتورية المذكورة، وهذا يُحزن الكثير من المسلمين بشدة. بالتأكيد، لم يعد بوسعنا قبول الخضوع لقواعد ثقافة تحظر أي نقد للدين. وبالتأكيد، لا يمكننا أن ننسى، ولا أن نتسامح مع، عنف الرسوم الكاريكاتورية المعادية للسامية التي تُنشر بشكل شبه يومي في معظم الدول العربية. لكن لا ينبغي لأي من هذه الأسباب أن يكون ذريعة لتبني موقف استفزازي أو عدواني أو ازدرائي؛ فذلك يعني تجاهل القيم الإنسانية، سواء أكانت مستوحاة من الدين أم من العلمانية، التي تُشكل أساس الحضارة التي نفخر بانتمائنا إليها. ماذا لو كان الانقسام الحقيقي، خلافًا لما يُروج له، ليس بين الغرب والعالم الإسلامي، بل بين أولئك في كل من هذين العالمين الذين يرغبون في المواجهة ويؤججون نار الفتنة، أو، على النقيض، أولئك الذين، دون إنكار أو التقليل من شأن الاختلافات الثقافية، يسعون جاهدين لإقامة حوار نقدي محترم - أي حوار بناء ومسؤول؟ (عالم الأديان، مارس-أبريل 2006). [...]
مجلة "عالم الأديان"، يناير-فبراير 2006 - قبل عام واحد فقط، في يناير 2005، تم إطلاق الشكل الجديد لمجلة "عالم الأديان". وهذا يتيح لي الفرصة لمناقشة التطور التحريري والتجاري للمجلة. وقد أثمر هذا الشكل الجديد، حيث شهدت مجلتنا نموًا ملحوظًا. بلغ متوسط توزيع المجلة لعام 2004 (في ظل الشكل السابق) 38,000 نسخة لكل عدد. وفي عام 2005، وصل إلى 55,000 نسخة، ما يمثل زيادة قدرها 45%. كان لديكم 25,000 مشترك في نهاية عام 2004؛ واليوم لديكم 30,000 مشترك. ولكن الأهم من ذلك كله، أن مبيعات الأكشاك شهدت قفزة هائلة، حيث ارتفعت من متوسط 13,000 نسخة لكل عدد في عام 2004 إلى 25,000 نسخة في عام 2005. في ظل المناخ الكئيب الذي يسود الصحافة الفرنسية - حيث تشهد معظم العناوين تراجعًا - يُعد هذا النمو استثنائيًا حقًا. لذا، أتقدم بجزيل الشكر لجميع مشتركينا وقرائنا الأوفياء الذين ساهموا في نجاح مجلة "عالم الأديان". مع ذلك، لا يجب أن نعلن النصر مبكرًا، فنحن ما زلنا على أعتاب عتبة الاستدامة، والتي تتجاوز 60,000 نسخة. لذلك، ما زلنا نعتمد على ولائكم ورغبتكم في نشر الوعي حول "عالم الأديان" لضمان استمرارها. لقد راسلنا العديد منكم لتشجيعنا أو مشاركة ملاحظاتكم، وأشكركم جزيل الشكر على ذلك. لقد أخذت بعض ملاحظاتكم بعين الاعتبار لتطوير مجلتكم. ستلاحظون في هذا العدد حذف قسم "الأخبار". في الواقع، لا يسمح لنا جدولنا الزمني الذي يصدر كل شهرين والمواعيد النهائية الضيقة جدًا لإنجاز العدد (قبل شهر تقريبًا من النشر) بمواكبة الأحداث الجارية. لذا، فقد واصلنا تطبيق المنطق الذي بدأناه مع الشكل الجديد، واستبدلنا صفحات "الأخبار" بمقال رئيسي من ست صفحات، سيظهر في بداية المجلة، مباشرةً بعد الافتتاحية، وسيكون إما سردًا تاريخيًا أو بحثًا اجتماعيًا. يأتي هذا استجابةً لطلب العديد من القراء بمقالات أكثر تعمقًا وطولًا. يلي هذا المقال الرئيسي قسم "المنتدى"، وهو المساحة التفاعلية للمجلة، والذي سيوفر مساحة أكبر لرسائل القراء، وأسئلة أودون فاليه، وردود فعل ومقالات من شخصيات بارزة، بالإضافة إلى رسوم كاريكاتورية فكاهية من فنانين مختلفين (شابير وفالدور بحاجة إلى استراحة). ونتيجةً لذلك، أصبحت المقابلة المتعمقة الآن في نهاية المجلة. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة في هذه الذكرى السنوية الأولى لأشكر كل من ساهم في نمو مجلة "عالم الأديان"، بدءًا من جان ماري كولومباني، الذي لولاه لما وُجدت هذه المجلة، والذي لطالما قدم لنا دعمه وثقته. نتقدم بالشكر الجزيل أيضًا لفرق العمل في دار نشر مالشيرب ومديريها المتعاقبين، الذين ساهموا في دعمنا ومساندتنا خلال مسيرتنا، وكذلك لفرق المبيعات في صحيفة لوموند التي استثمرت بنجاح في الترويج والمبيعات في أكشاك بيع الصحف. وأخيرًا، نتوجه بالشكر إلى الفريق الصغير في صحيفة لوموند دي ريليجن، وكذلك إلى كتّاب الأعمدة والصحفيين المستقلين المنتسبين إليها، الذين يعملون بحماس لتقديم فهم أعمق للأديان وحكمة الإنسانية. [...]
عالم الأديان، نوفمبر-ديسمبر 2005 — على الرغم من ترددي في مناقشة عمل شاركت في تأليفه في هذه الصفحات، إلا أنني لا أملك إلا أن أتحدث قليلاً عن كتاب الأب بيير الأخير، الذي يتناول مواضيع بالغة الأهمية ومن المرجح أن يثير جدلاً واسعاً. *على مدار عام تقريباً، جمعتُ تأملات مؤسس عمواس وتساؤلاته حول طيف واسع من المواضيع، بدءاً من التعصب الديني وصولاً إلى مشكلة الشر، بما في ذلك سر القربان المقدس والخطيئة الأصلية. من بين الفصول الثمانية والعشرين، خُصصت خمسة منها لمسائل الأخلاق الجنسية. ونظراً لصرامة يوحنا بولس الثاني وبنديكت السادس عشر في هذا الشأن، تبدو ملاحظات الأب بيير ثورية. ومع ذلك، إذا قرأ المرء ما يقوله بعناية، سيجد أن مؤسس عمواس يظل متزناً إلى حد كبير. فقد أعرب عن تأييده لرسامة الرجال المتزوجين، لكنه أكد بشدة على ضرورة الحفاظ على العزوبية المكرسة. لم يُدن الأب بيير العلاقات المثلية، لكنه تمنى أن يبقى الزواج مؤسسة اجتماعية حكرًا على المغايرين جنسيًا. كان يعتقد أن يسوع، لكونه إنسانًا كاملًا، قد اختبر بالضرورة قوة الرغبة الجنسية، لكنه أكد أيضًا أنه لا يوجد في الإنجيل ما يسمح لنا بتحديد ما إذا كان قد استسلم لها أم لا. أخيرًا، وفي مجال مختلف نوعًا ما ولكنه لا يقل حساسية، أشار إلى أنه لا يبدو أن هناك حجة لاهوتية حاسمة تعارض رسامة النساء، وأن هذه المسألة تنبع أساسًا من تطور المواقف، التي اتسمت حتى يومنا هذا بازدراء معين للجنس الأضعف. في حين أن ملاحظات الأب بيير ستثير حتمًا جدلًا داخل الكنيسة الكاثوليكية، فليس ذلك لأنها تُبرئ النسبية الأخلاقية في عصرنا (وهو ما سيكون تحريفًا فادحًا)، بل لأنها تفتح نقاشًا حول موضوع الجنس المحظور حقًا. ولأن هذا النقاش قد جُمّد من قِبل روما، فإن ملاحظات الأب بيير وتساؤلاته بالغة الأهمية للبعض ومقلقة للبعض الآخر. لقد شهدتُ هذا النقاش داخل جماعة عمواس نفسها قبل نشر الكتاب، عندما شارك الأب بيير المخطوطة مع من حوله. كان بعضهم متحمسًا، والبعض الآخر قلقًا ومنتقدًا. وأودّ هنا أيضًا أن أُشيد بقادة عمواس الذين، بغض النظر عن آرائهم، احترموا قرار مؤسسهم بنشر الكتاب بصيغته الحالية. لأحدهم الذي أبدى قلقه بشأن المساحة الكبيرة المخصصة للجنس في الكتاب - ولا سيما بشأن كيفية تغطية وسائل الإعلام له - أوضح الأب بيير أن هذه المسائل المتعلقة بالأخلاق الجنسية لا تشغل في الواقع سوى حيز ضئيل جدًا في الأناجيل. ولكن نظرًا لأن الكنيسة أولت أهمية بالغة لهذه القضايا، فقد شعر الأب بيير بأنه مُلزم بمعالجتها، حيث صُدم العديد من المسيحيين وغير المسيحيين من مواقف الفاتيكان المتشددة بشأن مشاكل لا تتعلق بأسس الإيمان وتستحق نقاشًا جادًا. وأنا أتفق تمامًا مع وجهة نظر مؤسس عمواس. أودّ أن أضيف: إذا لم تتناول الأناجيل - التي نُخصّص لها هذا العدد - هذه الأسئلة بتفصيل، فذلك لأنّ غايتها الأساسية ليست إرساء أخلاق فردية أو جماعية، بل فتح قلب كلّ إنسان على هاوية قادرة على تغيير حياته وإعادة توجيهها. ألم تُصبح الكنيسة، بالنسبة لكثير من مُعاصرينا، عقبةً حقيقيةً أمام اكتشاف شخص المسيح ورسالته، وذلك بالتركيز المُفرط على العقائد والقواعد على حساب إعلان رسالة يسوع "كونوا رحماء" و"لا تدينوا"؟ لعلّ لا أحد اليوم أجدر من الأب بيير، الذي كان على مدى سبعين عامًا من أبرز شهود رسالة الإنجيل، بالاهتمام بهذا الأمر. *الأب بيير، مع فريدريك لينوار، "إلهي... لماذا؟" تأملات قصيرة في الإيمان المسيحي ومعنى الحياة، بلون، 27 أكتوبر 2005. [...]
عالم الأديان، سبتمبر-أكتوبر 2005 - "لماذا القرن الحادي والعشرون ديني؟". عنوان المقال الرئيسي في هذا العدد الخاص بالعودة إلى المدارس يُردد صدى العبارة الشهيرة المنسوبة إلى أندريه مالرو: "القرن الحادي والعشرون سيكون دينيًا أو لن يكون كذلك". هذه العبارة مؤثرة للغاية. فقد تكررت في جميع وسائل الإعلام على مدى العشرين عامًا الماضية، ويُعاد صياغتها أحيانًا على أنها "القرن الحادي والعشرون سيكون روحيًا أو لن يكون كذلك". لقد شهدتُ بالفعل نقاشات حادة بين مؤيدي هاتين العبارتين. معركة عقيمة... لأن مالرو لم ينطق بهذه الجملة قط! لا يوجد أي أثر لهذه العبارة في كتبه، أو ملاحظاته المكتوبة بخط يده، أو خطاباته، أو مقابلاته. والأكثر دلالة على ذلك، أن مالرو نفسه أنكر هذه العبارة باستمرار عندما بدأت تُنسب إليه في منتصف الخمسينيات. وقد ذكّرنا صديقنا وزميلنا ميشيل كازيناف، إلى جانب آخرين من المقربين لمالرو، بهذا الأمر مؤخرًا. إذن، ما الذي قاله الكاتب العظيم تحديدًا والذي دفع الناس إلى نسب مثل هذه النبوءة إليه؟ يبدو أن الأمر برمته كان يدور حول نصين نُشرا عام ١٩٥٥. ففي رده على سؤال من صحيفة "داغليغا نيهيتر" الدنماركية حول الأساس الديني للأخلاق، اختتم مالرو إجابته قائلًا: "على مدى خمسين عامًا، دأب علم النفس على إعادة دمج الشياطين في الإنسان. هذا هو التقييم الجاد للتحليل النفسي. أعتقد أن مهمة القرن القادم، في مواجهة أخطر تهديد عرفته البشرية على الإطلاق، ستكون إعادة إدخال الآلهة". وفي مارس من العام نفسه، أعادت مجلة "بروفيس" نشر مقابلتين نُشرتا عامي ١٩٤٥ و١٩٤٦، مُرفقةً بهما استبيانًا أُرسل إلى مؤلف كتاب "مصير الإنسان". وفي نهاية هذه المقابلة، صرّح مالرو قائلًا: "ستكون المشكلة الحاسمة في نهاية القرن هي المشكلة الدينية - بصورة مختلفة تمامًا عن الصورة التي نعرفها، كما كانت المسيحية مختلفة عن الديانات القديمة". من هذين الاقتباسين استُقيت الصيغة الشهيرة، وإن كنا لا نعرف قائلها. إلا أن هذه الصيغة شديدة الغموض. فـ"عودة الدين" التي نشهدها، ولا سيما في صورتها القائمة على الهوية والأصولية، هي نقيض الدين الذي أشار إليه وزير الثقافة السابق للجنرال ديغول. أما الاقتباس الثاني، فهو في هذا الصدد واضح تمامًا: إذ يُعلن مالرو عن ظهور إشكالية دينية تختلف جذريًا عن إشكاليات الماضي. وفي العديد من النصوص والمقابلات الأخرى، يدعو، على غرار "مكمل الروح" عند برجسون، إلى حدث روحي عظيم ينتشل البشرية من الهاوية التي هوت بها خلال القرن العشرين (انظر في هذا الموضوع كتاب كلود تانيري الرائع، *الإرث الروحي لمالرو* - دار أرليا، 2005). بالنسبة لعقل مالرو اللاأدري، لم يكن هذا الحدث الروحي بأي حال من الأحوال دعوة لإحياء الأديان التقليدية. فقد اعتقد مالرو أن الأديان فانية كما كانت الحضارات بالنسبة لفاليري. لكنها، في نظره، تؤدي وظيفة إيجابية جوهرية، ستستمر في العمل: ألا وهي خلق آلهة هي "المشاعل التي يوقظها البشر واحدًا تلو الآخر لتنير لهم الطريق الذي يقودهم بعيدًا عن الوحش". عندما يؤكد مالرو أن "مهمة القرن الحادي والعشرين ستكون إعادة إدخال الآلهة إلى البشرية"، فإنه بذلك يدعو إلى موجة جديدة من التدين، لكنها ستنبع من أعماق الروح الإنسانية، وستتجه نحو دمج واعٍ للإلهي في النفس - كما تفعل شياطين التحليل النفسي - وليس إسقاطًا للإلهي إلى الخارج، كما كان الحال غالبًا مع الأديان التقليدية. بمعنى آخر، كان مالرو ينتظر ظهور روحانية جديدة، روحانية تجسد الإنسانية، روحانية قد تكون في مهدها، لكنها لا تزال مكبوتة إلى حد كبير في بداية هذا القرن بفعل حدة صراع الهويات الدينية التقليدية. ملاحظة 1: يسعدني أن أعلن تعيين دجينان كاره تاجر رئيسة تحرير لمجلة "عالم الأديان" (كانت تشغل سابقًا منصب السكرتيرة التحريرية). ملاحظة 2: أود إبلاغ قرائنا بإطلاق سلسلة جديدة من الأعداد الخاصة التثقيفية للغاية من مجلة "عالم الأديان": "20 مفتاحًا للفهم". يركز العدد الأول على ديانات مصر القديمة (انظر الصفحة 7)
[...]
عالم الأديان، يوليو-أغسطس 2005. هاري بوتر، شيفرة دافنشي، سيد الخواتم، الخيميائي: أعظم النجاحات الأدبية والسينمائية في العقد الماضي تشترك في شيء واحد: إنها تُشبع حاجتنا إلى الدهشة. فهي مليئة بالألغاز المقدسة، والوصفات السحرية، والظواهر الغريبة، والأسرار الرهيبة، تُرضي شغفنا بالغموض، وافتتاننا بما لا يُفسر. فهذه هي مفارقة حداثتنا المُفرطة: كلما تقدم العلم، ازدادت حاجتنا إلى الأحلام والأساطير. وكلما بدا العالم أكثر قابلية للفهم والتفسير، ازداد سعينا لاستعادة هالة سحره. إننا نشهد اليوم محاولة لإعادة سحر العالم... تحديدًا لأن العالم قد فقد سحره. وقدّم كارل غوستاف يونغ تفسيرًا قبل نصف قرن: يحتاج الإنسان إلى العقل بقدر حاجته إلى العاطفة، وإلى العلم بقدر حاجته إلى الأسطورة، وإلى الحجج بقدر حاجته إلى الرموز. لماذا؟ ببساطة لأن الإنسانية ليست مجرد كائن عاقل. نتواصل مع العالم أيضًا من خلال الرغبة، والحساسية، والقلب، والخيال. نتغذى بالأحلام بقدر ما نتغذى بالتفسيرات المنطقية، وبالشعر والأساطير بقدر ما نتغذى بالمعرفة الموضوعية. كان خطأ النزعة العلمية الأوروبية، الموروثة من القرن التاسع عشر (أكثر من عصر التنوير)، هو إنكار ذلك. فقد ساد الاعتقاد بإمكانية استئصال الجانب اللاعقلاني من البشرية، وأن كل شيء قابل للتفسير وفقًا للمنطق الديكارتي. استُهزئ بالخيال والحدس، وحُوصرت الأسطورة في خانة حكايات الأطفال. وقد اتبعت الكنائس المسيحية، إلى حد ما، النقد العقلاني، إذ فضّلت الخطاب العقائدي والمعياري - الذي يخاطب العقل - على حساب نقل التجربة الداخلية - المرتبطة بالقلب - أو المعرفة الرمزية التي تخاطب الخيال. وهكذا، نشهد اليوم عودة المكبوت. قراء دان براون هم في الأساس مسيحيون يبحثون في رواياته التشويقية الباطنية عن الغموض والأساطير والرموز التي لم يعودوا يجدونها في كنائسهم. أما محبو "سيد الخواتم"، مثل قراء برنارد ويربر النهمين، فهم في الغالب شباب يتمتعون بخلفية علمية وتقنية قوية، لكنهم يتوقون أيضًا إلى عوالم خيالية مستوحاة من أساطير أخرى غير تلك التي تنتمي إلى أدياننا، والتي ابتعدوا عنها كثيرًا. هل ينبغي أن نقلق إزاء هذا الانتعاش للأساطير والعجائب؟ بالتأكيد لا، طالما أنه لا يشكل، بدوره، رفضًا للعقل والعلم. ينبغي للأديان، على سبيل المثال، أن تُولي مزيدًا من الاهتمام لهذه الحاجة إلى العاطفة والغموض والرمزية، دون التخلي عن عمق تعاليمها الأخلاقية واللاهوتية. يمكن لقراء "شفرة دافنشي" أن يتأثروا بسحر الرواية وبأساطير الباطنية العظيمة (سر فرسان الهيكل، وما إلى ذلك) دون أن يأخذوا أطروحات المؤلف على محمل الجد أو يرفضوا المعرفة التاريخية باسم نظرية مؤامرة خيالية تمامًا. بمعنى آخر، المسألة كلها تتعلق بإيجاد التوازن الصحيح بين الرغبة والواقع، والعاطفة والعقل. يحتاج الإنسان إلى الدهشة ليُصبح إنسانًا كاملًا، لكن عليه ألا يخلط بين أحلامه والواقع. (لو موند دي ريليجن، يوليو-أغسطس 2005). [...]
عالم الأديان، مايو-يونيو 2005 - على الرغم من كونه مفكرًا ومتصوفًا وبابا يتمتع بكاريزما استثنائية، إلا أن كارول فويتيلا يترك لخلفه إرثًا مختلطًا. فقد هدم يوحنا بولس الثاني العديد من الجدران، لكنه بنى أخرى. ولا شك أن هذه البابوية الطويلة والمتناقضة، التي اتسمت بالانفتاح، لا سيما تجاه الأديان الأخرى، وبالانغلاق العقائدي والانضباطي، ستكون واحدة من أهم الفصول في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، وربما في التاريخ نفسه. وبينما أكتب هذه السطور، يستعد الكرادلة لانتخاب خليفة يوحنا بولس الثاني. ومهما يكن البابا الجديد، فإنه سيواجه تحديات جمة. هذه هي القضايا الرئيسية لمستقبل الكاثوليكية التي نتناولها في هذا العدد الخاص. لن أتطرق مجدداً إلى التحليلات والنقاط العديدة التي أثارها في هذه الصفحات كلٌ من ريجيس ديبري، وجان موتابا، وهنري تينك، وفرانسوا ثوال، وأودون فاليه، ولا إلى ملاحظات ممثلي الديانات الأخرى والطوائف المسيحية. سأكتفي بتسليط الضوء على جانب واحد. يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الكاثوليكية، كما هو الحال مع أي دين آخر، في تلبية الاحتياجات الروحية لأبناء عصرنا. تُعبَّر هذه الاحتياجات حالياً بثلاث طرق تتعارض تماماً مع التقاليد الكاثوليكية، مما سيجعل مهمة خلفاء يوحنا بولس الثاني بالغة الصعوبة. في الواقع، منذ عصر النهضة، شهدنا حركة مزدوجة من التفرّد والعولمة، والتي تسارعت وتيرتها باطراد على مدى الثلاثين عاماً الماضية. والنتيجة في المجال الديني هي أن الأفراد يميلون إلى بناء روحانيتهم الشخصية من خلال استقاء المعلومات من المخزون العالمي للرموز والممارسات والعقائد. يستطيع الغربي اليوم أن يُعرّف نفسه بسهولة بأنه كاثوليكي، وأن يتأثر بشخصية يسوع، وأن يحضر القداس من حين لآخر، ولكنه أيضاً يمارس تأمل الزن، ويؤمن بتناسخ الأرواح، ويقرأ للمتصوفين. وينطبق الأمر نفسه على سكان أمريكا الجنوبية، والآسيويين، والأفارقة، الذين انجذبوا منذ زمن طويل إلى التوفيق الديني بين الكاثوليكية والأديان التقليدية. هذا "التجميع الرمزي"، وهذه الممارسة لـ"الخروج عن المألوف في الدين"، باتت تنتشر على نطاق واسع، ويصعب تصور كيف يمكن للكنيسة الكاثوليكية أن تفرض على أتباعها التزامًا صارمًا بالعقيدة والممارسة التي تتمسك بها بشدة. ويُعدّ عودة التفكير غير العقلاني والسحري تحديًا هائلًا آخر. فعملية العقلانية، التي سادت الغرب طويلًا وتغلغلت بعمق في المسيحية، تُنتج الآن ردة فعل عكسية: قمع الخيال والتفكير السحري. ومع ذلك، وكما يُذكّرنا ريجيس ديبري هنا، كلما ازداد العالم تكنولوجيًا وعقلانية، كلما ازداد، تعويضًا عن ذلك، الطلب على الجوانب العاطفية والوجدانية والخيالية والأسطورية. ومن هنا جاء نجاح الباطنية، والتنجيم، والخوارق، وتطور الممارسات السحرية داخل الأديان التاريخية نفسها، مثل إحياء عبادة القديسين في الكاثوليكية والإسلام. ويُضاف إلى هذين الاتجاهين ظاهرةٌ تُقلب المنظور التقليدي للكاثوليكية رأسًا على عقب: إذ يُولي مُعاصرونا اهتمامًا أقل بكثير بالسعادة في الآخرة مقارنةً بالسعادة الدنيوية. وهكذا، يتحول النهج الرعوي المسيحي برمته: فلم يعد التركيز على الجنة والنار، بل على سعادة الشعور بالخلاص في اللحظة الراهنة نتيجة لقاء المرء بيسوع في تواصل روحي. ولا تزال قطاعاتٌ كاملةٌ من السلطة التعليمية للكنيسة مُنفصلةً عن هذا التطور، الذي يُعطي الأولوية للمعنى والعاطفة على الالتزام المُخلص بالعقيدة والقواعد. الممارسات التوفيقية والسحرية التي تهدف إلى السعادة الدنيوية: هذا تحديدًا ما ميّز وثنية العصور القديمة، وريثة ديانات ما قبل التاريخ (انظر ملفنا)، والتي ناضلت الكنيسة بشدةٍ ضدها لتأسيس نفسها. إن القديم يعود بقوة في العصر الحديث. ربما يكون هذا هو التحدي الأكبر الذي ستواجهه المسيحية في القرن الحادي والعشرين. [...]
عالم الأديان، مارس-أبريل 2005 - سواء وُجد الشيطان أم لا، فالأمر غير ذي صلة. ما لا يُنكر هو عودته. في فرنسا وحول العالم. ليس بطريقةٍ مُذهلةٍ ومُثيرة، بل بطريقةٍ مُنتشرةٍ ومتعددة الأوجه. تشير مجموعةٌ من الدلائل إلى هذه العودة المُفاجئة. فقد تضاعفت حالات تدنيس المقابر، والتي غالبًا ما تكون ذات طابعٍ شيطاني أكثر من كونها عنصرية، في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي. في فرنسا، أفادت التقارير بتدنيس أكثر من ثلاثة آلاف قبرٍ يهودي أو مسيحي أو مسلم في السنوات الخمس الماضية، أي ضعف العدد في العقد السابق. في حين أن 18% فقط من الفرنسيين يؤمنون بوجود الشيطان، فإن من هم دون سن 24 عامًا هم الأكثر عددًا (27%) ممن يُشاركون هذا الاعتقاد. ويعتقد 34% منهم أن الإنسان يُمكن أن يتلبّسه شيطان (1). بل إن الإيمان بالجحيم قد تضاعف بين من هم دون سن 28 عامًا في العقدين الماضيين (2). تُظهر أبحاثنا أن قطاعات واسعة من ثقافة المراهقين - موسيقى الغوث والميتال - غارقة في الإشارات إلى الشيطان، رمز التمرد الذي عارض الآب. هل ينبغي لنا تفسير هذا العالم الكئيب، الذي يتسم أحيانًا بالعنف، على أنه مجرد مظهر طبيعي لحاجة إلى التمرد والاستفزاز؟ أم ينبغي لنا تفسيره ببساطة من خلال انتشار الأفلام والقصص المصورة وألعاب الفيديو التي تُصوّر الشيطان وأتباعه؟ في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، كان المراهقون - وكنتُ واحدًا منهم - أكثر ميلًا للتعبير عن اختلافهم وتمردهم من خلال رفض مجتمع الاستهلاك. لقد أسرنا المعلمون الروحانيون الهنود وموسيقى بينك فلويد الرقيقة أكثر من بعلزبول وموسيقى الميتال العنيفة. ألا ينبغي لنا أن نرى في هذا الانبهار بالشر انعكاسًا للعنف والمخاوف التي تُسيطر على عصرنا، والتي تتسم بانهيار القيم التقليدية والروابط الاجتماعية، وبقلق عميق بشأن المستقبل؟ كما يذكرنا جان ديلوميو، يُظهر التاريخ أن الشيطان يعود إلى الواجهة في أوقات الخوف الشديد. أليس هذا أيضًا سبب عودة الشيطان إلى السياسة؟ فبعد أن أعاد آية الله الخميني طرح فكرة الشيطان عندما ندد بـ"الشيطان الأمريكي العظيم"، تبنى رونالد ريغان وبن لادن وجورج بوش الإشارة إلى الشيطان وتشويه صورة الخصم السياسي بشكل صريح. بل إن بوش يستلهم ذلك من الشعبية المتزايدة التي يحظى بها الشيطان بين الإنجيليين الأمريكيين، الذين يُكثّفون ممارسات طرد الأرواح الشريرة ويُنددون بعالم خاضع لقوى الشر. ومنذ أن تحدث بولس السادس عن "دخان الشيطان" لوصف تزايد علمنة الدول الغربية، لم تتخلف الكنيسة الكاثوليكية، التي نأت بنفسها عن الشيطان منذ زمن طويل، عن الركب. وكدليل على روح العصر، أنشأ الفاتيكان مؤخرًا ندوة لطرد الأرواح الشريرة داخل جامعة ريجينا أبوستولوروم البابوية المرموقة. كل هذه الدلائل استدعت ليس فقط بحثًا معمقًا في عودة الشيطان، بل أيضًا في هويته ودوره. من هو الشيطان؟ كيف ظهر في الأديان؟ ماذا يقول الكتاب المقدس والقرآن عنه؟ لماذا تحتاج الأديان التوحيدية إلى هذه الشخصية التي تجسد الشر المطلق أكثر من الأديان الشامانية أو الوثنية أو الآسيوية؟ علاوة على ذلك، كيف يمكن للتحليل النفسي أن يُلقي الضوء على هذه الشخصية، وعلى وظيفتها النفسية، وأن يسمح بإعادة تفسير رمزية مُحفزة للشيطان التوراتي؟ فإذا كان "الرمز" - sumbolon - وفقًا لأصل الكلمة، هو "ما يوحد"، فإن "الشيطان" - diabolon - هو "ما يفرق". أمرٌ واحدٌ يبدو لي مؤكداً: لن نتغلب على هذا الشرّ وهذه الحاجة البدائية، التي تعود إلى قدم البشرية نفسها، لإسقاط دوافعنا الجامحة وقلقنا من التشرذم على الآخر، على المختلف، على الأجنبي، إلا بتحديد مخاوفنا و"انقساماتنا"، على حدّ تعبير جولييت بينوش في مقابلتها الثاقبة. (1) وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مجلة سوفريس/بيليرين في ديسمبر 2002. (2) قيم الأوروبيين، مجلة فيوتشريبلز، يوليو-أغسطس 2002
[...]
عالم الأديان، يناير-فبراير 2005 - افتتاحية - عندما بدأت العمل في مجال النشر والصحافة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، لم يكن الدين يثير اهتمام أحد. أما اليوم، وبأشكاله المتعددة، بات الدين حاضرًا بقوة في وسائل الإعلام. في الواقع، يشهد القرن الحادي والعشرون تزايدًا في تأثير "الظواهر الدينية" على مسار الأحداث والمجتمعات العالمية. لماذا؟ إننا نواجه حاليًا تعبيرين مختلفين تمامًا عن الدين: عودة الهوية والحاجة إلى المعنى. إن عودة الهوية تهم كوكب الأرض بأسره، وهي تنبع من صراع الثقافات، ومن صراعات سياسية واقتصادية جديدة تُوظّف الدين كرمز لهوية شعب أو أمة أو حضارة. أما الحاجة إلى المعنى فتؤثر بشكل أساسي على الغرب العلماني الذي فقد طابعه الأيديولوجي. فالأفراد في العصر الحديث لا يثقون بالمؤسسات الدينية، ويسعون إلى أن يكونوا بناة حياتهم، ولم يعودوا يؤمنون بالمستقبل المشرق الذي وعدت به العلوم والسياسة. ومع ذلك، ما زالوا يواجهون أسئلة عميقة حول الأصل والمعاناة والموت. كذلك، لديهم حاجة إلى الطقوس والأساطير والرموز. هذه الحاجة إلى المعنى تعيد النظر في التقاليد الفلسفية والدينية العظيمة للبشرية: نجاح البوذية والتصوف، وإحياء العلوم الباطنية، والعودة إلى الحكمة اليونانية. إن صحوة الدين، بجانبيه المزدوجين من الهوية والروحانية، تستحضر الأصل اللغوي المزدوج لكلمة "دين": التجمع والتواصل. البشر كائنات متدينة لأن أنظارهم متجهة نحو السماء، ويتساءلون عن لغز الوجود. يجتمعون لتلقي المقدس. وهم متدينون أيضًا لأنهم يسعون للتواصل مع بني جنسهم برباط مقدس قائم على التسامي. هذا البعد المزدوج، الرأسي والأفقي، للدين موجود منذ فجر التاريخ. كان الدين أحد القوى الدافعة الرئيسية وراء نشأة الحضارات وتطورها. لقد أنتج الدين أشياءً عظيمة: الرحمة الفاعلة للقديسين والمتصوفين، والأعمال الخيرية، وأعظم الروائع الفنية، والقيم الأخلاقية العالمية، وحتى ولادة العلم. لكنه في صورته الأكثر قسوة، لطالما غذّى الحروب والمجازر وشرّعها. وللتطرف الديني وجهان أيضًا. فسمّه في البُعد الرأسي هو التعصب العقائدي أو اللاعقلانية الوهمية، وهو نوع من مرض اليقين الذي قد يدفع الأفراد والمجتمعات إلى أقصى الحدود باسم الدين. أما سمّه في البُعد الأفقي فهو الطائفية العنصرية، وهو مرضٌ يصيب الهوية الجماعية. وقد أدى المزيج المتفجر من هذين الجانبين إلى مطاردة الساحرات، ومحاكم التفتيش، واغتيال إسحاق رابين، وأحداث 11 سبتمبر. وأمام التهديدات التي يشكلونها على كوكب الأرض، يميل بعض المراقبين والمثقفين الأوروبيين إلى اختزال الدين إلى أشكاله المتطرفة وإدانته بشكل كامل (على سبيل المثال، الإسلام = الإسلام الراديكالي). وهذا خطأ فادح لا يؤدي إلا إلى تفاقم ما نسعى لمكافحته. لن ننجح في دحر التطرف الديني إلا بالاعتراف بالقيمة الإيجابية والحضارية للأديان، وتقبّل تنوّعها؛ وبالإقرار بحاجة الإنسانية إلى المقدسات والرموز، فرديًا وجماعيًا؛ وبمعالجة الأسباب الجذرية للعلل التي تفسّر نجاح التلاعب السياسي بالدين في الوقت الراهن: التفاوتات بين الشمال والجنوب، والفقر والظلم، وهيمنة أمريكية جديدة، والعولمة المتسارعة، وازدراء الهويات والعادات التقليدية. إن القرن الحادي والعشرين رهنٌ بما نصنعه. قد يكون الدين أداة رمزية تُستخدم في خدمة سياسات الغزو والتدمير، كما قد يكون حافزًا لتحقيق الذات والسلام العالمي في ظل تنوّع الثقافات. [...]
عالم الأديان، نوفمبر-ديسمبر 2004 - افتتاحية - نشهد منذ سنوات عودة ظهور اليقينيات الدينية، المرتبطة بتصاعد سياسات الهوية، وهو ما يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام. أعتقد أن هذا ليس سوى غيض من فيض. أما بالنسبة للغرب، فلنتذكر التقدم المحرز خلال قرن من الزمان. لقد أتاح لي العدد الخاص الذي نخصصه للذكرى المئوية للقانون الفرنسي الذي يفصل بين الكنيسة والدولة فرصة للغوص مجددًا في هذا السياق المذهل من الكراهية والإقصاء المتبادل الذي ساد آنذاك بين المعسكرين الكاثوليكي والمناهض لرجال الدين. في أوروبا، تميزت نقطة التحول في القرنين التاسع عشر والعشرين باليقينيات، يقينيات أيديولوجية ودينية وعلمية. كان العديد من المسيحيين مقتنعين بأن الأطفال غير المعمدين سيذهبون إلى الجحيم، وأن كنيستهم وحدها تمتلك الحقيقة. أما الملحدون، فقد احتقروا الدين واعتبروه اغترابًا أنثروبولوجيًا (فويرباخ)، أو فكريًا (كونت)، أو اقتصاديًا (ماركس)، أو نفسيًا (فرويد). واليوم، في أوروبا والولايات المتحدة، يعتقد 90% من المؤمنين، وفقًا لدراسة استقصائية حديثة، أنه لا يوجد دين واحد يحمل الحقيقة المطلقة، بل توجد حقائق في جميع الأديان. كما أن الملحدين أكثر تسامحًا، ولم يعد معظم العلماء يعتبرون الدين خرافة ستزول مع تقدم العلم. عمومًا، في غضون قرن تقريبًا، انتقلنا من عالم مغلق من اليقينيات إلى عالم مفتوح من الاحتمالات. هذا الشكل الحديث من الشك، الذي أطلق عليه فرانسوا فوريه "أفق الحداثة الذي لا يُجتاز"، انتشر على نطاق واسع في مجتمعاتنا لأن المؤمنين انفتحوا على الأديان الأخرى، ولأن الحداثة تخلت عن يقينياتها الموروثة من أسطورة التقدم العلمي: حيثما يتقدم العلم، يتراجع الدين والقيم التقليدية. ألم نصبح، إذًا، من أتباع مونتين؟ بغض النظر عن قناعاتهم الفلسفية أو الدينية، فإن غالبية الغربيين يؤمنون بأن العقل البشري عاجز عن بلوغ الحقائق المطلقة واليقين الميتافيزيقي القاطع. بعبارة أخرى، الله غير مؤكد. وكما أوضح فيلسوفنا العظيم قبل خمسة قرون، لا يسع المرء إلا أن يؤمن، وأن لا يؤمن أيضاً، في ظل حالة من عدم اليقين. ولأوضح، فإن عدم اليقين لا يعني الشك. فبإمكان المرء أن يمتلك إيماناً راسخاً وقناعات عميقة ويقيناً، ولكنه مع ذلك يُقر بأن الآخرين، بحسن نية ولأسباب وجيهة كأسبابنا، قد لا يشاركونه إياها. وتُعدّ المقابلات التي أجراها مخرجا المسرح، إريك إيمانويل شميت وبيتر بروك، مع مجلة "لوموند دي ريليجن" (عالم الأديان)، بليغة في هذا الصدد. فالأول يؤمن إيماناً راسخاً بـ"إله لا يُمكن تحديده" و"لا ينبع من المعرفة"، ويؤكد أن "الفكرة التي لا تشك في نفسها ليست ذكية". لا يُشير الأخير إلى الله، ولكنه يبقى منفتحًا على وجود كائن إلهي "مجهول، لا اسم له"، ويُقرّ قائلًا: "كنتُ أودّ أن أقول: 'أنا لا أؤمن بشيء...'، ولكن الإيمان بالعدم هو التعبير المطلق عن الإيمان". تُجسّد هذه الملاحظات هذه الحقيقة، التي أرى أنها تستحق مزيدًا من التأمل لتجاوز الصور النمطية والخطاب المُبسّط: فالانقسام الحقيقي اليوم، كما كان في القرن الماضي، لم يعد بين "المؤمنين" و"غير المؤمنين"، بل بين أولئك الذين يقبلون عدم اليقين، وأولئك الذين يرفضونه. - مجلة "عالم الأديان"، نوفمبر-ديسمبر 2004 [...]
يحفظ